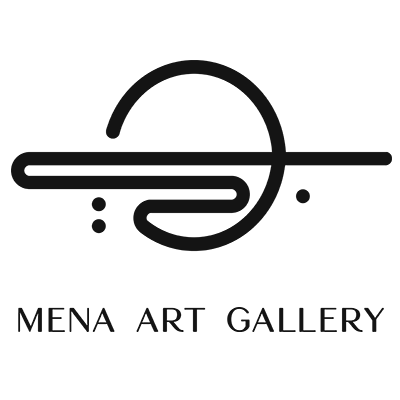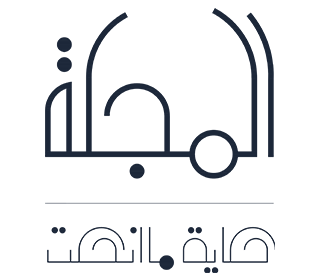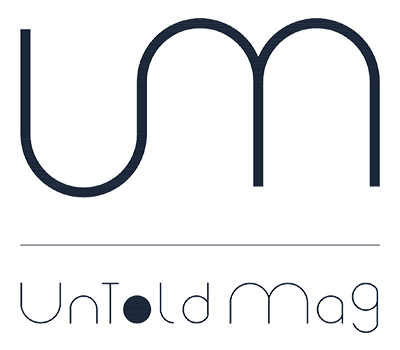سماح كركي هي عالمة أعصاب وكاتبة لبنانية-فرنسية. حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الأعصاب، وماجستير في علم الأحياء العصبية، بالإضافة إلى شهادة في التنوع البيولوجي وعلم البيئة. ألفت العديد من الكتب التي تجمع بين العلوم البيولوجية والاجتماعية، من أبرزها ” Analyse interdisciplinaire de la disparition du jeu libre de l’enfant”, Le talent est une fiction”, و “L’empathie est politique”.
أود البدء بفكرة أساسية تهيئ لمحادثتنا. نحن نعيش لحظة تاريخية قاسية، نشهد فيها على إبادة استمرت في غزة لأكثر من عام، تحت أنظار العالم وصمته، وانهيار لمفهومنا المشترك للإنسانية. نحن، كعرب، نعيش هذه اللحظة وكأن الإنسانية يُعاد تعريفها من دوننا، وكأننا خارجها تمامًا، مهمّشون، وكأن وجودنا ليس جزءًا من هذه اللحظة. ومن هنا، أجد أهمية كتابكِ “L’Empathie est Politique” (التعاطف هو فعل سياسي)، الذي يتعمق في قضايا تلامس جوهر ما نعيشه اليوم. ولهذا السبب، أود أن تكون هذه الفكرة مدخلًا لحوارنا وسؤالي الأول: كيف يمكننا فهم مفهوم “التعاطف” (Empathy) أو ما يعرف علميًا بالتقمّص الوجدانيّ؟
يُعد مصطلح “تعاطف” (Empathy) مصطلحًا جديدًا نسبيًا في اللغة الإنجليزية والفرنسية، ولم يكن معناه مرتبطًا في الأساس بالعواطف كما يمكن فهمها اليوم. تعود جذوره إلى الفلاسفة الألمان في مجال الجماليات (Aesthetics)، وكانت تشير إلى “التمثّل”، أي الشعور بما يمر به الآخر أو تخيل أنفسنا في موقع الفنان والخروج من الذات. في البداية، ارتبط المفهوم بالإحساس الذي ينشأ بعد مشاهدة عمل فني أو الاستماع إلى موسيقى، حين يشعر الفرد بأنه جزء من التجربة الإبداعية. كما شمل التعاطف “التمثّل” مع عناصر غير إنسانية، مثل الحيوانات أو النباتات، لفهم تجربتها.

مع تطور علم النفس في عشرينيات القرن العشرين، أصبح مصطلح “التعاطف” يعبّر عن القدرة على الإحساس بمشاعر الآخرين. لاحقًا، ومع تقدم علوم الأعصاب، صُنّف إلى نوعين رئيسيين:
الأول هو التعاطف العاطفي (Emotional Empathy)، وهو استجابة تلقائية وفورية تُتيح لنا فهم مشاعر الآخرين، من خلال إشارات مثل تعابير الوجه أو نبرة الصوت. هذا النوع لا يرتبط بالإيثار (Altruism) أو الرغبة في مساعدة الآخرين، بل يركّز على محاكاة أحاسيس الآخر وفهمها. هو مثل العدوى العاطفية (Emotional Contagion)، كالتثاؤب عندما نشاهد شخصًا آخر يتثاءب، وهي قدرة تظهر عند الأطفال منذ الأشهر الأولى عبر محاكاة أفعال الآخرين.
الثاني هو التعاطف المعرفي (Cognitive Empathy)، الذي يتطلب جهداً أكبرًا وواعيًا لتخيّل مشاعر وتجارب الآخرين عبر التفكير المجرد. هذا النوع يُعدّ أكثر تعقيدًا ويستهلك طاقة أكبر، فهو يتطلب منا تخيّل أنفسنا مكان الشخص الآخر لفهم ما يحسّه ويمر به.
يشكّلا التعاطف العاطفي والمعرفي معًا مفهوم “التعاطف”. ومع ذلك، هناك اعتقاد خاطئ بوجود ثنائية أو تناقض بين العواطف والإدراك، وافتراض تراتبي يعتبر أن العواطف هي أكثر عدلًا أو صدقًا. في الفكر الفلسفي الغربي، غالبًا ما تُعتبر العقلانية وسيلة لضبط العواطف وتوجيهها، بينما تُوصف العواطف بأنها عشوائية أو خطيرة إذا لم يسيطر عليها.
أجادل في الكتاب بعدم صح هذه الثنائية التي لا تدعمها الأدلة العلمية؛ فالعواطف ليست منفصلة عن الإدراك، بل هي انعكاس لتجاربنا السابقة وثقافتنا. بدوره الإدراك ليس ثابتًا أو عالميًا، بل يتأثر بالسياقات الثقافية والاجتماعية وخبرات الشخص المتراكمة.
لفهم التعاطف بشكل أعمق، يجب معرفة أن العاطفة والإدراك مترابطان بشكل وثيق، وأن إدراكنا للعواطف ليس أمرًا موضوعيًا تمامًا، بل هو نتاج لماضينا وتجاربنا وتصوراتنا الثقافية. يعيد الكتاب النظر في هذه الثنائيات التقليدية، مؤكدًا أن التعاطف ليس مجرد شعور منفصل أو عملية إدراكية محضة، بل هو عملية مركبة ومعقدة تتأثر بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي ننتمي إليه.
ولماذا كان من المهم بالنسبة لكِ كتابة هذا الكتاب في هذا التوقيت تحديدًا؟
هناك سببان أساسيان دفعاني إلى كتابة هذا الكتاب. الأول هو متابعتي لما كان يحدث في فلسطين، تحديدًا التصعيد خلال الشهرين الأولين، أكتوبر ونوفمبر 2023، ومراقبتي للتغطية الإعلامية والنقاشات في فرنسا، حيث أعيش. لفت انتباهي آنذاك الاتهامات المتبادلة للطرفين بعدم إظهار التعاطف تجاه الضحايا، وتحديدًا الاستخدام الممنهج للعاطفة كأداة لتبرير العنف. على سبيل المثال، ظهر محللون سياسيون في برامج بارزة يبررون تصرفات إسرائيل بحجة أنها تعيش صدمة أو حدادًا جماعيًا، ما يجعل مساءلتها أو انتقادها أمرًا مستحيلًا. فجأة، أصبحت العواطف جزءًا من النقاشات السياسية، لكن ليس لفهم الآخر أو لتخفيف المعاناة، بل لتبرير أفعال عنيفة وقاسية.
أما السبب الثاني، فهو مرتبط بثقافة “التنمية الذاتية” (Personal Development) التي سيطرت على عالمنا خلال العقود الأخيرة، والتي بالغت في تقديس الفرد ومشاعره. هذه الثقافة عزّزت فكرة أن أي شعور يعيشه الفرد هو شرعي بمجرد أنه شعور شخصي، وليس هناك حاجة لمراجعته أو التفكير في تأثيره على الآخرين. أدى ذلك إلى تبرير مواقف غير إنسانية، حيث أصبحت العواطف الفردية وسيلة لتغليب الذات ومشاعرها على الآخرين، حتى في السياقات السياسية والاقتصادية. أرى في هذا النهج ارتباطًا ما بين الفاشية وثقافة التنمية الذاتية، التي ترى الفرد محور كل شيء، وتتجاهل آثار مشاعره على المحيطين به.

لذا أردت من خلال هذا الكتاب التأكيد على أن مشاعرنا ليست محايدة أو معزولة، بل هي انعكاس لمصالحنا وتجاربنا التاريخية ومن نحب ومن نكره، وحتى قربنا أو بعدنا الجغرافي. مشاعرنا ليست بريئة، بل هي مرتبطة وتنبع من سياقات معقدة. كما يسلط الكتاب الضوء على الدور الذي يلعبه الإعلام والسينما والأدب في تجريد مجموعات معينة من إنسانيتهم، ما يعمّق أزمات التعاطف ويكرّس الهيمنة.
دور الإعلام في تشكيل السرديات المهيمنة يبدو ظاهرًا فعلًا في عالمنا اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجريد مجموعات معينة من إنسانيتها. هذا الأمر ليس جديدًا، فقد شاهدنا خلال عقود كيف تُصور وسائل الإعلام الغربية العرب والمسلمين، أو مجموعات أخرى كالمكسيكيين في الولايات المتحدة والأفارقة في فرنسا، بأساليب نمطية ومهينة. في سياق آخر، أظهرت لنا الحرب في سوريا كيف يمكن توثيق حربًا كاملة بالصور، من دون أي تغيير حقيقي، بل يمكن استخدامها أحيانًا كوسيلة لتبرير الإبادة، كما حدث في غزة، حيث تُعاد صياغة الروايات لتناسب مصالح القوى المهيمنة. في ظل هذا الواقع، كيف ترين دور الإعلام الحالي في استمرار هذه السرديات، وكيف يُعيد إنتاج الصور النمطية ذاتها كأداة لتعزيز الهيمنة؟
علينا أن نفهم أن الهرمية التي تحدد قيمة الحياة والجسد ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات تاريخية طويلة ومنظومة هيمنة مستمرة. يُستغل الإعلام فيها كأداة لتبرير تجاهل مآسي معينة، وغالبًا ما تُستخدم حجج مثل “هناك دائمًا حروب في تلك المناطق”، مما يجعل هذه الأحداث تبدو مألوفة أو متوقعة.
من منظور علم الأعصاب، تستجيب أدمغتنا مع الأحداث غير المتوقعة أكثر من تلك المألوفة، وهذا يفسر جزئيًا قلة التفاعل مع الأزمات المتكررة في سوريا أو غزة أو لبنان. لكن اختزال ضعف التعاطف في الاعتياد أو القرب الجغرافي هو تبسيط كبير. فالجذور أعمق، وهي مرتبطة بسياسات تاريخية عززت الفوقية وكرست التفاوت في تقدير قيمة الحياة.
يمكننا العودة إلى التاريخ، حيث نجد أن التجريد من الإنسانية مرتبط بالاستعمار. في الجزائر، خلال الاحتلال الفرنسي، لم يُقتصر ذلك على الاستغلال المادي، بل شمل أيضًا استعمال الجسد كأداة للسيطرة والتجريد من الإنسانية. نرى ذلك أيضًا في نظام العبودية، حيث استُغل الجسد للسيطرة والهيمنة. أما تأسيس إسرائيل، فارتكز على استبعاد شعب اعتُبر بلا قيمة، حتى داخل الدولة نفسها نرى تفاوتًا بين اليهود الأشكناز والمزراحيين. هذا التحول من العنصرية البيولوجية إلى الثقافية رسّخ صورة الغرب كنموذج للتطور والأخلاق، مبررًا الاستعمار والعنف بمفاهيم مثل “حماية النفس من البرابرة”، “تنظيف العالم”، أو “إصلاح الآخر”.
لا تقتصر هذه السرديات على الغرب فقط؛ فهي متجذرة أيضًا في مجتمعاتنا، حيث يُعتبر الغرب نموذجًا للتطور. كما أوضح المفكر إدوارد سعيد، إن استغلال الجسد العربي والمسلم هو جزء من تاريخ استعماري طويل. ويلعب الإعلام دورًا أساسيًا في إعادة إنتاج هذه الصور النمطية بشكل مستمر. كما رأينا مثلًا في أفغانستان، حيث أظهرت الفيلسوفة النسوية جوديث بتلر كيف يُصوَّر العنف كضرورة مُلحة لحماية الذات من تهديد الآخر، مما يعزز هذه السرديات ويبرر الهيمنة.
حتى على مستوى التعاطف مع الكائنات الأخرى، تتأثر مشاعرنا بتصوّرنا لهذه الكائنات كجذابة أو مهددة. نتعاطف بسهولة مع القطط الصغيرة، لكن نتجاهل الأفاعي. في دراسة حول الكوارث البيئية، أُبيّن إن خُيِّر البعض بين الحيوانات الكبيرة والصغيرة والمهاجرين، فانهم يفضلون التخلي عن المهاجرين قبل الحيوانات، مما يعكس نجاح وتأثير الخطابات اليمينية المتطرفة التي تُصور المهاجرين كسبب لأزمات الغرب، سواء عبر تهديد “الشرف”، أو “الوظائف”، أو “الأمان”. تترسخ تدريجيًا هذه الرسائل، التي تُكرر باستمرار، لتصبح جزءًا من الثقافة العامة دون وعي.
لنأخذ مثال الصور القادمة من غزة وتل أبيب في الإعلام الفرنسي والتي نرى من خلال دراستها التحيّز الواضح: تُظهر صور تل أبيب أشخاصًا “جميلة” يعيشون بسلام وهدوء، بينما تُركز صور غزة على الدمار والعداء، وتحديدًا رجال يصرخون “الله أكبر”. تُكرس هذه الصور صورة الآخر كبربري وعدواني، مما يبرر العنف ويعزز السرديات المهيمنة.
علم الأعصاب يوضح كيف يؤدي تصوير الآخر كتهديد إلى فقدان التعاطف، بل وتعزيز شعور الدفاع عن الذات من خلال إيذائه قبل أن يؤذينا. هذه الديناميكيات الإعلامية والسياسية تستوجب علينا إعادة النظر في كيفية تصوير الآخر والأسباب التي تؤدي إلى فقدان القدرة على التعاطف الحقيقي.

أود العودة إلى موضوع تنمية الذات وربطه بمصطلح تناولته في كتابك، وهو “السياحة العاطفية”. هذا المفهوم، كما أشرتِ، يُظهر كيف يمكن أن يتحول التعاطف إلى وسيلة لتطوير الذات بدلًا من كونه أداة لتحقيق العدالة والمساواة. هل يمكنكِ توضيح مفهوم السياحة العاطفية أكثر؟ وهل يعكس هذا المفهوم مشكلة أوسع، حيث تتحول السياسة من تحقيق العدالة إلى تعزيز الذات؟
التعاطف ليس شعورًا بسيطًا أو تلقائيًا، بل هو عملية تستنزف منا طاقة وجهدًا كبيرين. من الناحية البيولوجية، يحتاج جسمنا إلى استعادة الطاقة التي تُستهلك في النشاطات العاطفية، سواء مشاعر الفرح أو الحزن. وفي غياب تجارب عاطفية حقيقية، نلجأ إلى خلق تجارب مصطنعة لملء هذا الفراغ، ما يفسر ظاهرة “السياحة العاطفية”.
السياحة العاطفية هي البحث عن تجارب تمنح حياتنا شعورًا بالمعنى. مثلًا، يشاهد البعض أفلامًا حزينة أو ينخرط في أنشطة مصطنعة لإثارة مشاعرهم. موقع Stuff White People Like (أشياء يحبها الأشخاص البيض)، الذي تحول إلى كتاب، وثّق أنشطة شائعة يمارسها البيض، مثلًا حضور المهرجانات الموسيقية أو التخييم في البرية. بالنسبة لشخص مهاجر أو مشرد، إن فكرة التخييم في البرية غير منطقية أبدا، لكنها بالنسبة للأشخاص البيض فهي تُعتبر تجربة تضيف معنى وقيمة لحياتهم.
هذا السلوك مرتبط أيضًا بفكرة أعمق مستوحاة من التراث اليهودي-المسيحي، وهي أن “المعاناة تُضفي قيمة”. يُعتبر الأشخاص الذين يعيشون تجارب مؤلمة، أنهم يكتسبون مكانة أخلاقية أو شخصية أعلى. هذه الفكرة يمكن أن تمتد إلى الفن وتشكيل الهويات، حيث يُصبح الألم عنصرًا أساسيًا في بناء الشخصية. ومن هنا التركيز على دور الضحية، سواء في تحديد من يستحق التعاطف أو في تقديم الضحية كشخصية ذات قيمة معنوية أعلى.
لكن السياحة العاطفية تُحوّل معاناة الآخرين إلى منتج يُستهلك عاطفيًا، من دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها الحقيقي على الضحية. ويلعب الإعلام دورًا كبيرًا في تعزيز هذا النهج، إذ لم يعد يكفي تقديم أرقام وإحصاءات مجردة لجذب الانتباه. بل يجب تقديم قصص حزينة ومأساوية مثل التعذيب أو الاغتصاب لإثارة العواطف. هذه القصص تُستهلك عاطفيًا، لكنها لا تُحدث تغييرًا حقيقيًا، بل تُعيد إنتاج الهيمنة نفسها.
يُحوّل النظام الإمبريالي والفاشي التعاطف إلى سلعة. فهو يسمح ويساهم بتمويل معارض، وإنتاج أفلام وثائقية، وكتابة كتب تُعالج قضايا استعمارية أو إنسانية، لكنها في الواقع هي هنا لتخدم النظام القائم وتحافظ عليه. وكما يقول الفيلسوف جاك رانسيير، كل ما يُنتج داخل النظام يتحول إلى سلعة. القصص والصور التي نراها وتنتشر على وسائل التواصل تُثير العواطف، لكنها لا تقدم أي عمق تاريخي أو حلول فعلية، هي فقط تساهم بخلق شعور وهمي بالتغيير، في حين يبقى الواقع على حاله.
لذا أرى فكرة السياحة هنا دقيقة جدًا: فمن هو المُتَسوِّح؟ هو من يملك الوقت والمال، ومن هو المُتعاطِف؟ هو من يملك الطاقة والامتيازات لخوض تجربة عاطفية دون أن يتخلى عن شيء من امتيازاته. هذه المبالغة في تضخيم تجاربنا الشخصية، تجعلنا نستهلك الألم والمعاناة اللتين تصبحان وسيلة لإثراء حياتنا، التي بدورها نحوّلها إلى “غرف نزينها” بمشاعر وتجارب، بما في ذلك عذابات الآخرين، دون أن ننظر فعليًا إلى أثر المعاناة الحقيقي على أصحابها أو دون إحداث تغيير جوهري في الواقع.
لنتوقف قليلًا عند مفهوم الضحية والمظلومية، ونناقشه في سياق طرحكِ بأن العواطف هي نتاج تراكمات تاريخية وتجارب مرتبطة بمن نحب ومن نكره. في لبنان، تَبرز المظلومية المبالغ فيها في سرديات الطوائف، وتبني كل طائفة هويتها على تجارب تاريخية من الاضطهاد والمظلومية. إذا أخذنا الطائفة الشيعية كمثال، نجد أن ذاكرتها الجماعية المرتبطة بالتهميش تُستخدم بشكل متكرر. بنفس الوقت، نشهد اليوم أزمة تعاطف تجاه “بيئة حزب الله” والشيعة عمومًا. فلا يُسلط الضوء مثلًا بما يكفي على ضحايا هجوم البايجرز، الذين تُربط إصاباتهم تلقائيًا بحزب الله، مما يعزل هذه الفئة عن تعاطف المجتمع ككل. كيف يمكن تفسير هذه الديناميكيات من خلال مفاهيمكِ عن العواطف والمظلومية وتأثيرها على العلاقات بين الطوائف والصراعات في لبنان؟
مفهوم الجوهرية (Essentialism) هو من الركائز الأساسية التي تساعدنا على فهم الأنظمة العنصرية، إذ يعتمد على فكرة أن لكل فئة خصائص جوهرية وثابتة، مما يؤدي إلى اختزال الأفراد في هذه الصفات المفترضة، سواء كانت ثقافية، اجتماعية، أو نفسية.
في السياق اللبناني، العنصرية ضد الطائفة الشيعية ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى تاريخ طويل سبق ظهور حزب الله، تعرض خلاله الشيعة للإقصاء والاستهزاء، وذلك ليس بسبب قوتهم، بل نتيجة لضعفهم وتهميشهم. لم يكن هذا التهميش ماديًا أو اقتصاديًا فقط، بل امتد إلى مستوى الكرامة والشرف، ما أدى لديهم إلى ترسيخ شعور دائم بالدونية. مع تصاعد نفوذ حزب الله، ركز خطابه على استعادة الكرامة والاعتراف الاجتماعي المفقودين، لكنّه ساهم أيضًا في ظهور النرجسية الجماعية الحالية لدى بعض أطياف الطائفة، كرد فعل على تهميش طويل الأمد.
التركيبة الاجتماعية اللبنانية تعزّز الهرمية، حيث تعتبر كل طائفة نفسها بأنها الأكثر تطورًا أو تمدنًا، وهذا يعيق الشعور بالمساواة الذي هو بدوره ضروري للتعاطف. النرجسية الجماعية لدى الشيعة، التي ارتبطت بالقوة المكتسبة حديثًا، زادت من تعقيد العلاقات مع باقي الطوائف، حيث تُصوّرهم السرديات الإعلامية كخطر دائم، ما يؤدي إلى التجريد من الإنسانية ويُسهّل غياب التعاطف.
قلة التعاطف ليست ظاهرة جديدة، بل هي نتيجة تراكمات تاريخية وسرديات مضللة تُبسّط الأحداث وتُختزل المجموعات في تصنيفات جوهرية سطحية. من منظور علم الأعصاب، الكرامة هي حاجة أساسية، كالحاجات البيولوجية الأساسية، لذا عندما تُنتزع، تسبب ألمًا نفسيًا يعادل الألم الجسدي. بناء مجتمع متوازن يتطلب أن يشعر الجميع بالمساواة، وهو ما أهملته السياسات والحركات اللبنانية المتعاقبة.
والمظلومية ليست هوية ثابتة، بل هي حالة مؤقتة. قد يكون الأفراد والجماعات في نفس الوقت ضحايا ومُضطهِدين. في لبنان، كما في إسرائيل، لم تعد المظلومية التاريخية كافية لتبرير الأفعال الجماعية. ومع ذلك، يفضّل العقل البشري استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة النفسية، فيسعى للحفاظ على سرديات تتماشى مع تصوراته السابقة عن الذات والجماعة. أي تهديد لهذه السرديات يؤدي إلى ما يُعرف بـ“التنافر المعرفي” (cognitive dissonance)، وهو حالة تدفع الأفراد إلى رفض المعلومات التي تتعارض مع قناعاتهم أو تعرضهم لشعور بالتناقض مع أنفسهم.
والكتاب يوضح كيف يمكن أن للشخص أن يُظهر تعاطفًا كبيرًا مع فئة معينة، بينما يفقده تجاه مجموعة أخرى، حسب السياقات الاجتماعية والسياسية. حتى من يرتكب أفعالًا مشينة، قد يكون مختلفًا تمامًا في سياقات أخرى، ما يعكس تعقيد البيئة الحاضنة.
المُنظِّرة والمفكِّرة السياسية حنة آرنت أشارت في دراستها للسيكولوجية الألمانية إلى أن زيادة تماسك الجماعة داخليًا تؤدي غالبًا إلى زيادة كراهيتها للآخرين. من هنا خطر البيئات المنغلقة على ذاتها، التي تُعزز الكراهية تجاه الآخر. هناك عاملان أساسيان يفسّران هذه الظاهرة: أولًا، التراكم التاريخي الذي يُشكل العواطف الحالية، وثانيًا، الوهم بعالم عادل، فالدماغ يسعى لتبرير العالم كمكان منصف عبر إعادة إنتاج الظلم الذي تعرض له الفرد.
التحدي الأكبر يكمن في مواجهة الحقائق التاريخية بشجاعة وقبول تعقيد التجارب الإنسانية، بعيدًا عن السرديات المبسّطة التي تسعى إلى تصوير الذات دائمًا كمنتصر أو ضحية. يتطلب تجاوز هذه المعضلة تطوير سرديات جديدة تُعيد بناء علاقة عادلة بين المجموعات المختلفة، وتعزّز المرونة الفكرية لقبول الأخطاء ومواجهة الماضي بصدق.
ختامًا، تؤكدين أنه يمكن استعادة التعاطف من خلال التركيز على طرح الأسئلة بدلًا من تقديم حلول مباشرة، وإبراز قيمة الاختلافات عوضًا عن السعي لإيجاد أوجه التشابه، إضافة إلى تبني قصص الآخرين مع الاعتراف بعدم قدرتنا على فهمها بشكل كامل. هذه نقاط مهمة للغاية، خاصة في سياق الحديث عن أهمية الالتزام بالقانون الدولي. لكن كيف ترين دوره اليوم في ظل العجز الواضح الذي أظهره أمام الإبادة في غزة؟
قبل الحديث عن القانون الدولي، يجب فهم طبيعة البشر كمخلوقات اجتماعية تضع قواعد لضمان استمراريتها، وهي ليست حكرًا على الإنسان، بل تمتد إلى الكائنات الأخرى مثل الفئران والقرود. هذه القواعد تُنظم العلاقات داخل المجموعة، ويمكن أن تُبنى على التوافق أو أن تُفرض بشكل ديكتاتوري. حتى الأطفال، في ألعابهم، يبتكرون قواعد تمثل تمرينًا على الحياة، يتعلمون من خلالها مهارات التفاوض والتسوية، والعمل الجماعي. ويمكن اعتبار القانون الدولي امتدادًا طبيعيًا لهذه القواعد، لكن للأسف تطلّب وقوع جرائم كبرى ودمار في أوروبا لإرساء معاييره العالمية.
ورغم نشأة القانون الدولي في سياق هيمنة القوى الغربية، إلا أنه يُعد خطوة أساسية لتنظيم العلاقات الدولية وحماية الأرواح. فهو يُعرّف الجرائم مثل الإبادة الجماعية، والفصل العنصري، وتدمير البيئة، ويهدف إلى منع الجرائم ضد الإنسانية. على سبيل المثال، ينص القانون على حماية المباني التي تحتوي على مدنيين، حتى في حال الاشتباه بوجود إرهابيين فيها، لتقليل الخسائر البشرية والحفاظ على الأرواح. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار تدمير المنازل في غزة بحجة وجود إرهابيين انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بل يُمكن تصنيفه كعمل إرهابي، كما هو الحال في عملية البايجرز.
المشكلة إذًا ليست في وجود القانون الدولي بحد ذاته، بل في عدم تطبيقه بشكل عادل ومنصف. خلال السنوات الأخيرة، برزت أمثلة تُظهر قدرة القانون الدولي على الحد من الانتهاكات إذا التُزم به، مثل البروتوكولات الإنسانية الدولية. لكن طبعًا هناك ضرورة لإصلاح القانون الدولي ليصبح أكثر شمولية وعدالة، دون أن يبقى أداة تخدم القوى الكبرى فقط.
في النهاية، التخلي عن القانون الدولي لصالح العواطف الفردية يمثل خطرًا كبيرًا. فرغم عيوبه، يظل القانون الدولي أداة ضرورية لضبط العلاقات الدولية ومنع الفوضى، ويمكن لتطبيقه حتى بصيغته الحالية أن يحد من الجرائم ويمهد الطريق نحو عالم أكثر إنصافًا.