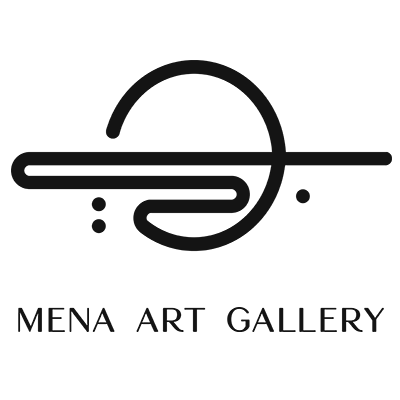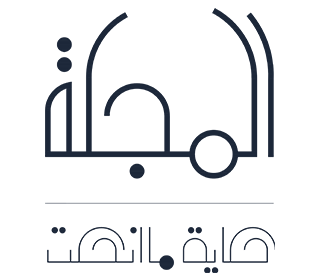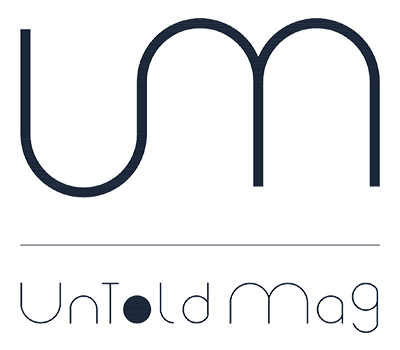هل هناك حقيقة ما في مكانٍ ما في المدينة؟ وهل يمكن أن نصل إليها؟ أين الطريق؟
حكايات الناس هي حكاية المدينة… هي تاريخها الممحي. في خضم تدميرها المدينة، تسعى آلة الحرب الإبادية إلى محو ذاكرتها غير المدوّنة أيضًا.
ليست الذكريات تلك التي نستعيدها فقط حين نخلو بأنفسنا في مكان هادئ، بل هي أيضًا داخلنا، نحملها معنا ونتنقل بها، نهرب من الموت و ننجو بها. هي متجددة مثل بحر غزة، حتى تلك الذكريات القاسية، في ليالي الخيام القارصة.
تقع العين على “صورة” تظهر لنا فجأة من بين كومة الرماد الذي ننفضه عن أرواحنا كل يوم، من بين صور الدماء و الأشلاء التي ترصد لحظة الموت، لا لحظة النجاة، ذاكرة تتأكد أنها مرت ولن تعود. تأخذنا اللحظة بعيداً إلى زمن الصورة، نتأملها ومن فيها من دفء، ونتذكر كم كنا محظوظين بتلك اللحظة، وكم أسعدتنا دقائق دافئة في إحدى زوايا المدينة. أخاف كل يوم أن تُصادف عيني مشهدًا للحياة، أخاف أن أقضي الليل بين الصور التي لن تعود.

وتتهشم ذاكرتي التي فقدت الزمان و المكان و الأشخاص.
كانت مدينتي مثل كل المدن حولها. تخجل من حكاياتها فتخفيها، وتضيق على من يحاول نبشها.
لم تختفِ غزة وحاراتها وشوارعها وأزقتها وأسواقها وبحرها من ذهني، حاضرة هي دائماً، مع كل صورة و خبر عن دمارها. تلك المدينة التي تواجه الإبادة الممنهجة للإنسان والتراث والثقافة.
رغم محاولات جيش الاحتلال تدمير ذاكرة المدينة وتاريخها، استحضرها حيث تتوالى الصور من هنا وهناك، من بيتي في مخيم النصيرات، إلى طريقي الجامعي كل يوم، مرورًا بشارع البحر صباحًا، وإيابًا من شارع صلاح الدين.

كان والدي غالبًا ما يتركني في “الشجاعية”، هناك في أسواقها، قرب المسجد القديم الذي يطل على منتزه الشجاعية ومدرستها. تتوارد صور رجال بشعر شائب، يستعدون لحصد القمح، وتحضير موسم الدقة، وفتح محلاتهم التجارية الموروثة عن أجدادهم في سوق الزاوية، ذلك السوق الذي يتميز برائحته واكتظاظ سكان القطاع فيه، القادمين من كل المحافظات، خلال المواسم و الأعياد.
ما زال طعم عصير الخروب من العربات الصغيرة محفورًا في ذاكرتي، وأتذكر جيداً العم أبو سامي الذي كان يتجول بعربته كل يوم، كانت أمي تشرب منه الخروب في طفولتها، وأنا أيضًا. صوت الأذان من المسجد العمري في غزة القديمة، و أجراس الكنائس يوم الأحد، والشُرفات المغبرة.

غزَّة عِطرٌ لا ينتهي، يتوسط الغيوم المَحْشوة بندى الخريف، تحبل أرضها بأشجار البرتقال والزيتون الأخضر، تفرش صدرها لنا بالزنبق الليّلي. تُبكينا تارًة وتُضحكنا تارًة أخرى، يتكالب عليها باستمرار كُلّ الغُزاة. تقول لي أُمي دائمًا: سيعود ورد المدينة المُزهر، وسينمو النعناع في كأس الشاي الاخضر، وسنغفو نحن كأولاد تعبوا من الركض في أحضان الطبيعة. أسير كل يوم في شوارع غزة، أبحث عن تلك الإيقاعات والصور العتيقة للمكان في رأسي، كان الإيقاع محمولًا كأنّني أستعيد غزة كلها دفعة واحدة، تملأ حواسي الخمس، أو ربما تخلق لي حاسة جديدة من شدة التأمل والشوق.
أمشي في سوق الخضرة، حيث تصطف المخللات والفلفل والزيتون والخُضار بألوانها المختلفة. تشدني الروائح الشهية، تنبعث ذكريات الطفولة من أقصى زاوية في عقلي. أتذكر يوم الاثنين، حين كان أبي يحملنا في السيارة لشراء حوائج البيت من الخضار والدواجن، إذ كان يوم الجمعة مخصصًا لذلك، وتطفو صور الناس وهم يتزاحمون، يلقون التحية على الباعة.
وجدت نفسي مرة أخرى في حي الرمال، الذي يعتبر مركز المدينة. تأخذني الرائحة إلى المنزل الذي كبرت فيه، بيت الجدة أُم معاوية، الذي يحتوي على ساحة كبيرة و صور معلقة على الحائط، لأبنائها الذين فقدتهم على يد الاحتلال. هناك كنت، محاطة بأحبائي، الذين يتمتع كل منهم بخصوصية ما ورائحة طبيخ مخصصة في كل منزل، و لكل فرد منهم أسرار مخبأة في كل ركن من هذا المنزل الكبير وعالمه الكبير، ما بين الموسيقى والأدب والحب والدين والعلم.

أتذكر طبخة السماقية التي تعدها جدتي وتجمع العائلة كل خميس في البيت، أتذكر الفراش الذي نَباتُ عليه والمشط المُسنن الذي تسُرح جدتي شعرها به. لقد احترق، قتل الاحتلال جدتي عن عمر ٩٤ عامًا عند اجتياحه مدينة غزة في مارس/آذار في حصار مشفى الشفاء، ذهبت وحيدة دون أحفادها المئة وأولادها العشر.
أعود إلى المخيم، الذي ولدت فيه، ويبعد عن مركز المدينة مسافة ربع ساعة بالسيارة. كل شيء في المخيم له ذاتية مختلفة، الأشجار والسكان، حتى شكل البيوت، والأزقة التي تفوح منها روائح الطعام من كل بيت وتسمع فيها أحاديث الناس في المنازل. النساء الجالسات على عتبات بيوتهن، ومدارس وكالة الغوث، والزي المدرسي المخطط، وعيادات الوكالة، ودفتر العائلة الأزرق الذي نحمله لإثبات إننا لاجئون، والخالة رِحاب التي تذكر البلاد جيداً، حيفا و يافا وقطرة.

هذه الذكريات والأماكن التي حفظناها بصوت ضحكات الأصدقاء في شوارع المدينة، وأحلامهم التي كبرت معهم في الطرقات، وأحلامنا التي دفنت تحت الركام. حتى أصدقاؤنا، قتلتهم آلة الحرب، وما زالت أجسادهم تحت الركام حتى هذه اللحظة.
لقد دمرت آلة الحرب 206 مواقع أثرية في قطاع غزة، واستهدفت ذاكرة المكان وكأنها تريد لكل القطاع أن يختفي، تحاول أن تمحو كل شيء ينتمي إلى القطاع . استهدفت آلة الاحتلال المواقع والأماكن التي شهدت وخبأت أحلام شباب قطاع غزة، وضمّت ذكرياتهم و صوت الضحكات مع الأصدقاء. دُمرت المواقع الفكرية والثقافية، وتحولت إلى رُكام. هذا مثلًا كان حال مركز رشاد الشوا الثقافي، الذي يُعد أول مركز ثقافي بُني في فلسطين، وتحوّل بفعل محاولات إبادة المدينة، الى كومة من الركام ورماد من الكتب المحروقة.