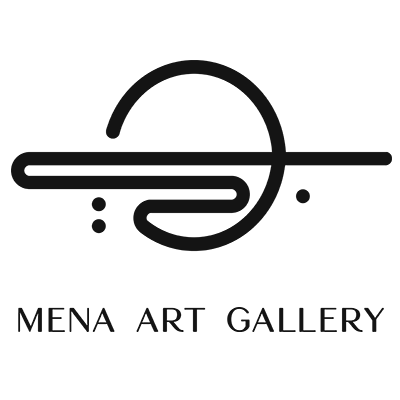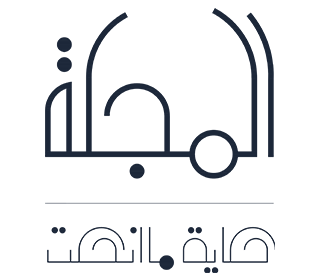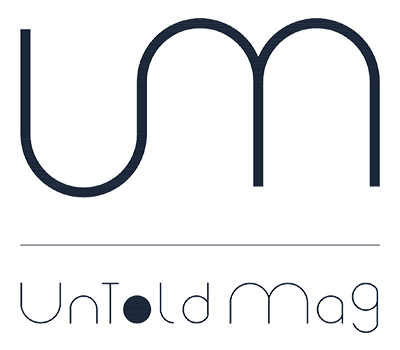حسناً، هكذا يبدو المشهد من الداخل، مجموعة من النسويات الغاضبات، ثلاثة؟ أربعة؟ العدد ليس ثابتاً، تبدو النسخ متطابقة من الخارج، جباه بواحدات بين الحواجب، شفاه مزمومة، وأعين مستعدة لتدور في الرأس على شيء ما. هناك أنا، لكنها كثيرات، وكلّ واحدة تبخّ في وجه الثانية وتقول لها “اسكتي، مو وقتها هلأ”.
في السطور القادمة أتحدث إلى نفسي، وإليكنّ، عن رحلتي من الاغتراب النسوي إلى الانفصام النسوي. بينما كان تشخيص وفهم الحالة الأولى غنياً وممتعاً، بدت صياغة الحالة الثانية منهكة ومحبطة. ليس أنّه لم يُحك عنها أبداً، لكنني كنت أبحث عن تطابق نسوي وجدته بسهولة حين كنت مجرّد نسوية مغتربة عن عالم بطريركي. هنا محاولة لمدّ جسر بين المنفصمات نسوياً، ووضع طوبة إضافية في البناء المعرفي حوله.
ليسقط النظام، مو وقتها هلأ:
لا أذكر وقتاً في حياتي لم أكن غاضبة فيه. لم يكن يُسمّى غضباً في السابق، كنت “نمرودة”، “عصبية”، “نكدية”، “مش عاجبها شي”، ووقحة أحياناً. كنت نسوية رقم 0. لطالما شعرت بحنق يشبه نبتة فلفل تنمو في رأس معدتي، لا أعرف متى نبتت وكيف تهدأ، وما الذي سيطحنها تالياً لتشتعل وتقود إلى سلوك غير مدروس، يكلّفني كثيراً بعدها، ويغمرني برضا يشبه الخطيئة. منذ محاولات تدجيني في روضة القبيسيات، حتى اشتباكاتي مع مشرفة الملابس (التسمية المدنية لمدربة الفتوة بعد إلغاء مادة الفتوة من المدراس) في الإعدادية، وصولاً لامتناعي عن المسيرة المدرسية وخروجي في أوّل مظاهرة ضد النظام في 2011 قبل أن أتمّ الثامنة عشر.
مع بداية الثورة لم أعرّف نفسي كنسوية. بدا لي فصل حقوق الإنسان عن بعضها أمراً مشتّتاً وغير ضروري؛ لدينا اليوم نظام سياسي يضطهد النساء والرجال، يضطهد حتى الحشرات نظامنا، فلنتخلص منه أولاً، ولنرَ لاحقاً. وكنت من المدافعات عن هذه الفكرة حتى نهاية 2013. وحين بدأ اليأس من سقوط عاجل للنظام يتسلّل إلى قلبي، لنقل قبل نهاية 2013 بقليل، بدأت أفكر أنه ربّما يمكننا الالتفات لخصوصية اضطهادنا كنساء، لأننا نساء. وبالطبع تعالت أصوات رفاق الدرب بأنه “مو وقتا، ليسقط النظام”. وعشت معركة حقيقية، مع ذاتي أولاً التي بدأت تقبل بتعريف نفسها كنسوية، نسوية 1، تتعافى من النظرة الأبوية لنسويتها، ومع الرفاق ثانياً، ومع النظام، عدوّنا المشترك الذي أنتج هذا المجتمع الذي أثور عليه غاضبة منه. ليست جبهة رؤوفة بضآلة فتاة في العشرين.
بعد انغماسٍ في قراءات نسوية كلاسيكية، وأخرى أقلّ كلاسيكية، بهدف تشخيص حالتي، عرفت أنّني أعاني من الاغتراب النسوي. هذا الاغتراب هو شعوري بالانفصال عن المجتمع الأبوي حولي، عن الآخر الذي لا يعترف بشرعيّتي، عن جسدي وصوتي، عن بشريّتي التي لم يُسمح لها يوماً بالتحرّك خارج القفص الجندري الذي وضعوني فيه منذ أصبحت فتاة كبيرة في حلب.
في كتابها “عيش حياة نسوية” تخبرنا سارة أحمد أنّ بإمكاننا اختبار النسوية كاغتراب، وتشرح كيف يمكن أن تمتزج عملية تعرّفنا على الطريقة التي تشكلت بها حياتنا باغترابنا عنها. نعم أقتبس سارة كـ”قاتلة بهجة” تقليدية، وأتفق معها. ظهرت النسوية الأولى داخلي مع شعوري بالاغتراب النسوي. كلّ ما حولي كان مصمّماً بطريقة معادية للنساء، مادياً ومعنوياً. بدءاً من النسق السياسي والاقتصادي، وصولاً لحبوب الدواء ومقاسات الخصر، خصري بحدّ ذاته وليس الملابس. وأعتقد أنّ هذه طريقة شائعة للتعرّف على النسوية داخلنا. ثم إن كانّ كل شيء حولي غريباً عني، فلأغيره ليشبهني، ويتواءم مع احتياجاتي، سهلة!
الاغتراب النسوي هو شعوري بالانفصال عن المجتمع الأبوي حولي، عن الآخر الذي لا يعترف بشرعيّتي، عن جسدي وصوتي، عن بشريّتي التي لم يُسمح لها يوماً بالتحرّك خارج القفص الجندري الذي وضعوني فيه منذ أصبحت فتاة كبيرة في حلب.
دعني أوضح هنا السخرية الواضحة، لم تكن سهلة، ولن أجندر “دعني” فلا أتصوّر امرأة لا تعرف وتعيش صعوبة التغيير. في سنوات الثورة، ثمّ الحرب، تقلّصت إلى نسخة بائسة من قصيدة بول إيلوار عن الحرية، أصبحت أكتب على دفاتري وعلى الأشجار، وعلى الثلج وأسلحة المحاربين، على تيجان الملوك وصدى طفولتي، فوق الغياب القسري، والعزلة العارية، عنف عنف عنف عنف. كتبت عنف، وشعرت أنني ولدت لأسميه، لأتعرّف عليه، ولأعلّق حياتي بانتظار أن ينقضي.
افتقدت وقتها صديقاتي في ثانوية البنات، متمردات وثائرات، ولم يكن النظام التعليمي البعثي قد نجح في كسرنا جماعياً. أعرف اليوم أنّ كلّ تفاصيل أيامنا وقتها مقاومة نسوية، من خط الكحل الممنوع في عيوننا، تضييق قمصاننا الوردية عند الصدر، الهروب من الحصة السابعة، رواية النكات البذيئة، وتدخين سيجارة بالسر. كان غضبنا منتجاً، محرّكاً، دافعاً، وهذا أكثر ما افتقدته.
على مدار سنوات إقامتي في حلب حتى نهاية 2016 لم تتم دعوتي فيزيائياً لأيّة مساحات نسوية، ولم أفكر آنذاك بتشكيل المساحات التي افتقدتها، حتى على نطاق ضيّق. هربت إلى مساحات افتراضية، صديقات حقيقيات في فضاء افتراضي، نتحدث عن النجاة، ولا شيء غير النجاة. نجاة من عنفٍ يخرج من بين أصابعنا أحياناً. هذا ما تفعله بنا “الحياة العارية”، قصّرت في قراءة أطروحات الفيلسوف الإيطالي، جورجيو أجامبين، من منظور نسوي، لكنني فهمتهما كإنسانة حرب، مُسخ وجودها السياسي.
لم يكن سهلاً التحول إلى امرأة ثائرة في حلب. مدينة سورية منغلقة ومغرقة في بطريركيتها. لم أشبه بنات جامعتي أو حيي، ولم يكن لديّ طاقة بذل مجهود العثور على من تشبهنني خارج الفيسبوك، ولم تّتواجد أيّ من صديقاتي الافتراضيات في حلب آنذاك. كان اغتراباً قاسياً حتى عن النساء اللاتي لم يكنّ جاهزات للتخلّي عن الأدوار المرسومة لهنّ منذ ولادتهنّ.
نتج عن هذا الاغتراب عزلة اجتماعية فيزيائية. قضيت سنواتي الجامعية بجدية مبالغ بها، وددت أن أكون نسوية مثالية، تحصل على علامات كاملة، تخوض نقاشات فكرية وتكسبها، “جدعة” ولا يمكن أن ندوس لها على طرف. كنت “قاتلة بهجة” لكنها كانت بهجتي الذاتية. ومع كلّ ما يمكن أن نعيشه في حرب، دخلت في سلسلة من نوبات القلق والأرق، والاكتئاب. ولم أملك أدنى رفاهية التوقف، أخذ نفس، وترميم صحتي النفسية.
ثمّ في نهاية 2016، بعد نوبات غضب وثورة جرّتني إلى سلسلة تحقيقات وتهديد بالاعتقال، حزمت عائلتي أمتعتها إلى فرنسا. هناك سأكتشف معنى أن أكون لاجئة، وسأتعرف على ذاتي الناشطة، من المنفى.
مو وقتها هلأ، وبس! أو كل القضايا وقتا، فما العمل؟
منذ وضعت قدمي في فرنسا أردت أن أعود، لكن هذا ليس موضوعنا. كان الاغتراب مألوفاً بالنسبة لي، لكنه صار مشروعاً هنا، اسمه غربة، ونشعر به تجاه المنفى. لم أجد المنفى المُرمنس (من الرومانسية) في الشعر والأدب، وجدت كلّ ما جعلني أقول: “أها! لهيك كان المنفى حكم من زمان”. لكنني “هنا” امتلكت كلامي. أصبحت قادرة على نشر ما يحدث في سوريا دون تشفير، ودون خوف من الاعتقال.
في الريف الفرنسي أصابتني لوثة التوثيق، شعرت أنني خرجت من سوريا بذاكرة ليست لي، ذاكرة لسرديتنا، عليّ كتابتها، وتوثيقها، وحفرها في دفاتر وتخزينها في محافظ إلكترونية. بتّ مثل مخبولة تعتقد أنها آخر “الناجيات”. هذا التوثيق تزامن مع تهجير حلب الأخير، والأكثر تراجيدية. أشاهد الفيديوهات والصور، أقرأ الشهادات، وأعود إلى ما أودّ كتابته، وهنا ولدت نسوية صغيرة تزنّ في رأسي، لنسمّها نسوية 2، “مو وقت الحكي عن التحرّش عالحواجز”.
كلّ ما حولي كان مصمّماً بطريقة معادية للنساء، مادياً ومعنوياً. بدءاً من النسق السياسي والاقتصادي، وصولاً لحبوب الدواء ومقاسات الخصر
الوغدة معها حق، من يكترث لتحرّش لفظي وجسدي نتعرّض له على الحواجز العسكرية في حلب؟ الناس تموت، وتُسلب منها أرضها بالتزامن، علينا أن نشدّ المجتمع الدولي من ياقته، أو ننزل على ركبنا ونتوسله بمبادرة أقل نسوية، ليتفرج ويهتمّ ويفعل. كانت تتجادل معها النسوية 1، تذكّرها أنّنا بذلنا مجهوداً خرافياً لنتخلّص من سُمّية ترتيب الأولويات الذي يُعلي صوت المعركة ويدوس قضايا النساء. يتصاعد الخلاف، يهرس نبتة الفلفل في رأس معدتي، أتكوّر بعد نوبة هلع، ولا ينتج عن غضبي إلا الهراء.
في الأشهر الأولى عشت معزولة تماماً عن المجتمع، باستثناء رحلاتنا اليومية إلى المشفى لمرافقة أمي في رحلة التداوي من السرطان، ودروس اللغة الفرنسية. تعاطيت مع المجتمع الصغير أول ما تعاطيت كطالبة لجوء. هكذا عرّفت نفسي، وهكذا ألصق المجتمع هذه الماركة على جبهتي. تمسّكت بها، انتميت إليها، شعرت أنني لاجئة فعلاً، بكلّ ما تحمله الكلمة من قهر، ودونية، وفاعلية سياسية.
أصنّف نفسي كنسوية تقاطعية، لكن ما يتقاطع في سوريا يختلف عمّا يتقاطع في فرنسا. أذكر حضوري محاضرات في جامعات ومؤسسات كبيرة، للتدرب على اللغة، وكمحاولة بائسة للتغلّب على فكرة اللجوء. أذكر بشكل حيّ تماماً أنني ملت على أختي في ندوة حول المهاجرين/ات، وقلت لها هناك الكثير من النساء، كنت سعيدة بذلك. على يميني مالت فتاة مهاجرة على صديقتها، وقالت: “فقط رؤوس بيضاء!”.
أنا إذاً لاجئة، لا صوت لي في بلادي، ولا أحد يمثلني في المنفى، بسم الله نبدأ رحلة استعادة الصوت السياسي. هنا لم تنتفض النسويات، انتفض المنطق نفسه، تريدين صوتاً سياسياً قبل أن تملكي صوتاً للسؤال عن الاتجاهات في الشارع؟ نعم، سأكون ناشطة لحقوق اللاجئين/ات، ولن تكون ناشطية اختيارية. صيف 2017 ولدت النسوية رقم 3، ترى عدستها العنصرية أول ما تراه، الإقصاء والتهميش بناء على الحالة القانونية، ولون البشرة، ومن منظور نسوي تحديداً.
لم تحبّ نسوية 1 النسوية 3. أول مرة قابلتها صرخت “مو وقتا” حتى انفجرت حنجرتها. الناس تموت في سوريا، وهذه المتماهية مع العالم الأوّل تريد مشاركة سياسية للاجئات، أليس إيقاف الحروب ومسبّبات اللجوء أولى؟ نسوية 3 ليست أكثر هدوءاً، تصرخ صرخة لم تعتد توجيهها لنسوية “وقتا ونص”. وبينما يبدو الوصف كوميدياً، إلا أنه في الواقع صراع نفسي مُستهلِك دون جدوى. ومجدّداً تضيق مساحات التشبيك والالتقاء في مساحات بعيداً عن سياط “مو وقتها”.
أفكر بالكتابة على الفيسبوك، أكتب بالفعل، ثم أمسح غالباً. هل أحدّث صديقاتي في سوريا عن العنصرية في سوق العمل الفرنسي؟ هل أحدّث صديقات مصريات عن عدم توفر وصول للرعاية النفسية “هنا”؟ هل أحدّث صديقات لاجئات في تركيا عن شوقي لحديقة السبيل؟ مو وقتا!
لم يفارقني الاغتراب النسوي لكن الشجار الدائم لجوقة النسويات داخلي كان يمنعني من إعطاء شرعية لأي نوع من المشاعر، ويدفعني للتشكيك في ترتيب أولوياتي الذي بات يأخذ منحى أفقي على حساب ما تبقى من سلامتي العقلية.
انقسمت ناشطيتي في فرنسا إلى ناشطيتين، ناشطية فيزيائية و”لينكدإنية”، تركز على قضايا اللجوء من منظور نسوي، وتحديداً الصحة النفسية والاندماج المهني، وناشطية فيسبوكية وضمن تنظيمات سياسية سورية افتراضية، تركّز على دور النساء في بناء مستقبل بلدنا البائس. من وقت لآخر كانت تختلط الأمور، فأحتقن مثلاً في حدث فرنسي وأطالب الناس ألا ينسوا سوريا ومسبّبات اللجوء. المشترك في كلّ وقت هو الإحساس الدائم بالذنب، ذنب الناجية التي لا تعرف كيف تخرج النسويات من داخلها لتناضل كلّ واحدة منهنّ لقضية، كيف ينفجر الغضب المبارك. كل القضايا وقتا، فما العمل؟
شيئاً فشيئاً، تحول هذا الصراع الداخلي إلى صراع واقعي خارجي. مع الشيطنة المتصاعدة للنسويات السوريات في كلّ مكان؛ من جهة شيطنة تستند إلى موروث ديني يرفع سيف قداسته في وجهنا، ومن جهة ذكورة هشّة لا تفوّت فرصة لاتهامنا بالهسترة والتطرّف. نتحدث عن تنقية الخطاب اليومي من التحيّز الجنسي، فنُشتم، نتحدث عن حقوق النساء بامتلاك أجسادهنّ، فنُشتم، نفضح متحرشين ومغتصبين، فنُشتم، نتحدث عن حقوق مجتمع ميم عين فنُشتم، نتحدث عن تشكيل سرديتنا، فنُشتم، حتى إذا تحدثنا عن الرياضة نُشتم. ناهيك عن نقاشات محمومة عن انفصال النسويات عن واقع النساء. الأخيرة كانت تُربكني فعلاً، كأننا نُجرّد من نسائيتنا عندما نصبح ناشطات لحقوقنا، وعلينا أن ندافع عن أنفسنا أمام تحقيرهم مُعاش غيرنا لإبراز هذا الانفصال المزعوم. هل نعمل أم نقاتل لانتزاع شرعية نسوية من كلّ الأطراف؟
نتحدث عن تنقية الخطاب اليومي من التحيّز الجنسي، فنُشتم، نتحدث عن حقوق النساء بامتلاك أجسادهنّ، فنُشتم، نفضح متحرشين ومغتصبين، فنُشتم، نتحدث عن حقوق مجتمع ميم عين فنُشتم، نتحدث عن تشكيل سرديتنا، فنُشتم، حتى إذا تحدثنا عن الرياضة نُشتم…
إذاً، نسويتي هنا تتقلص وتُختزل إلى حفيدة ساحرات، توثق وتكتب وتنتج لتصرخ معرفياً بينما يحرقها حراس البطريركية، “لكنني أتعرّض لتمييز بناء على نوعي الاجتماعي!”
قررت في لحظة مشؤومة أن أحوّل ناشطيتي الفرنسية إلى عمل بدوام كامل، في جمعية للاندماج المهني للاجئين/ات. قرار سأندم عليه طويلاَ، خسرت فيه استقلاليتي وقدرتي على التعبير عن رأيي بحالة سوق العمل، إضافة لتواجدي في بيئة سامة، تريد مكاسب توظيف لاجئة، ولا تريد بذل أي مجهود لبناء بيئة أقل بياضاً. انتهى الأمر باحتراق وظيفي ومغادرتي العمل، ونوبة اكتئاب ألزمتني فراشي عدّة أشهر عصيبة. لن أكرّر هذا الخطأ، كان قراري بعد التجربة.
مع ملامح استقرار مادي بدأت أسمح لنسوية 4 بالهمس بصوت أعلى قليلاً، ولدت في وقت غريب مع الكورونا في 2021، وأسكتتها تجربة العمل آنفة الذكر. ذات يوم سمعتها تطلب إذناً للكلام: “منحكي عن الحياة بعد النجاة؟ ولا مو وقتا؟ إذا مو وقتا بتفهم”. نسوية 4 لديها قلق اجتماعي، وتخاف كلّ النسويات الأخريات، لا أحد منهنّ يعتقد أنّ لها أولوية، أو ستكون لها في المدى القريب. لكنّها تدفعني للتفكير فعلاً. إن كانت نسوية 0 تنتمي إلى الموجة النسوية الثانية، والنسوية 1 تنتمي للموجة الأولى، والنسوية 2 تريد الولولة والندب على الحرب دون انتماء إلى موجة أو مدرسة، والنسوية 3 تبدو متسقة مع الموجة الثالثة، فماذا تريد نسوية 4؟ ومع من تتضامن وتتحد؟
“آ آ، أتضامن مع نفسي. لا أريد أن أنجو من شيء، أو أهرب من شيء، أريد أن أحيا”، نسوية 4 تجعل مهمّة الدفاع عنها صعبة. أنا لا أنجح حتى في الاجتماع فيزيائياً مع نسويات لنقاش ما نتفق أنّه أولويات، وأتلقى تهديدات مباشرة بالقتل حين أتحدث عن قضايا النساء ومجتمع ميم عين، ولديها جرأة طرح موضوع الحياة، الحياة الحقيقية التي لا يكون جوهرها النجاة. وقتا هلأ؟
تصف نسويات 0 و1 و2 و3 النسوية 4 بالبيضاء، وتسخرن من اهتماماتها البيضاء مثلها. نستسهل تخوينها إذا ما أرادت المشاركة في نقاش افتراضي نسوي حول الضرائب الوردية، ومجانية مستحضرات الدورة الشهرية، ونلومها إذا فكّرت بفتح حديث نسوي مع شريكها حول مهام وحقوق كلّ منهما. نتسامح مع نسوية 4، نسوية العالم الأول، فقط حين تتحدث عن حوادث قتل النساء في فرنسا، وربما قليلاً حين تنتقد الخطاب المتحيّز جنسياً في الإعلام.
هذه النسوية ذاتها تتداعى حين تتلقى خبر مجزرة أو مجاعة في سوريا، بينما تناقش قضايا متصلة بكونها امرأة مقيمة في دولة عالم أول، قضايا بتفاهة وأهمية إضراب وسائل النقل، حقوق العاملات، وظروف عمل الممرضات/ين. تصفعها الأخبار وتعيدها إلى النقطة صفر، إلى نسويتها العارية. “يمكن ما كان وقتا؟”، “يمكن ولا مرة رح يكون وقتا؟”.
لكن ألم تكن أحلامنا جميعاً الوصول إلى ما وصلت إليه النساء صاحبات الامتيازات؟ أو من نجحن بانتزاع حقوقهنّ من أدنى سلّم الامتيازات؟ لماذا “نرتاح” في منطقة السعي المحدود للنجاة؟
في خضم إنهاك الانفصام النسوي يغدو الجدوى والمعنى محرّكين مهمّين. جلست في الأسبوع الماضي أفسّر لرجل أبيض، بهدوء تحوّل لانفعال، لماذا لا يمكنه كرجل أبيض تحديد احتياجاتي كلاجئة منفرداً، ولماذا أتحسّس من محاولات مصادرة ناشطيتي ممن لسن لاجئات. وبينما دخنت سيجارة بعد سيجارة، سألت نفسي “لشو؟”. ألحّ سؤال الجدوى، ما الهدف من كلّ هذه النضال والحفر في الصخر؟ وهل ستتاح لك فرصة رؤية ثمار احتراقك النفسي والسياسي؟
أخشى أن أسأل نفسي ما لو استيقظت لأجد مصادر العنف انتفت من حياتي بشكل سحري؟ ما هي الحياة التي أحلم بعيشها لو لم أكن ثائرة، إنسانة حرب، ثم لاجئة؟ ماذا يعني أن تكوني امرأة حين يُنزع النضال ضد شيء ما، من حياتها؟ هذه الأسئلة غير ملحّة بالنظر لواقعنا، لكنها أساسية لصياغة مطالب محدّدة، يجعلها تحديدها قابلة للتحقيق. في الحقيقة، أحتاج لطرح الأسئلة لإحياء الجدوى من نضالي النسوي بكلّ أشكاله، ولأتذكّر أنني ولدت لأسمّي الحرية وليس العنف.