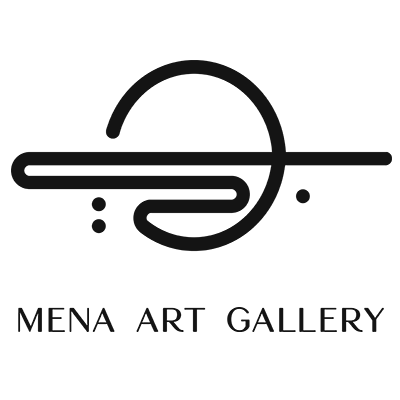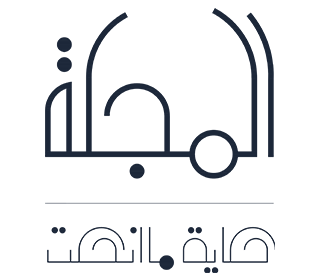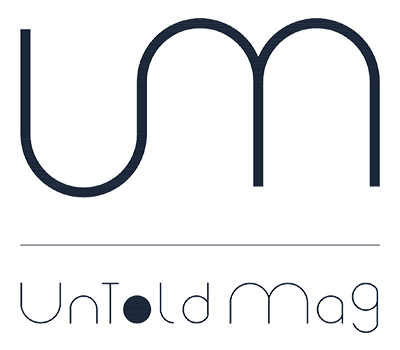في 22 يوليو 2024، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، أثناء عودتي إلى المنزل في منطقة أفجلار بإسطنبول، أوقفني رجال الشرطة وطلبوا مني إبراز بطاقة الإقامة (المعروفة باللغة التركية باسم “إقاميت”). كانت بطاقتي السابقة قد انتهت صلاحيتها في نهاية أبريل 2024، لكنني قدمت طلب تجديدها وأرسلت جميع الوثائق المطلوبة إلى سلطات الهجرة في أوائل مايو.
غالبًا ما تتم متابعة الطلبات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو شهر كحد أقصى. أما في حالتي، فلم أتلّق أي رد لأكثر من شهرين. وعندما استجوبتني الشرطة، كنت من دون بطاقة هوية لما يقارب الثلاثة أشهر. حاولت أن أوضح للضباط أنني اتبعت جميع الإجراءات المطلوبة عند انتهاء صلاحية بطاقتي، وأن التأخير كان من جانب سلطات الهجرة.
ومع ذلك، لم يقتنعوا بتفسيري، وأبلغوني أنهم سيأخذونني إلى مركز فحص كبير في منطقة إسنيورت، التي تُعرف بتواجد كبير للأجانب. طُلب مني الصعود إلى شاحنة ستنقلني إلى المركز مع آخرين أوقِفوا أيضًا. للتوضيح، يُعدّ توقيف الأجانب للتحقق من بطاقاتهم إجراءً روتينيًا في البلاد.
الطريق إلى الاحتجاز
داخل الشاحنة، قام رجال الشرطة بتفتيشي وأخذوا جميع مقتنياتي الشخصية، بما في ذلك ساعة، وخاتم، ومحفظة، وهاتف، ووضعوها في كيس بلاستيكي. طُلب مني الجلوس في الخلف والانتظار لبضع ساعات بينما كانوا يواصلون جمع المزيد من الأجانب من المنطقة.
مرت خمس ساعات طويلة وأنا جالس في الشاحنة، لا يحدث شيء سوى الانتظار. لم يُسمح لي باستخدام الهاتف، وزاد الصيام من حدة الإرهاق والملل إلى درجة لا توصف. بعد حوالي ثلاث ساعات من الاحتجاز الانفرادي، انضم إليّ شابان من اليمن. وبعد ساعتين، حوالي الساعة 3:00 عصرًا، انطلقت الشاحنة أخيرًا إلى مركز الفحص في إسنيورت.
وصلنا إلى مركز إسنيورت حوالي الساعة 3:30 عصرًا. أخبرتنا الشرطة أن الفحص سيكون سريعًا وأنه من المحتمل أن نعود إلى منازلنا بحلول المساء. لكن عوضًا عن ذلك، أمرنا بالصعود إلى حافلة كبيرة كانت ممتلئة بالعديد من الأجانب.
اكتشفنا لاحقًا أن الحافلة كانت تأخذنا إلى أرناؤوط كوي، أحد أكبر مراكز احتجاز الأجانب في إسطنبول، بالقرب من مطار المدينة الدولي. كانت الحافلة مكتظة للغاية بالمحتجزين لدرجة أن الممرات كانت ممتلئة تمامًا.
عندما نظرت إلى الخارج، رأيت جدارية كبيرة تحمل علمي تركيا والاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب، مع رسالة تشير إلى أن المركز بُني بتعاون مشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي. معظم الركاب كانوا من جنسيات عربية، بما في ذلك يمنيون، عراقيون، مصريون، سوريون، وفلسطينيون، بالإضافة إلى أشخاص من تركمانستان، باكستان، وبعض الدول الإفريقية الغربية.
قيل لنا إننا سنغادر حوالي الساعة 7:40 مساءً، لكننا انتظرنا لساعات. بدأ المحتجزون يتحدثون مع بعضهم البعض لتمضية الوقت والتكهن بما قد يحدث لاحقًا. حاول البعض ممن احتجزوا سابقًا طمأنتنا بأن الإفراج غالبًا ما يحصل في الليل، مما جعلنا نشعر ببعض الراحة.
لاستعمال الحمام، كنا بحاجة إلى إذن من شرطي يقف عند مدخل الحافلة. تبيّن لاحقًا أن “الحمام” لم يكن سوى خلفية شجرة، وكانت رائحة البول المنبعثة من الأرض لا تُحتمل. عندما عدت، سألني أحد المحتجزين اليمنيين ممازحًا عن حالة الحمام، فأجبت بردٍّ ساخر أضحك الجميع.
لم يُسمح لنا بالوضوء أو الصلاة خارج الحافلة عندما حان وقت الصلاة. من توضأ مسبقًا، أدوا الصلاة وهم جالسون في مقاعدهم، محاولين تقدير اتجاه القبلة. لم يكن هناك سوى القليل من الماء، ولم يُقدّم لنا أي طعام، واستمر هذا الوضع طوال فترة احتجازنا.
طلب بعض المحتجزين السجائر؛ نجح البعض في الحصول عليها، بينما لم يحالف الحظ الآخرين. بقينا في هذا المركز حتى الساعة 10:00 مساءً، عندما انطلقت الحافلة أخيرًا نحو مركز احتجاز أرناؤوط كوي، الذي كان مكتظًا بأكثر من 60 محتجزًا.
الإساءة وسوء المعاملة
كانت هذه وجهتنا الأخيرة، مركز احتجاز ضخم تحت إدارة سلطات الهجرة، يتألف من عدة مبانٍ تشمل مركزًا للشرطة ومركزًا للفحص، قيل إنه قريب من قاعدة عسكرية. في تلك الليلة، حُشر أكثر من 50 شخصًا في غرفة لا تتجاوز مساحتها 10×5 أمتار. النوم كان مستحيلاً، وكنا نعتبر أنفسنا محظوظين إن وجدنا حتى مكانًا للجلوس.
في هذا المكان، شاهدتُ أو سمعتُ مباشرةً عن سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. بعد نزولنا من الحافلة، أُمرنا بالاصطفاف في طوابير طويلة، ننتظر الدخول إلى غرفة حيث تُؤخذ بصماتنا وصورنا. كان علينا الوقوف حتى نعالج، بصرف النظر عن حالتنا الصحية.
رجل مصري مسن، بدا واضحًا أنه يعاني من آلام مبرحة في ركبتيه، لم يكن قادرًا على الوقوف. عندما طلب الجلوس، أهانته الشرطة وهددته بعواقب وخيمة. في النهاية، انهار الرجل من شدة الألم. قام أحد أفراد الشرطة بصفعه وأجبره مع زملائه على الوقوف بالقوة. كان صراخ الشرطة والإهانات المستمرة تهدف إلى ترهيب المحتجزين وإذلالهم.
في صباح اليوم الثاني، سمعنا جدالًا وصراخًا من غرفة مجاورة. كان أحد المحتجزين يتشاجر مع شرطي. أوضح المحتجز لاحقًا أنه عوقب بسبب رفضه الامتثال لأوامر الشرطي، مما أدى إلى إجباره على تنظيف الغرفة وتعرضه لضرب مبرح من عدة رجال شرطة. استمر صراخه وضربه لأكثر من 10 دقائق.
في تلك الليلة، رأيت نفس المحتجز في الطابور، وكان وجهه متورمًا، غير قادر على الوقوف بشكل طبيعي. ولم تتوقف معاناته عند هذا الحد، حيث استمر رجال الشرطة في ضربه بين الحين والآخر دون سبب طوال فترة احتجازي. لم يتقبلوا رفضه لأوامرهم ورده بالضرب على أحدهم عندما تعرض للاعتداء أولًا.
ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الأجانب في مراكز الاحتجاز التركية يواجهون معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وحالات الاعتداء الجسدي، حيث يُحتجز العديد من طالبي اللجوء إداريًا بانتظار ترحيلهم.
كما احتُجز رجل سوري رغم أن إقامته كانت صالحة. عندما سألته كيف يمكنهم احتجاز شخص رغم أن أوراقه قانونية، أجابني بمرارة: “أنا سوري، لا يحتاجون إلى سبب.” وأضاف: “أنتم الأجانب غير السوريين تعتقدون أنكم تعانون، انتظروا حتى تروا كيف يعاملوننا نحن السوريين.”
حاولت مواساته، قائلًا له إنه بعد انتهاء الإجراءات، سيكون عليهم الإفراج عنه لأنه لم يرتكب أي خطأ. فأجاب: “لدي زوجة وأطفال أعيلهم، الإفراج عني لن يعوضني عن الأيام التي سأقضيها هنا بعيدًا عنهم.”
المحتجزون من باكستان وميانمار وبنغلاديش والصومال الذين التقيت بهم أخبروني أنهم وقعوا على أوراق الترحيل منذ أشهر، وكانوا يتمنون العودة إلى بلدانهم والخروج من هذه المراكز. ومع ذلك، ما زالوا محتجزين ويتوقعون أن يستمر احتجازهم لأشهر أخرى.
عندما سألتهم عن السبب، أجابني أحدهم أنه يعتقد أن الحكومة التركية تستخدمهم للحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي. قال: “نحن مصدر ربح للحكومة التركية، التي تحتجزنا وتستخدمنا لتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي. الجميع مستفيد: الاتحاد الأوروبي لا يحتاج للقلق بشأن المهاجرين المحتملين، وتركيا تحصل على مليارات لدعم اقتصادها المتعثر.”
وأضاف: “كلما طالت مدة احتجازنا، زادت الأموال التي يحصلون عليها.”
مشكلة كبيرة أخرى واجهتنا، وهي منعنا من استخدام الهاتف لإبلاغ عائلاتنا وأصدقائنا. خلال فترة احتجازي التي استمرت ثلاثة أيام، لم يُسمح لي باستخدام هاتفي إلا في اليوم الأخير.
التفويض الخارجي وكراهية الأجانب
هذه المراكز وغيرها هي نتيجة لسياسة تفويض السيطرة على الحدود التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، حيث يقدْم مليارات الدولارات لدول مجاورة مثل تركيا، المغرب، وتونس لمنع الهجرة إلى أوروبا ووقف تدفقها. يستفيد الاتحاد الأوروبي من تقليص أعداد المهاجرين مع التهرب من المسؤولية المباشرة، بينما تدمج هذه الدول هذه السياسات في أجندتها الداخلية، وغالبًا ما تعامل المحتجزين بطرق تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
منذ عام 2016، تلقت تركيا أكثر من 9 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار هذا المخطط. إلا أن العديد من المنتقدين أشاروا إلى نقص الشفافية في كيفية استخدام هذه الأموال. وقد اتهم البعض تركيا بتوجيه الجزء الأكبر منها لدعم اقتصادها المحلي، بينما يُخصّص جزء صغير فقط للأهداف المعلنة، مما أدى إلى إهمال المرافق وتدني المعايير في مراكز الاحتجاز.
تعرضت هذه المراكز لانتقادات شديدة لفشلها في تلبية معايير حقوق الإنسان الأساسية والمعاملة القاسية التي يتعرض لها المحتجزون، وفقًا لتقارير العديد من المنظمات الحقوقية.
في تركيا، وهي دولة تتبنى سياسات قومية متشددة، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في كراهية الأجانب، مما جعل فكرة “طرد و/أو احتواء الأجانب” محورًا رئيسيًا في الحملات الانتخابية.
مؤخرًا، فازت الأحزاب المعارضة بغالبية الأصوات في الانتخابات البلدية في المدن الكبرى، مستفيدة من موجة كراهية الأجانب الواضحة. وردًا على ذلك، قام الحزب الحاكم بتشديد الإجراءات ضد الأجانب، بما في ذلك الطلاب. أصبحت عملية الحصول على إقامة عادية أكثر تعقيدًا، حيث تُضاف متطلبات ووثائق جديدة كل عام.
على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولية ضمان أن تُستخدم أمواله للأغراض المخصصة لها. يجب عليه محاسبة الحكومات التي يفوضها لحماية حدوده، والتأكد من القضاء على جميع أشكال سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون.
*عُدّلت بعض التواريخ في هذا النص لحماية هوية الكاتب.