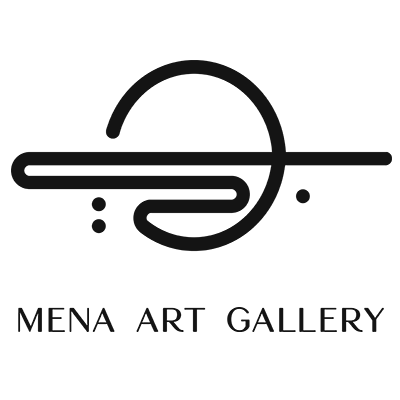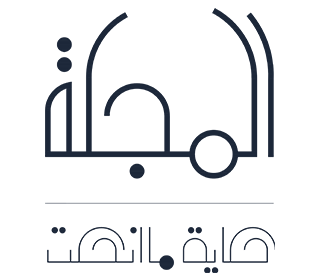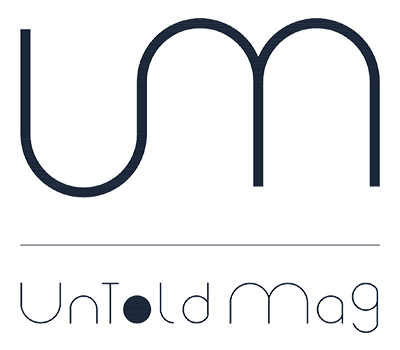مرّ وقت طويل على آخر مرة مشيت فيها بالطبيعة. في تلك المرة الأخيرة، كان شخص آخر يسير خطاي، كشخص بديل.
هل سبق لك أن مشيت في حذاء شخص آخر؟ هل شعرت بما شعر به هو؟ هل تذّكر جسدك تلك التجربة كما يتذكرها جسده؟“
بحثت عن “الشخص البديل” بعد أن رفضت السلطات الهولندية تمديد تأشير إقامتي كطالبة في هولندا. اعترضت على القرار، وأخذوا يعيدون النظر فيه. لكن بالأثناء، كان عليّ الانتظار في هولندا محظورة من السفر إلى اي مكان، وحتى من زيارة بلدي لبنان.
استغرقت مراجعة القرارعامًا ونصف. خلال فترة الانتظار، ماجت الأرض تحت أقدامي وفقدت وجهتي. شعرت وكأن جسدي قد تم اقتلاعه من حيث أنا، نتيجة إعادة رسم خرائط واضحة للقوى السياسية ولأنظمة الإقصاء، أدّت إلى تثبيت جسدي في المكان المحدد مسبقًا على الخريطة، هناك، حيث أنا لست فيه.
وضعت إعلانًا للبحث عن بديل: شخص يحل مكاني في لبنان لمدة عشرة أيام، يزور خلالها الأشخاص والأماكن التي شكلّت مفهوم البيت في ذهني.
اخترت آيتانا، طالبة إسبانية في مجال الرقص في أمستردام. أعطيتها دفترًا يحتوي على مئة وخمسين صفحة، كتبتُ عليها بخط يديا ذكريات وتعليمات لتعينها على كيفية العيش مكاني وتلبُّسَ مشاعري وذكرياتي، اضافة إلى قوائم بأشياء أتوقع منها أن تشتمها، أو تلمسها، أو أن تنظر إليها إلخ…
خًطًتْ آيتانا رحلتها عبر ذكرياتي الجسديًة والفكرية. رسمت خرائط حب، وفقدان، وحنين، وحزن، وذاكرة جسدية وتداخالات مرئيّة من خلال وجودها هي، كذلك نتيجة لغيابي. لم تقم بديلي، فقط، بآداء الأفعال التي يقوم بها جسدي عفوياً، بل قامت أيضًا بأداء أفعال تنتظرني أن اقوم بها و ربما لا يمكنني القوم بها او لن افعل. جعل ذلك من أيتانا بديلاً جسمانياً وجسداً مزدوجًا، بالتناوب. آيتانا ليست بصديقتي، ولا هي بشبه لي، ولا تتحدث بلغتي الأم؛ العربية.
وأنا في طور التحضير لهذه المهمة، سألت صديقي المقرّب بلال إذا كان هناك شيء يشعر برغبة في القيام به برفقتي، أثناء غيابي، لكنه يتعذر لأنني لا أكون هناك، أو بسبب انشغالي عندما أذهب إلى لبنان، حيث أكون دائمًا مع العائلة بصدد إعادة ترتيب أموري بعد قضائي فترة في الخارج. ردّ بلال قائلاً: “لطالما أردت أن أتمشى بصحبتك في الطبيعة عند الفجر؛ في مكان يساعدنا على الابتعاد عن روتيننا اليومي وما يحيط بنا، حيث يمكننا أن نكون، ليس إلا، ونتواصل بتلقائية كي نشيّد جسوراً تصل بين مسافاتنا واختلافاتنا”.
إلى أي ‘طبيعة‘ سيأخذك؟ هل تبدو الطبيعة هناك كما تعرفينها أنت مسبقاً؟
في إحدى الصباحات الباكرة، أخذ بلال آيتانا في سيارته وتوجه بها إلى تلال جزين، التي تبعد حوالي الساعة عن منزل والديّ في صيدا، جنوب لبنان.
أخذني بلال إلى منطقة صخرية فيها بقايا لبيوت قديمة، وتتناثر على أرضها الزهور الصفراء، ويظهر جرّار حفر ضخم، وبعض المباني المهجورة التي تعرضت للقصف بشكل عنيف خلال إحدى الحروب مع إسرائيل، كما وصفت بديلتي. كان قد أحضر بلال معه زجاجة من النبيذ الأحمر، من نوع “كسارة”، فاحتسياها على العشب عند العاشرة صباحًا، من فوق موقع مشرف على مدرجات من الهضاب.
بلال، كما أعرفه، لا يتواصل مع الطبيعة من منظور رومانسي غربي، نابعٌ من حنين إلى توحد مع طبيعة أضعناها في خضمّ حياتنا السريعة “الحضارية”. إنه يدرك تماماً أن مفهوم “الطبيعة” مركب و مؤدلج جداً، و لكنه قرر أن يغامر.
أتذكر كتابًا أعجب كلينا وتحدثنا عنه عدة مرات، كتاب هيرمان هيسه “سيدارثا”، الذي يقوم برحلة روحية بهدف اكتشاف الذات.
أعتقد أن بلال يرى إلى الطبيعة مكاناَ نتعلم من خلاله أن نتوقف عن البحث، ونبدأ في الاستماع والإدراك والتأمل. مكان يمكننا فيه تحقيق( siddha) ما نسعى إليه (“artha”)، من خلال تخطي المفاهيم المسبقة التي كونّاها. لأن الطبيعة هي حكيمة ومعقدة وغير منطقية إلى أبعد حدود، في آن معاً، انها تكشف حقيقة كينونتنا عندما نتأملها. تلك الحقيقة هي التغيير.
مشت آيتانا في الطبيعة مع بلال. قامت برسم اسكتشات عن هذه التجربة على دفترها.
أمشي من خلال وصفها لتلك الرحلة وذكرياتها عنها. تمكنت من خلال آخرٍ، التعرف على تضاريس لم أستكشفها من قبل، كذلك استطعت التقصّي والاستماع للتضاريس التي مشيتها من قبل بشكل أفضل.
اتبعونا!
وأنا أمشي من خلال سردها، أشعر بالعشب الأخضر الرطب يلامس ساقيّ، ويبلل سروالي بينما أوازن وركيّ بين الصخور والزهور البيضاء والصفراء الصغيرة التي تبزغ من بين الشقوق. يستيقظ جسدي ببطء بالتناغم مع وتيرة شروق الشمس خلفنا، وهي تنشر النور على كافة التفاصيل من حولنا، وتغمر كل الألوان بأشعتها. أكاد أسمع صدى البيوت وأرى الأشجار التي ترتفع فروعها كأذرع منتصرة من بين الجدران المتهالكة، تتحدى تاريخ الخسارة. أرقب عينيّ تحاول ملء ثقوب الرصاص في البيوت المتهالكة على التلال.
بينما كنت أُنَقّل بثقلي، بين لبنان وهولندا، وأنا أقتعد التربة، حاولت الاستماع إلى قصصها المخبوءة.
إن تاريخ هذين البلدين المضطرب والمعقّد بشريًّا وجيولوجيًّا هو من شكلَّ مشاهدها الطبيعية و تضاريسها التي يتردد في أنحائها، ويتلاشى، صدى تاريخ الاحتلال والاستعمار والهجرة و الجريمة، ومسارات المستعبَدين، والمنفيين، والضحايا. ليس فقط في تلك المشاهد التي تكمن في ذاكرتنا، بل أيضاً، التي تكتنفها الرمال، الطمي، والحجر، والملح والماء.
هل تختبر الطبيعة أيضًا الألم أو الحزن؟ كيف تحزن يا ترى؟
بينما أنظر إلى البيوت المثقوبة بالرصاص، اجتاح ذاكرتي مشهد الدبابات الإسرائيلية تعيث خراباً بخصوصية المعلم الطبيعي الذي يميّز مدخل جنوب لبنان؛ بساتين الحمضياّت الممتدة على طول الساحل المجاور للبحر. طاف أيضاً فوق جلدي من خلال عظامي مشهد آخر لدبابات إسرائيلية تجتاح مدرعاتها بساتين الموز، بينما يطل عبر فوهاتها جنود يطلقون النار دون توقف من رشاشاتهم الآلية، بقطر يبلغ 360 درجة. إنها لقطة من فيلم الرسوم المتحركة “فالس مع بشير”، الذي شاهدته في سينما ريالتو في أمستردام. أتذكر كيف شعر جسدي بأكمله بالتشرذم، كيف مزقت ارتعاشاتي صمت قاعة السينما، وكيف تدفقت الدموع من عيني وبقيت تتدفق لأسابيع عدة تلت. من مكان ما في ذلك المشهد، ومن عبثية العنف والتجرد في تقديمه من خلال رسوم مصورة، طافت على سطح جسدي وغمرته مؤشرات صدمة طفولتي الأولى التي تسببت بها الحرب.. هذا المشهد الخاص للجنوب، حيث نشأت، مع كل أشكال حياته وألوانه وروائحه، جعلني أستشعر الرابط القوي الذي يجمعني به. أحسست كما لو أنهم كانوا يجتاحون صلب عائلتي.
لنسلّم جدلاً بأن الأشياء التي نشأنا معها هي عائلتنا. عائلتنا غير البشرية، تراثنا. على سبيل المثال: كلُّ ما نما في الفناء بجوارك، أو ما وجدته على الشاطئ، أو في البركة وبين الأنقاض التي كانت مسرح لعب طفولتك؛ كل ما رافقك، وذلك الذي ألهمك، و ما لجئت اليه هارباً او خائفاً، وهذا الذي أمكنه أن يريحك، ويمدك بالشجاعة. ما كان يزودك حرفياً بالغذاء، أو يكشف لك عن معنى وسحر تناقضات الحياة. زهرة ما، حشرة أو صَدَفة، حجر أو عصا، بركة طين، جبل أو صوت نهر، كل هذا مجتمعًا أو على حدىً يكوّن: عائلتك.
في مشهد آخر من الفيلم، يتوقف الجنود لأخذ صورة جماعية لهم على المدرعة في صباح يوم مشمس تنعم به تلال الجنوب. ثم ينطلقون في طريقهم عبرالريف وهم يتناولون الحلوى. نسمع أغنية بوب عبرية تضج في الخلفية: “لبنان، صباح الخير. يتواصل الألم …كثير من الألم، لبنان، صباح الخير.”
يأخذ أحد الجنود بالتذكر: “كان حقًا منظرًا ريفياً نموذجياً. كنا نستمتع بالمناظر ونحن نقود ببطء. “إنك تشعر دوما بالآمان في الدبابة”، الدبابة تمشي فوق السيارات، وتسحقها، تنتهك البيئة وتحول الجمال إلى خراب. تتابع الأغنية: “لبنان، إنك تنزف حتى الموت ين ذراعي. إنك حب حياتي. حياتي القصيرة، القصيرة جداً”.
في لحظة ما، بينما تمنح الطبيعة الجنود اليافعين براءتها، فيبدون لبرهات كمن تحرر من دوره وما يمثله، يكمن الخطر في الطبيعة نفسها: في المشهد التالي يحدث تغيير مفاجئ في ميزان القوى، عندما تُطلق رصاصة من قلب المنظر الطبيعي وتصيب أحد الجنود في الرقبة.
في مشهد آخر، أيضاً، يمشي الجنود أمام الدبابة بين أشجارالبرتقال في بستان بينما ينبعث صوت موسيقى تعزف لحناً كلاسيكياً على البيانو. ضوء جميل يتراقص من خلال أوراق الشجر فينعش وجوههم المنقبضة. لكن، هنا أيضاً، يتم تشويش سكون المناظر الطبيعية: يُصوّب صبي صغير مختبئٌ بين الأشجار قاذفة صواريخ RPG-7 نحو الدبابة ويطلق النار عليها. تستمر الموسيقى الكلاسيكية بالانسياب لتتوقف عندما يطلق الجنود نيران مدافعهم ويسقط الصبي الصغير بين أشجار البرتقال على الأرض الخصبة، وحيدًا، يعوم في بركة دمه.
ما هي الصدمة النفسيّة؟ وأين مكامنها في أجسادنا؟
هل يمكن أن تتحول الصدمة إلى بقايا، شيئٌ نخلفه وراءنا؟ شيء من مخلفات أفعالنا وأجسادنا ينتقل ليعيش بشكل دائم في الأرض، في الطبيعة؟ أو أن الصدمة نوعًا من الأحافير التي يمكن أن تخبرَ شيئًا عن عصرنا الحالي في المستقبل؟ أو هل أن وجودنا ليس إلا بقايا بحد ذاته؟ بقايا من الأشخاص الذين جاؤوا قبلنا؛ من التاريخ، والعلاقات، والقصص المحكية وغير المحكية.
تبدو الحاجة إلى تصريح للإقامة في أي مكان فوق هذه الأرض، غير منطقية بالخالص.
أسير نحو الثقوب في الجدران مرة أخرى، وأشعة الشمس الصباحية تتسلل من خلالها. أمرر يدي على جلد الحائط، وتنقلني ذاكرتي إلى ورشة عمل للرقص العلاجي كنت قد شاركت فيها في أمستردام.
في الورشة، كان على كل مشاركة أن ترسم جسدها على ورقة بيضاء حجم A4 . رحت أجري برأس قلمي على الورقة، وأنا أرسم بخفة خطوط لهيكل جسد بذراعين مفتوحتين على وسعها؛ امتدت خطوط الساقين والأذرع والبطن إلى حواف الورقة، إلى الخلف، وما وراء ذلك. كان بطني على جانب وكان ظهري على الجانب الآخر. ثم ثقبت ثقوبًا بطرف القلم ذات أحجام مختلفة في جسمي الورقي.
“هل يمكنك أن تخبرينا شيئًا عن رسمك، عن جسدك؟” سألتني الإخصائية المشرفة على الورشة. حاولت أن تطرح السؤال بما أوتي لها من حياد، ولكنني شعرت بأنها كانت تختطف أنفاسها بينما كانت تنظر إلى الرسم.
“أحب أن أفكر في جسدي على أنه مسامّيّ، جسد يتوق ليكون لا شكل له أو أن يكون قادرًا على تجاوز حدوده وأشكاله”، قلت برفق لكل العيون والآذان المرتبكة التي تحيط بي.
أوليست حدود أجسادنا ضرورية لحفظ حريتنا وفردانيتنا؟
“وهل إصلاح تلك الفجوات هي وسيلة للشفاء؟”، سألت الأخصائية.
لكنني لم أرسم جروحي، بل مسامات لجسمي. أُفضّل يوتوبيا التعددية على يوتوبيا الفردية.
المشي في الطبيعة: مغناة للصداقة، للغياب، للحضور، للتغيير، وللأجساد المكتنزة بالعلامات، والمناظر، والتواريخ التي تتكشف شيئًا فشيئ.
المشي بحذاء شخص آخر: قصيدة غنائية للحزن، للبعد، للقرب، لآدائية الهوية، للتعدد، وللأماكن التي نحن منها ولسنا فيها.