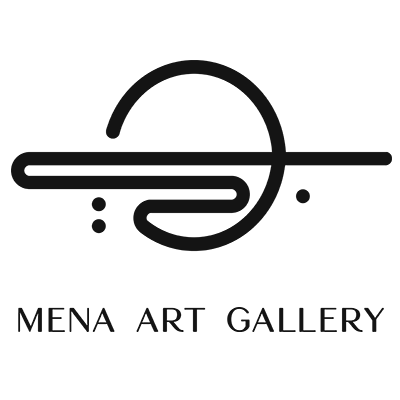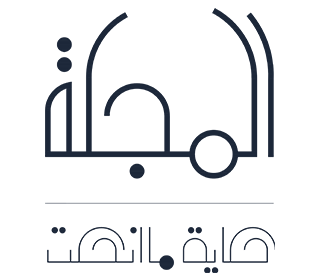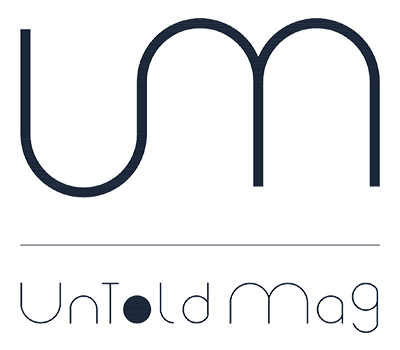لطالما كان هنالك رغبة متأصلة في داخلي لحياة التنقل. لا أعرف ما إذا كانت الحاجة الملحة إلى العزلة أو الرغبة الشديدة في سبر أعماق الذات وراء الأسباب في شوقي الدائم للترحل سيراً على الأقدام.
بدأت رحلتي الأخيرة في المرتفعات الإسكتلندية، عندما سلكت طريقًا غير محدد من المحيط الأطلسي باتجاه بحر الشمال.
قمت بلمس مياه خليج Mallaig أملاً في إنهاء رحلتي عند المياه مرة أخرى. أعطاني ذلك إحساسًا غريباً، كما لو أني كنت أحاول الانتقال من حالة إلى أخرى أو ربما نقل ماضي الشخصي من حالة النسيان إلى حالة مختلفة من التذكر.
بدأ صدى الأفكار والتساؤلات يتردد بكل خطوة خطوتها. ومع تشابك حركة جسدي بشكل أعمق وأعمق في التضاريس المتموجة، بدأت ذكريات الماضي تتداعى بدون هوادة مرددة في رأسي مقولة لا أذكر أين قرأتها «الذاكرة يسكنها الموت»، فاتحة الطريق بدورها لمقولة أخرى من رواية “البطء” لميلان كونديرا: “هناك رابط سري بين البطء والذاكرة، بين السرعة والنسيان“.
ماشياً، وجدت نفسي أُبطئ من حركتي قليلاً متأملاً العلاقة الغير قابلة للفصل بين الموت والذاكرة ومحاولاً فهم التشابك في الثنائيات، فكل واحدة منها معتمدة على الأخرى في المعنى. فعلى سبيل المثال، إن الفهم البشري للنسيان يتم استيعابه عبر عملية التذكر، مثلما أن فهمنا للحياة مؤطر بالموت.
وبينما كنت أفكر في مقولة كونديرا، وإذا بي أتناوب بين الإسراع في خطواتي تارة و التباطئ بها تارة أخرى. هل يمكن لإيقاع المشي أن يكشف سر التذكر والنسيان؟ ولماذا تبدو بعض ذكريات الماضي كأنها حيوات سابقة سبق عيشها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فربما كل واحد منا قد مر بعدد لا يحصى من الوفيات والولادات المتكررة.
ما كانت اجاباتي لتلك الاسئلة إلا عبارة عن تدفق كبير من الذكريات الممزوجة بتفاعل لاشعوري متنقلاً بين الإسراع، ثم التباطؤ، ثم التسارع مرة أخرى.
تباطؤ …
في حي جبلي صغير على قاسيون دمشق، كانت ولادتي الأولى، تلك الحياة كانت الأطول، استمرت 28 عامًا. ذكرياتي عن حياتي الأولى ماهي إلا ومضات مبعثرة، أتذكر جسدي الصغير واثباً تحت صنوبرة بدت لي في حينها شاهقة. وقفت تلك الشجرة الصفراء وحيدة في الحي المنعزل، مطلة على تلك البيوت المتواضعة كضيفة غريبة بينهم حطت رحالها مجبرة. كان المارة يقدمون تحياتهم الصامتة لجذعها، يتحسسون لحائها ويتساءلون عن سر ازدهارها الدائم في حي قد غلبت عليه العشوائيات الفقيرة.
في ذلك المكان، استودعت أسراري، مثل قصة دموعي التي ذرفتها سرا خلال حصة التربية القومية، عندما علمت أن سوريا دولة من دول “العالم الثالث“.
بجانبها، كشف لي ماهر لأول مرة سر العلاقات الحميمة وأطلعني لاحقاً عن تعقيدات سياسة الهوية، وكيف أن الاختلاف بالانتماء بين الكرد والعرب وبين السنة والشيعة قد يكون مشكلة.
هنالك همس عمي عن الحياة في ظل الديكتاتورية، وهنالك كرر والدي، بحذر في صوته، ترنيمة مألوفة للكثيرين: “الجدران لها آذان، لا تنس أن تختار كلماتك بعناية“.
لم تكن حياتي الأولى طويلة كما توقعها محيطي الاجتماعي، فقد مت في سن مبكرة تماماً مثل تلك الصنوبرة التي قُطعت تعسفاً على يد النظام السوري فقط لأنها قد ارتدت راية المتظاهرين الذين أعلنوا بكل حماس ثورتهم ورغبتهم في الحرية والتغيير.
تسارع …
في حلب، بقيت على الحياة ليوم واحد فقط.
أي يوم من أيام الثورة السورية هناك، قد يلخص حياة بأكملها. لحظات قليلة قبل أو بعد قصف، او انفجار، هي العامل المحدد بين الموت أو الحصول على حياة جديدة. البقاء على قيد الحياة كان ترفاً صعب المنال، وكانت التقلبات الصارخة تتجلى في كل تفصيل يومي صغير، حتى ضوء النهار كان ينكسر فجأة بظلام مفاجئ. كان الوقت في حلب كرحلةٍ جامحة، تقطعت بلا هوادة بين القسوة والتناقضات.
جئت إلى تلك الحياة من نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف جثتي، بجانب شجرة صنوبر محترقة، كانت ضحية أحد الغارات الجوية المدمرة التي نفذتها قوات الأسد الجوية. بجانبي كان يرقد جسم طفل لجأ إلى نفس الشجرة أثناء لعبه
الغميضة. واصلت أخته العد للأيام الثلاثة التالية، متمسكة بالأمل في أن يظهر شقيقها مرة أخرى ويكف عن الاختباء.
تباطؤ …
بعيداً عن أي أرض وأي شجر، في غماض المياه العميقة التي لا تنتمي لأي أمة، حيث تُغرق أمواج البحر المدوية كل الأصوات الأخرى، وُلِدَنا جميعاً معاً في صمت مهيب. في لحظة القرار الذي تم اتخاذه بالقفز على متن القارب، اختفت أسماؤنا في الماء وأعطى البحر كل منا ذات الاسم وذات الهوية “نفر“*. رغم أن الهمهمة كانت كل ما لدينا كمحاولة لكسر الظلام وبث بعض من الطمأنينة، كان لصوت تكسر الموج على جانب القارب الصغير وقعاً قوياً مخيفاً كما ل أن البحر لم يكن لديه آذان صاغية لتذمرنا.
كتفًا بكتف، جلست الأغلبية على أرضية قارب الصيد، لكن القلة المحظوظة مثلي، التي تمكنت من القفز على القارب أولا كانت تنعم بالجلوس على الحافة. في تلك اللحظة، بدا القارب كعالم مصغر يحتفل بالألوان والمعتقدات والخلفيات المتنوعة، مشتاقاً الى ملامسة الطرف الآخر من البر لبدء فصل جديد في مدينة فاضلة. كنت أنظر بدوري من حافتي إلى تلك المساحة المليئة بالأجسام في الوسط كما لو أن اكتظاظها كان شكلاً متظاهراً قد عرى شعار العدالة الاجتماعية.
سرعان ما تبين لي لاحقاً أن امتيازي بالجلوس على الحافة كان وهمياً، ذابت قدماي تحت ثقل الأجسام الخائفة الأخرى. كل محاولة لتحريرهم أثبتت عدم جدواها، وكأنهم قد تحولوا إلى كتل أسمنتية خدرة ترفض أدنى تحرك. كنت نصف جسد قد نابه إحساس غامض بالخلاص أو بالاقتراب الشديد من الموت.
تلك الحياة كانت قصيرة للغاية، استمرت لمدة ثلاث ساعات فقط.
كنا خمسة عشرة شخص على متن قارب صيد يتسع لأربعة أشخاص في أحسن الأحوال، نجا الجميع باستثنائي، كنت الوحيد الذي فشل بالوصول إلى الجانب الأخر. عندما توقف المحرك عن العمل فجأة، قفز الجميع في مياه شهر كانون الأول قبل أن ينقلب القارب. وجدت نفسي وحيداً ألهث من أجل الهواء، كنت اختنق في صمت غريب تتخلله صرخات الآخرين. بينما كنت أغرق ببطء، كان آخر ما سمعته مزيجاً من أصوات تلعن الله والإنسانية، وأصوات أخرى تتلو آيات من القرآن.

تباطؤ أقرب للتوقف …
عند غروب شمس يومي في المرتفعات الإسكتلندية، بدأتُ أتجاهل تسلل بعض علامات التعب الجسدي. لم يمنعني ذلك من صعود تل موحل، الذي قادني بدوره إلى شجرة صنوبر منعزلة. بدت الشجرة النحيلة والمنحنية برشاقة، في مكان غير مناسب وسط مشهد يهيمن عليه أشجار البلوط القوية. على مر السنين، نحتت الرياح شكلها بأناقة فريدة، شاهدة على تحملها وقوفها وحيدة. عزلتها أثارت إحساسًا بالألفة، مذكرة بولادتي الأخيرة، فقد وُلِدتُ مُنفىً وغريبًا في مكان كهذا الصنوبر.
أثناء مشيَ، مر شريط حيواتي السابقة، لم تكن أي منها واضحةً ومختصرةً في الوقت مثل حياتي الأخيرة التي مُنحت لي، عندما قدمت لي موظفة البلدية جواز سفري مُعلِنةً رسميًا أنني أصبحت مواطنًا هولنديًا. كانت كلماتها بعيدة عن صفتها الرسمية، حيث قالت: “أتمنى أن تنسى كل الموت الذي ألمَّ بوطنك، مُباركًا لك ولادتك من جديد“.
لكن ماذا لو أردتُ أن أتذكر؟ وهل هناك طريقة أُخرى للتذكر؟ أو ما الذي يكمن بين التذكر والنسيان؟ أو حتى بين السرعة والبطء؟
بين التذكر والنسيان رُبما تمتد مساحة معقدة من اللحظية. إنها مكان تضمحل فيه الذكريات لكنها تبقى تتردد، مكان تثير فيه شظايا الماضي العواطف دون تذكر كامل للأسباب. إنها مزيج حلو ومر من الحنين والانتماء، وفي الوقت نفسه، خليط من النزوح والاغتراب. إنها مساحة يصارع العقل مع ما يحتفظ به ومع ما يتلاشى، في هذه المكان لا تحدث الحركات بسرعة جارفة ولا ببطء شديد. إنها النقطة التي تتسكنُ فيها إيقاعات الزمن اليومي، مقدمةً إحساسًا متناقضاً بالخدر والحساسية. بين التذكر والنسيان يعيش جسد في المنفى.
بجانب جذع تلك الصنوبرة الوحيدة، قررت أن أبطئ خطواتي واتأمل. شعرتُ أننا طيفان يحومان ما بين حياة في الماضي وأخرى في الحاضر. ممزقين بين الإمساك بما تبقى من الذاكرة أو ربما تركها لتتلاشى في النسيان.
بجوار الصنوبرة، اعترفت بحملي لعقدة النجاة من كل تلك الوفيات السابقة، وأظهرت للشجرة كيف يحمل جسدي هوية مختلفة عن هوية ذاكرتي. هوية حصلت على امتياز التجوال بحرية دون قيود، وأخرى تعيش في حالة من الحداد الدائم حزناً على هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون تجاوز الحدود السياسية. تنعى تلك الهوية الأماكن التي مازالت تتحمل الظلم والقهر اليومي، مواجهة ًفقداناً مستمراً، بينما تظل الإنسانية على الجانب تقف كمراقب صامت ومؤيد للمشهد.
وكأني شعرتُ أن الشجرة قد استشعرت أفكاري الغير معلنة، كما لو أنها كانت تستجيب هامسةً بقصص لا تُنسى حول “تطهير المرتفعات الاسكتلندية“*، وكأن وجودها الصامت مازال يحمل صدى الآلاف من الأسر والقبائل الذين تم تهجيرهم بالقوة من منازلهم و أراضي أجدادهم.
في تلك اللحظة فقط، كان الشيء الوحيد الذي أردته هو الاستمرار بالتذكر والمشي بشكل أبطأ وأبطأ وأبطأ.
– نفر*: لغوياً، تُستخدم للدلالة على عدد معين من ثلاثة إلى عشرة أشخاص.
في سياق النص كلمة نفر شائعة الاستخدام بين المهربين وتجار البشر، دلالة على شخص يريد الهروب عبر الحدود السياسية.
– “تطهير المرتفعات الاسكتلندية“* بدء الإخلاء القسري لسكان المرتفعات والجزر الغربية في اسكتلندا، من منتصف إلى أواخر القرن الثامن عشر واستمر متقطعًا في منتصف القرن التاسع عشر. وقد أدت عمليات الإزالة إلى تطهير الأرض من الناس والعشائر في المقام الأول للسماح بإدخال وسائل رعي تدر أرباح أكثر. أدت عمليات تطهير المرتفعات إلى تدمير مجتمع العشائر التقليدي وبدأت نمطًا من التهجير الريفي والهجرة من اسكتلندا، بقيت نتائج الإخلاء منعكسة على المجتمع الإسكتلندي لهذا اليوم.