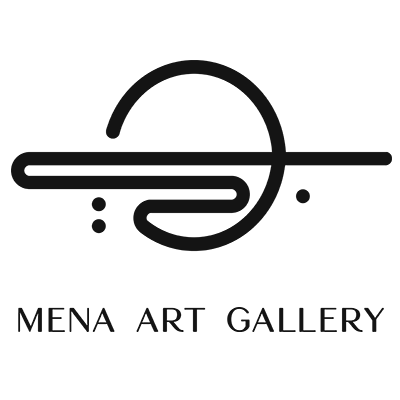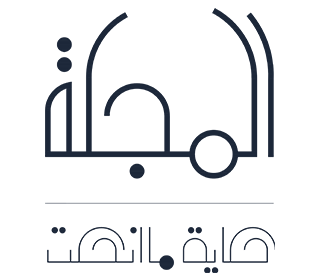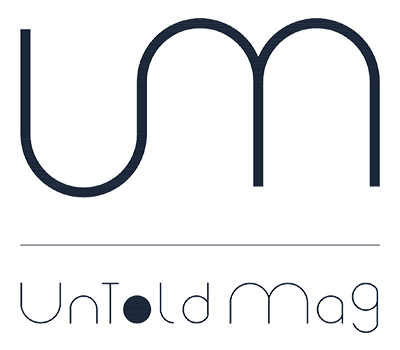فيما يلي حوار خيالي، يروي من خلاله صوت إناس آيت عبد السلام معاناة تُجسد واقعًا يعيشه العديد من أفراد مجتمع الميم-عين في الجزائر. هذا الحوار ليس مستندًا إلى شخص حقيقي، ولكنه يُستمد من تجارب واقعية لمجتمعات تعيش على هامش الاعتراف، وتعاني في صمت.
بملامح باردة لا تروي أبدًا فظاعة ما تمر به، أجابت إناس آيت عبد السلام عندما سألتها: “كيف حالكِ؟”
“بخير … لمن لا يهمه الأمر ولا يعترف بوجودي”، ثم أضافت، بعد لحظة صمت، “وللبقية، أريد أن أقول إنه منذ تلك الليلة التي ذاقت فيها روحي مرارة الموت، تسيطر على عقلي تساؤلات متواصلة حول حقي في الحداد. هل يحق للمجتمع أن يحرمني من الشعور بالحزن والمشاركة في طقوس الجنازة؟ هل من العدل أن أُجبر على كتم صرخات ألمي العميق؟ هل يُعقل أنني مضطرة لقبول قرارات أشخاص لم تكن شريكتي تحبهم وهي على قيد الحياة؟ وهل سيراعي أحد أمنياتها الأخيرة بعد وفاتها؟
كيف أخبرها الآن أنني لم أتمكن من إجبار أي شخص على احترام خياراتها، وأنني لم أستطع أن أنطق بكلمة واحدة؟ كيف أستمر رغم مشاعر القهر والإقصاء؟ وكيف لي أن أتعامل مع الصراع الذي يمزقني بين تقبل الواقع المفروض وحقي في التعبير عن حجم استغاثتي، وقهري بسبب عجزي عن تغيير الوضع ومنعي من عيش الفاجعة بطريقة إنسانية.”
العيش بوجهين
حياة المثليين/ات والعابرين/ات في الجزائر معقدة وصعبة بسبب التجريم القانوني، والقيم التقليدية، والمعايير الاجتماعية الصارمة، مما يدفعهم/ن إلى تبني حياة مزدوجة بين الظاهر والباطن.
في محيطي المقرب، تتعدّد قصص الأشخاص اللامعياريين/ات. ففي الحيّز الخاص، يعيش المثليون/ت والعابرون/ات علاقات حب وصداقة بسرية تامة، بعيدًا عن الأنظار، نتيجة الخوف الدائم من اكتشاف هويتهم/ن، مما قد يؤدي إلى نبذهم/ن اجتماعيًا أو ملاحقتهم قانونيًا.
لكن في الحياة العامة، يضطر أفراد مجتمع الميم-عين إلى تمثيل أدوار اجتماعية تتماشى مع التوقعات العامة، مثل الدخول في علاقات مغايرة الجنس والزواج لتجنب الشكوك. فيتعين عليهم/ن تبني قيم وممارسات المجتمع التقليدية لضمان عدم اكتشاف هويتهم/ن الحقيقية. في الحياة المهنية والاجتماعية، يتجنبون الحديث عن حياتهم/ن الخاصة للحفاظ على حياة طبيعية ومستقرة.
تؤدي هذه الحياة المزدوجة إلى العديد من العواقب والتحديات، من بينها ضغوط نفسية شديدة قد تنتهي بالاكتئاب والانهيار العصبي. وتؤثر السرية والخوف على علاقاتهم/ن الشخصية، مما يزيد من عزلتهم/ن الاجتماعية.
للكشف عن جزء من تلك العتمة، أجريت هذا الحوار الخيالي، مع إناس آيت عبد السلام، وهي شابة جزائرية مثلية متخيلة، تعيش على دقات قلق تتملّكها وتسيطر عليها، وسط مجتمع لا يعترف إطلاقًا بوجودها.
أعلم أن الحضور كان مؤلمًا، لكن هل استطعتِ تحمل تلك اللحظة؟ هل تمكنتِ من حضور الجنازة؟
نعم، كان ذلك صعبا جدّا، كان عليّ أن أٌحضِّر نفسي وأخرج، وأُعزِّي عائلتها الرسمية. كان عليّ أن أنسى بين ليلة وضحاها أنها كانت تنام بجانبي منذ أشهر. لم يكن لي الحق أن أشرح أن أشباح الموت تلاحقني في وحدتي، تحت سقف المنزل الذي جمعنا، حيث لا يزال صدى صوتها يدوي. بينما كنت مجبرة على تأمل خصلات شعرها العالقة بالوسادة طوال الليل، كانت عائلتها الرسمية تتلقى المواساة والتعازي.
صمتت للحظة، وكأنها تستعيد تلك اللحظات المؤلمة، ثم قالت: تردّدت كثيرًا، لكنني لم أتمالك نفسي حين علمت أن نعشها متجه إلى بيت عائلتها ليلقوا عليها نظرة أخيرة قبل الدفن. ركضت رغم الأحاسيس المتناقضة، لأنني شعرت أنها فرصتي الأخيرة لأودعها. لم أفكر فيما يجب قوله كي أفرض نفسي بين الأقرباء، وأسرق بضع ثوان أخيرة معها … كرهت العالم في تلك اللحظات، ماتت معي ولكنها تُدفن معهم.
وهل أُتيح لكِ وداعها كما أردتِ؟ هل استطعتِ أن تلقي نظرة أخيرة على وجهها؟
نعم، أظن أن هناك من دفعني إلى الأمام، وسط المقربين. لم أستطع النظر إلى وجهها في البداية وفضلت الهروب. كنت خائفة من برودة الموت التي أحسست به أمام نعشها، ومرعوبة من أحكام وعتاب ذويها.
استسلمت للبكاء خارج البيت، ولم أنتبه حتى استَعدّ البعض لنقل النعش إلى المقبرة. كانت نفسيتي تنهار تارة وتصحو تارة أخرى، خائفة من أن يكون أحد الحضور يراقبني. هل اكتشف أحد الحقيقة؟ في اللحظات التي كانت مرارة الموت تطغى على مشاعري، كنت أود إخبار الجميع بالحقيقة، غير مكترثة بعقليات وسلطة مجتمع جعلنا نعيش ونموت في الخفاء … ولكن الخوف والقهر تحكّما في صمتي.
خاطبني والدها في تلك اللّحظات الأخيرة وكأنّه أحّس بإرادتها. سألني إن كنت أريد رؤيتها قبل أن ترحل المركبة، لم أتمالك نفسي وتوجهت نحو النعش بعد انصراف الجميع. بين بضعة رجال كُلِّفوا بحمله ومرافقته، كتمت أنفاسي ودموعي، كشفت عن وجهها وقبلت جبينها، ثم هربت بعيدًا.
أتساءل… هل كان والدها يعرف شيئًا عن علاقتكما؟
لا أدري، ولكنني فهمت منذ فترة أن العائلات تشك تدريجيًا في توجهات الأبناء. البعض يرفض، البعض يحارب… منهم من يتجاهل، ومنهم من يقمع حتى الاستسلام، ما يجمع بين كل العائلات هو الصمت القاتل ورفض المواجهة الصريحة.
صدمتني التفاتة والدها، لكنني لم أتردّد في استغلال الفرصة.
في عاداتنا، الرجال يرافقون النعش إلى المقبرة للدّفن، بينما تبقى النساء في البيت للتكفل بباقي مراسيم الجنازة. رغم رفضي لهذه الأدوار المعيارية، وضعيتي في ذلك اليوم جعلتني غير معنية بكل ذلك.
البيت الذي جمعنا، والذي قضت فيه آخر أيامها، لم يحتوي جنازتها، والمقبرة ليست متاحة للنساء عند الدفن. رغم ذلك، قمت بما اعتقدته بديهيًا، تبعت المركبة وتأملت من بعيد دفنها بقلق، وكأنني مدركة أن تلك اللحظات هي التي ستنقذني من بشاعة الإحساس بالانتماء للعدم.
كنت شاردة الذهن، منهارة تمامًا، ورغم ذلك سألني الكثير عن حال ذويها والمقربين. كنت في تلك اللحظة نكرة ، كان عليّ أن أُسأل وأجيب عن حال الغير وطمأنة البعض ومواساة الآخرين. كان عليّ أن أنتبه للجميع وأنسى أن حالي قد يكون الأسوء… أمر عادي، ألست منبوذة من مجتمع يستغفر ويدعي عليّ إذا علم بوجودي، ويحاربني إذا أردت فرض ذاتي…؟
بعد كل هذا، كيف كانت عودتكِ للمنزل؟
شعرت بالوحدة وبمرارة رهيبة، لا أعلم لماذا ولكني لم أرتح لحضور بعض معارفي. أغلبهم لم يكونوا من مجتمعنا المنبوذ. مجتمع العلاقات المحرّمة والممنوعة، مجتمع الميم -عين. عائلتي كانت مغيّبة تمامَا.. تساءلت بشدّة يومها، أيعقل ألا يأتي أحد من عائلتي لمواساتي، لتجنب انكساري في هذه الظروف الصعبة، وتكريم ذاكرة شريكتي في الحياة؟ هل كل هذه الوحدة فقط لأنني مختلفة؟ هل سيسامحني أحدهم إذا عزفت عن تعزيته/ا إن فقد/ت زوجًا/ة أو إبنًا/ة ؟ لماذا تُعد تلبية احتياجاتي في هذه اللحظات مستحيلة؟ حتى عندما حاولت الاتصال ببعض الأصدقاء، لأخبرهم أنني لست بخير، تلقيت إجابات متشابهة، جميعها تتجاهل حالتي. أخبروني أن في الحياة ما يذكرني بأن ما أعيشه أهون بكثير مما يعيشه من يفقد قريبًا أو فردًا من العائلة.
حتى أن بعض أصدقائنا المقربين، الذين كانوا على علم بعلاقتنا، فضلوا تقديم التعزية لعائلتها التي لم يروها يومًا، على الوقوف بجانبي والاهتمام بمخاوفي التي تشاركتها مع حبيبتي لفترة طويلة.
لم أشعر يومًا بالبرد كما شعرت به ذلك اليوم، رغم دفء الطقس. حاولت أن أكرّم ذكراها لكنني أخفقت. لم أستطع تحمل استهتار البعض بمشاعري. لم أتحمل خطابات التحليل تثقيف وعقلنة المشاعر.فوجئت يومها بقيام بعض الأصدقاء بزيارتي، ثم التحدّث عمّا أمر به من جانب علمي ونظري دون الاكتراث لمشاعري وحالتي النفسية في تلك الليلة. تصرّفات لم تصادفني يومًا في جنازة أخرى.
واجهتني، في خضم مرارة قهر موت شريكتي، أحاسيس متناطحة … غضب، ويأس، وضعف، وخوف مرعب. يومها، أحسست أنني لم أعد أتحمّل، وفضلت الانفراد في غرفتنا، أقصد غرفتي المخيفة. لم أنم تلك الليلة. بفارغ الصبر، انتظرت الصباح لزيارة قبر حبيبتي. كان صباح يوم دفنها. عند وصولي للمقبرة، تسارعت خطواتي نحو مثواها الأخير. لم أفهم معنى الحياة والموت في تلك اللحظات. تذكرت معتقداتها واختياراتها التي كنت سأفرضها في جنازتها لو كنت زوجها أو ذلك الشخص الذي يعترف به المجتمع ويحترمه.
أمام قبرها الهادئ، كنت أكرر أنني آسفة. لم أكن قادرة على فعل أفضل من ذلك، لأنني لا أحد. اختلطت مرارة الحزن ببرودة الخوف، وكنتُ أغرق في شتى الأفكار، حتى وصلتُ إلى لحظةٍ ألمت بي بطعنة أخرى في قلبي الذي لم يعد يتحمل. قال لي أحدهم بصوت خافت ابتعدي، يجب ترك المساحة للعائلة.
حين قيلت لي هذه العبارة، أدركت وصول ذويها المعترف بهم. كانت العبارة قاسية، رغم أنني استقبلتها بابتسامة كاذبة عندما اضطررتُ للانصراف. بالفعل، العائلة، الأقرباء، هم أصحاب الحقوق في تلك اللحظات… أما أنا، فلا أحد يعيرني اهتمامًا، لأنني لا أحد. علاقتنا لم تعد تحديًا منذ ذلك اليوم، لقد أصبحتْ وهمًا، وأصبحتُ بين ليلة وضحاها غريبة عنها، غريبة مجبرة على الصمت، صمت لا تختلف مرارته عن مرارة الموت. حتى حقوق الحزن والتعازي لم تُمَنَح لي، فقد كُتب لي ولها عندما اجتمعنا أن نظل في ظلام النسيان.
منذ ذلك اليوم، أخرج يوميًا لأمشي في شوارع العاصمة بحثًا عن الإرهاق … بحثًا عن الغفيان. أردت أن أنسى حزني وشوقي، ما سُلِّط عليّ وما حرِمت منه… في لحظات تغمرني فيها قوة الأحاسيس المتناقضة، تتسارع خطواتي كما تسارعتُ نحو قبرها ذلك اليوم، وكأنني أهرب من أشباح تلاحقني لا أرتاح لها إلا إذا داعبت وجهي نسمات الرياح. لا أعلم لماذا يُشعرني الريح بالحرية … الحرية أو ذلك الوهم في الحياة، لا يمكن للإحساس بالحرية إلا أن يكون شظايا من ذكريات طفولتنا المليئة بالأحلام. ولا يمكن للإحساس بالأمل إلا أن يستمر عندما تقتلنا الأوهام.
عشت رغمًا عني أشهر الفراق الأولى في وحدة مطلقة.
هل تعتقدين أن التجاهل هذا قد يشمل حتى الشركاء في العلاقات المغايرة خارج إطار الزواج؟
ربما، لا أعلم، ولا أريد أن أعلم. نحن لا نختار أن نكون معًا خارج إطار الزواج. الزواج متاح فقط للمغايرين/ات. نحن مجبرات/ون على العلاقات السرية والحياة بهويات مزدوجة. علاقاتنا مجرّمة في القانون رغم أن الحب بين بالغين لا يعتدي على سلامة الغير والمجتمع. في الحقيقة، لا أريد التفكير أو الاجابة عما يخص المغايرين/ات حتى في هشاشتهن/م.
هشاشتهن/م غير مرتبطة بوجودي، لكن العكس صحيح.
والآن، ما الذي تفكرين فيه؟ هل ستواصلين على هذا النحو؟ أو ربما تفكرين في الهجرة إلى بلاد تعترف بحقوق مجتمع الميم عين؟
لا، بعد ما مررت به، أظن أنه قد فاتني الأوان للتفكير في حياة أخرى. ما الجدوى من ذلك وقد أصبحت غير قادرة تمامًا على إعادة تجربة الحياة العاطفية.
اليوم، أنا مجرد امرأة تطالب بحقها في الحداد، دون تلقي مواعظ من أشخاص لا يمكنهم الإحساس بما أمر به. فأنا نتيجة تجارب ومعضلات لم يعيشوها. سأقاوم لأعيش وحدتي بسلام ولأفرض صمت من لا تعنيهم معاناة المجتمعات المنبوذة. ليس لديهم الحق في ادعاء فهمي أو معرفة ما يليق بي أكثر مني.
لا أريد أن يتفنن الآخرون في وصف وتبرير ما نعيشه كمجتمع غير معترف به، لأنني كنت أقل من لا شيء في أصعب الأوقات، في تلك اللحظات التي كنت فيها منهارة تمامًا، لم يستطع أصحاب الامتيازات مواساتي.. شريكتي العاطفية توفيت، والأفظع أنها أنهت حياتها بعد 20 عامًا من المقاومة ضد المرض النفسي. لم تنصحني طبيبتها كما نصحت عائلتها، لأنها اعتبرتني لا أحد. رغم علمها بعيشنا معًا، لم تعتبرني معنية بصحتها وبمتابعتها. لم تعاملني كما تعامل عائلتها.
لم أكن أمتلك المكانة القانونية التي تخولني إدخالها إلى المصحة النفسية عندما تدهورت حالتها، لأن القانون، رغم كل ما كنا نعيشه ونتقاسمه كشريكتين في الحياة، لا يعترف بعلاقتنا ويُجرمها. كانت شريكتي تذبل، وكان علينا فقط المقاومة لحماية العلاقة وحمايتها من تشديد وصاية والدها الصحية تلك الوصاية التي تحولت إلى استبداد أجبرنا، وأجبرني على وجه الخصوص، على الإخفاق. لقد أخفقت لأنني كنت أضعف من أي شريك/ة يحق له أن يخفق. أخفقت لأنني تناسيت من أكون. تجاهلت أنني عندما أظهر بدون قناع إرضاء المجتمع: لست سوى لا أحد.
هذه التجربة المؤلمة فتحت عيني على جانب آخر من التمييز ضد مجتمع الميم. في الأشهر الأخيرة، كنت المسؤولة عن كل شيء نظرًا لحالة شريكتي الصحية والمالية، كانت أسرتها بالطبع متورطة بطريقة ما، ولكن كانت شريكتي تصر على إخفاء أفكارها الباطنية خوفًا من خسارة بعض الحريات التي انتزعتها بصعوبة كبيرة. كنت أقاتل وحدي، ولكني، فشلت. لم أتمكن من إنقاذها.
حقا أنا مخفقة، ولكنني لست مذنبة؛ أخفقت لأنني واجهت حدود هويتي الجنسية. ربما كنت أعني لها ولعلاقتنا شيئًا مهمًا، ولكنني كنت أيضًا لا شيء، لا أحد.