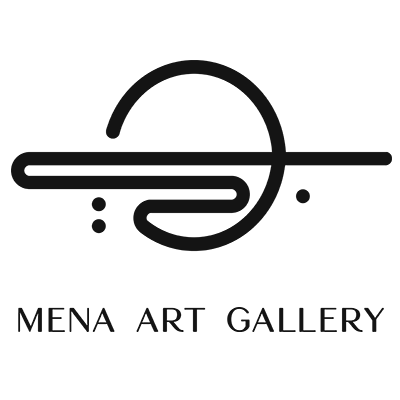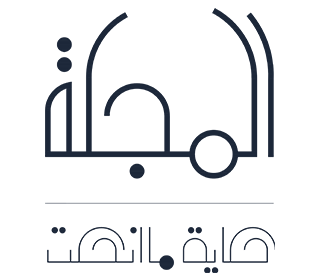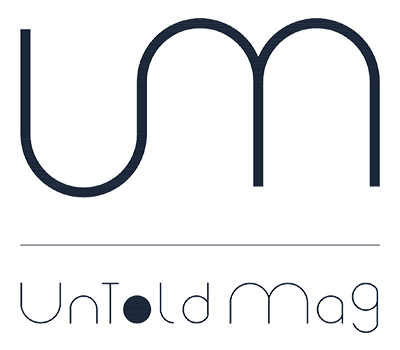ما الذي يحدث لنا؟ ما الذي يحدث في هذا العالم؟ كيف يمكن للمرء أن يشهد كلّ هذا في حياة واحدة؟
أنا في النصف الأول من ثلاثينيات العمر، وأحسب نفسي تسعينياً أحياناً. كيف لي ولأبناء وبنات جيلي، أقصد أولئك الذين ولدوا بين سنتي ١٩٨٠ و١٩٩٤ في دول بلاد الشام والعراق، أن يستوعبوا كلّ هذا؟
ولدنا بين حربي الخليج الأولى والثانية، في لبنان حرب أهليّة. تفكّك الاتحاد السوفيتي ونحن نولد أو ونحن نلعب بالطين في شوارعنا الفقيرة. رأينا حروب يوغسلافيا في نشرات الأخبار، وهتفنا مجبرين لحافظ الأسد في مسيرات تأييدية ونحن ما نزال نتعرف على شوارع أحيائنا. بعد قليل انتفضت فلسطين مرة ثانية في وجه الاحتلال وصار أطفال الحجارة رموزًا لنا. في سنوات مراهقتنا الأولى ضُرب برجا التجارة العالميّة في نيويورك فاحتلت أمريكا أفغانستان، ومن ثمّ غزت العراق. كانت الحرب جزءاً يومياً من حياتنا اليومية. لم نستفق من هذه الحرب الأخيرة حتى انسحب الجيش السوري من احتلاله للبنان وبدأ سلسلة الاغتيالات، ثمّ جاءت حرب إسرائيل وحزب الله، واحتل هذا الحزب الفضاء العام، وتدفق لاجئون لبنانيون إلى سوريا. كانت الحرب الأهلية مستعرة في العراق والعراقيون يهربون منها أينما استطاعوا ولا سيما إلى الأردن وسوريا. لم يمض وقت قليل حتى هاجمت اسرائيل غزة مرة أخرى وبدأت حصارها الذي لم ينتهي بعد.
انتهت العشرية الأولى من الألفية الجديدة بخروج ثورة في تونس وتلتها مصر فليبيا فاليمن والبحرين وسوريا. صار لدينا حلم ونحن في سنوات شبابنا الأولى. خرجت ثورات تنادي بالحرية والكرامة والعدالة، فخرج علينا جنود الدكتاتوريّة وارتكبوا مجازر أكثر من أن يستطيع الإنسان تذكرها كلّها، كلّ يوم مجزرة جديدة في مكان جديد، قُتل مئات الآلاف وسجن مئات الآلاف وهُجر الملايين. لم يترك السوريون مكانًا في العالم لم يلجؤوا إليه. قُسمت سوريا إلى ثلاثة دول واحتلتها خمسة جيوش وعشرات الميليشيات، انهار لبنان أكثر من انهياره السابق، انهار العراق، واليوم تقع غزة تحت ضربات إسرائيل التي لا ترحم.
كلّ هذا بمعزل عن الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وحرائق وجفاف وتلوث بيئي. كلّ هذا ولم نذكر خراب المدن جراء القصف بالطائرات والصواريخ. شوارع وأحياء كاملة اختفت عن وجه الأرض، لم يعد لها وجود وكأنّها لم تكن.
فقدنا أصدقاءً وأهلاً وأحباباً قتلاً تحت التعذيب. فقدنا أصدقاءً وأهلاً وأحباباً في المعتقلات. تفرقت عائلاتنا في بقاع الأرض المختلفة. خسرنا المدن التي نحبها. خسرنا ذكرياتنا. خسرنا أصواتاً وروائحَ نحبها. صرنا معلّقين بين ذاكرة ثقيلة وواقع صعب لا نفهمه. صرنا نعيش على أطراف الحياة، لا نحن جزء منها ولا نحن قادرين على اتخاذ قرارات مصيرية فيها. نفكر في تغيير العالم دائماً ولا نستطيع تغيير أي شيء في حيواتنا الشخصية. نبحث في دائرة لا منتهية عن أمان اقتصادي وأمان في الأوراق الثبوتية في أي مكان في العالم دون أن نقدر على تحقيق أدنى مقومات الحياة. نحاول التركيز على خلاصنا الفردي لكنّنا لا نستطيع الفكاك عن الأحداث الجسام التي تدور رحاها في بلادنا.
أحاول بهذه الكلمات أن أفهم ما يحدث اليوم في غزة، كيف يُمكن للمرء الذي يعيش خارج غزة أن يتفاعل مع ما يحدث هناك. أحاول أن أفهم لأنّ كلّ ما حدث ويحدث كثير على حياة واحدة قصيرة.
لنبدأ أولاً بالإبادة
لا يُمكن للمرء أن يشيح بنظره عمّا يحدث في غزة. قصف إسرائيلي مستمر وتحضيرات لاجتياح بري. أكثر من مليوني شخص يعيشون في بقعة جغرافيّة ضيّقة يتعرضون لقصف ثقيل أحال بيوتهم وشوارعهم دماراً، بعد أن عاشوا حصاراً مضنياً لنحو ست عشرة سنة. آلاف الأشخاص قتلوا، كثير منهم أطفال. قصفت إسرائيل مستشفيات وكنائس وجوامع. يبدو أن إسرائيل لا تستثني شيئاً، تمحي عائلات كاملة عن الوجود، ويبدو أنّها تريد محو كلّ الفلسطينيين عن الوجود. يُقال في نشرات الأخبار أنّ هناك خطة لإرسال الفلسطينيين إلى الصحراء. نكبة جديدة.
باحثون/ات مختصون/ات يقولون إنّ ما يحدث هو إبادة جماعيّة، وإنّ ما يحدث في اسرائيل على مدى عمرها هو نظام فصل عنصري يعطي كلّ الحقوق للإسرائيلين ويحرم الفلسطينيين من أيّ حق، وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين يبدو أنّ الإسرائيليين قرروا أن يحرموا الفلسطينيين من حق الحياة أيضاً.
لا يُمكن حصر أعداد من قُتل من الفلسطينيين، لأنّ كثير منهم بقي تحت الأنقاض، فامتزجت أشلاؤهم بركام بيوتهم وصاروا جزءاً حقيقيًا من الأرض، لا ينفصلون عنها مهما مرّ عليهم الزمن. صارت أجسادهم هي الأرض.
تمييع الحقائق
وكيف يقابل العالم هذه الإبادة؟ يدعم العالم القوي إسرائيل. زعماء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة قالوا صراحة، نحن ندعم إسرائيل في كلّ شيء. لا يهمهم أعداد القتلى من الفلسطينيين. من هم هؤلاء الفلسطينيون على كلّ حال؟ ليموتوا فداءً لرغبات إسرائيل، فإسرائيل فوق المحاسبة، تقتل ما تشاء وترتكب ما تشاء من جرائم حرب.
وماذا يحدث عندما يحصل شيء كبير، كأن تقصف إسرائيل مستشفى ما وتقتل أكثر من خمسمئة شخص في لحظة واحدة؟ لا شيء. يموت من يموت، ويحزن من يحزن، وينتهي الأمر، لأنّ إسرائيل تتبع استراتيجية يعرفها السوريون جيداً، فقد اتبعها نظام بشار الأسد لسنوات عديدة. يقومون بمجزرة، فيقول الناس إنّ النظام السوري/ إسرائيل قد ارتكتب مجزرة، فيخرج مسؤولون يتبعون النظام السوري/النظام الإسرائيلي برواية بديلة، كأنّ يقولوا مثلًا إنّ من قصف مدن غوطة دمشق بالسلاح الكيماوي هم قوات المعارضة ولا دخل للنظام بدخلك، أو أنّ إسرائيل لم تقصف المستشفى بل إنّ ما حدث كان انفجاراً قام به الفلسطينيون، ويقدّمون دلائل واهية يسهل تفنيدها، لكن وسائل الإعلام التابعة لهم أو المتعاطفة معهم، وأحياناً حتى المعارضة لهم، يتناقلون هذه الرواية ويركزون عليها، فتضيع الحقيقة على المتابع المحايد ويصبح مشتتاً بين روايات مختلفة، لتغييب بعدها مسؤولية الفاعل الحقيقي عن المجزرة.
تخرج مظاهرات منددّة هنا وهناك، وتُكتب بيانات هنا وهناك، وتُوثّق الحقائق هنا وهناك، لكن الحقيقة في اللحظة الآنية تضيع، فلا مواقف حقيقية تؤخذ من شعوب العالم ومسؤوليه. تصبح الحقائق مائعة غير واضحة ومغبّشة. هكذا تفعل إسرائيل، هكذا يفعل النظام السوري، هكذا تفعل كلّ الدكتاتوريات. تمييع الحقائق استراتيجية إعلاميّة تقليديّة تتبعها الدكتاتوريّات.
وكيف نقاوم ذلك؟
في كتاب اسمه “القلم والسيف”، وهو مجموعة من حوارات دافيد بارساميان مع المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد أجراها في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي حول الثقافة والامبريالية والاستشراق وفلسطين، ومن ترجمة توفيق الأسدي، يرد هذا السؤال من بارساميان لسعيد: “فلنقل إنّك شخص عادي على شاطئ وأنت على وشك أن تُحاصر بموجة مديّة من المعلومات وفقدان المعلومات. كيف تبقى دون بلل؟ كيف تشق طريقك عبر شبكات خداع وسائل الإعلام؟”
يجيب سعيد: “هناك مَلَكتان نمتلكهما جميعاً وعلينا استخدامهما في وضع كهذا، حين يكون هناك هجوم ساحق إعلامي كهذا، وهناك عادة هجوم كهذا حين تكون قصة واحدة هي محور القضية. وهاتان هما: أولًا الذاكرة. علينا أن نتذكر ما قالوا في اليوم السابق وهو في العادة العكس بالضبط. والملكة الثانية هي الشك. الأولى تأتي من المرور بتجربة هذه الأمور. إذا تذكرت كمتفرج على التلفزيون، كشخص أمريكي، فأنت قد رأيت «عرفات» يُشتم على أنّه إرهابي، وفجأة يبدو كشخص لطيف لمجرد أنّه يتلفظ بكلمات قليلة، فتعرف أنت أن شيئاً ما على خطأ. لا يمكن أن يحدث هذا بتلك السرعة. وثانياً فإنّ الشك جزء من ملكتك الفكرية والنقدية. يبدو لي أن عليك أن تفعل ذلك مع أي بند من بنود الأخبار. وأن تحاول أن تسأل عمّا هو أكثر مما يُقدم في العشرين دقيقة التي تسمى قانونياً «ساعة الأخبار». أعتقد أنّ أي شخص يستطيع فعل ذلك. هناك دائماً مصادر معلومات بديلة: هناك الكتب والمكتبات. عليك فقط أن تمارس تلك المهارات وترفض السماح لنفسك بأن تصبح مجرد شخص بليد يمتص المعلومات ببساطة، وقد أصبح مسبق البرمجة، مسبق الأدلجة، لأنّ أيّ رسالة على التلفزيون ليست مجرد أي شيء بل عبارة عن صفقة إييولوجيّة تغلغلت عبر نوع من أنواع عمليات المعالجة”.
قرأتُ في مكان ما مؤخراً ما كتبه أحد الأشخاص: “كيف نصدق التاريخ، إن كان الحاضر يزوّر أمام أعيننا؟”.
وماذا عن حرية التعبير؟
أسأل نفسي وأنا أرى مشاهد الشرطة الألمانيّة والفرنسية وهي تعتدي على المتظاهرين المتعاطفين مع الفلسطينيين: هل يوجد مكان ما في العالم يُمكن أن يحكي فيه أي شخص رأيه في أيّ شيء دون أن يتعرّض للأذى؟
في دول أوروبا التي تحتفي بحقوق الإنسان والتي صدّعت رؤوسنا بالحديث عن حقوق الناس، تتغاضى الحكومات عن عملية تطهير عرقي تجري أمام أعيننا مباشرة ومنقولة على الفضائيات التلفزيونيّة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. تتغاضى هذه الحكومات والمؤسسات الأوروبيّة، عن قتل الآلاف من الفلسطينيين، لأنّ إسرائيل فوق أي قانون، حتى وإن ارتكبت جرائم حرب، حسب تعريف جرائم الحرب في كتاب القانون الدولي. أسأل نفسي: أكانوا سيفعلون الشيء نفسه لو كان الضحايا أوروبيون أو أمريكيون بيض؟
ليس التغاضي فقط، بل إنّهم حتى يمنعون التظاهرات والتجمعات التي تقف إلى جانب الفلسطينيين. في يوم قصف المستشفى الأهلي وقتل أكثر من خمسمئة شخص، أكثر من ثلثهم من الأطفال، منعت الشرطة الألمانيّة في شوارع العاصمة برلين الناسَ من التجمع والحزن على من قُتلوا.
في شارع العرب في برلين Sonnenallee، منعت الشرطة الناس من التظاهر والتجمع والهتاف لفلسطين واعتقلت المئات من الذين أبدوا تعاطفهم مع الفلسطينيين، حتى أنّ رجال الشرطة دهسوا شموعاً أشعلها بعض الشبّان والشابات حزناً على ضحايا المستشفى الأهلي. حتى الشموع لم تسلم!
لا يستطيع المرء التعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين في معظم الدول الأوروبيّة ولا سيما في ألمانيا، خوفاً من طرد من العمل أو من دعوى قضائية أو من تحقيق ما، وكأنّنا نعيش في دولة أمنيّة تعيش تحت وطأة دكتاتوريّة ما. أو ربّما، قد يفكر المرء: في ألمانيا يعيش الناس تحت حكم دكتاتوريّة أخرى، من جهة هي دكتاتوريّة رأسماليّة تستعبد الناس، ما يسميه بعض الباحثين/ات «عبودية حديثة»، ومن ناحية أخرى هي دكتاتورية القول، فلا يستطيع المرء قول ما يشاء، خاصة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فذلك خط أحمر، لا يُمكن أن يتجاوزه المرء وإلّا فأنّه يعرّض نفسه لحرب شرسة، إعلاميّة واقتصاديّة ونفسيّة واجتماعيّة، تستهلك كلّ طاقات الفرد.
التركيز على نقطة واحدة
هذا الطوفان الإعلامي الذي أغرَقنا منذ هجوم حماس أدى إلى اختفاء القدرة لدينا/ لدى العالم، على النظر إلى أماكن أخرى. قصفت تركيا شمال شرق سوريا مستهدفة الأكراد مرة أخرى، راح ضحية الهجوم العشرات بين قتلى وجرحى. قصف النظام السوري والجيش الروسي شمال غرب سوريا في أعنف قصف عرفته المنطقة منذ سنتين على الأقل. رفعت أذربيجان علمها فوق إقليم كاراباخ مهجرة آلاف الأرمن في وسط اتهامات للقوات الآذرية بالقيام بعمليات تطهير عرقي، الصراع في اليمن، الصراع في السودان… الخ.
لم نعد ننظر إلى أماكن أخرى وإلى صراعات أخرى في أماكن أخرى من العالم. من المعلوم أنّ ما يحدث في فلسطين هائل الحجم وتأثيره الدولي كبير جداً، لكن ما أثر هذا على شخص يُقصف في ريف إدلب، التي بالمناسبة خرجت في مظاهرات داعمة لغزة؟
مثلما بدأ هذا المقال، هذه الكلمات هي محاولة شخصيّة لفهم ما يدور في العالم ومحاولة لأجد أجوبة عن الأسئلة التي تحتل عقلي منذ أسابيع. أفكر أنّ أحد مشاكل بلادنا أنّنا كنّا نظن دائماً أنّنا محور العالم لنفاجئ بعد قليل أنّنا نعيش على الهامش، يحدث بعدها شيء ما في بلادنا كثورة ما أو حرب جديدة من دائرة الحروب غير المنتهية، فنعود لنظن أنفسنا مركز العالم… وهكذا إلى ما لا نهاية.
مشاعر شخصيّة في فوضى العالم
أناقض نفسي وأقول إنّ ما يحدث كبير جداً، أكبر من قدرتي على الاستيعاب. أشعر، مثل كثيرين على ما أفترض، بالعجز وقلّة الحيلة عند كلّ حدث كبير يصيب بلادنا.
لا يُقارن المرء نفسه بمن فقد كلّ أفراد عائلته، أو بمن فقد بيته وحيّه ومدينته، أو بمن يعيش تحت القصف ليل نهار، لكن هناك شعور بالعجز يأكل المرء من داخله.
لو كنتُ أعيش في غزّة أو في إدلب أو في القامشلي لما كنتُ قادراً على تغيير شيء في الغالب، لكن على الأقل أكون جزءاً من المكان، أعيش ما يعيشه المكان وأهله. ينتابني هذا الشعور منذ سنة ٢٠١٣ حين قصف النظام السوري غوطة دمشق، كنت قد غادرت تلك المنطقة قبلها بشهور قليلة. أصابني إحساس كامل بالعجز، إحساس كامل بذنب النجاة.
حين غزت الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا العراق في سنة ٢٠٠٣، كانت الحرب جزء من عائلتنا، أمي عراقية وجزء من تاريخنا العائلي مرتبط بالعراق، فصارت الحرب جزءاً من يومياتنا. كذلك الأمر حين هاجمت إسرائيل لبنان في العام ٢٠٠٦، كنّا نتفاعل بشكل يومي مع ما يحدث، كانت الحرب جزءاً منّا وخاصة حين جاء لاجئون لبنانيون إلى دمشق. ما أحاول قوله إنّه، حين كنّا نعيش في بلادنا وليس في منفانا البارد، كنّا جزءاً من البلاد بعجزها وفقرها وخوفها وقهرها، كنّا جزءاً منها حتى لو لم نكن نفعل شيئاً أكثر ممّا نقوم به الآن.
منذ سنوات طويلة صارت معركتنا الرئيسيّة في أوروبا هي قدرتنا على قول رأينا في القضية الفلسطينيّة دون أن نخاف من تهم معاداة الساميّة ومن أن نحرم من فرص ومن أن يتم تأطيرنا بصور نمطية معينة. منذ سنوات طويلة ونحن الذين نعيش في أوروبا والولايات المتحدة نسينا صعوبة الحياة في بلادنا، نسينا القصف ومعارك الحياة اليوميّة في بلادنا، لا نعرف قطع الماء ولا قطع الكهرباء ولا صعوبة الحصول على ربطة خبز. نعيش معارك الحياة اليوميّة الأوروبيّة والتي ربّما، وأقول ربّما، لا تشبهنا.
منذ أسابيع، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة أصابني خرسٌ ما. لم أعد أعرف ما الذي عليّ قوله. لم أعد أعرف كيف أشعر. ما يحدث أكبر بكثير مني. خجل حقيقي من مشكلات حياتي الشخصيّة ومن مرضي ومن مرض ابنتي التي أصابها الزكام في يوم الهجوم.
أفكر بأنّني أريد أن تَهجُر الناس، كلّ الناس، تلك البلاد التي لا مكان لأيّ شيء شبه آدمي فيها، ولتبحث لنفسها عن حياة تشبه الحياة في مكان آخر، ومن ناحية أخرى أتمنى لو كنتُ موجوداً في فلسطين أو في إدلب أو دمشق أو القامشلي، أتمنى لو كنّا كلّنا نعيش هناك، لنعيش الذي يعيشه أهلنا وأحبابنا اليوم.
شعور هائل بالعجز أصابني، وقلبي المثقل بالحزن مكسور على بلادنا وعلى أهلها وناسها. انظر إلى المستقبل وأخاف منه.
الخوف من المستقبل
أفكّر بأنّ دورات الحروب لم تنقطع في بلاد الشام أبداً. كيف ستكون هذه البقعة الجغرافيّة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد ثلاثمئة سنة؟ ماذا سنرى؟ ما الدول التي ستختفي؟ من الذي سيبقى؟ من سيحكم من حينها؟ أيّ حرب ستقع؟ لكن ماذا عن مستقبلنا القريب: بعد خمس سنوات، بعد عشر سنوات، عشرين سنة؟ كيف سيكون شكل العالم حين أبلغ سن الشيخوخة؟
هل ستأخذ البيئة بقصاصها منها؟ هل تُخفي حروب اليوم شعوباً مثلما فعلت حروب سابقة؟ هل سيكون لنا مكان في هذا العالم؟ هل تستطيع ابنتي العيش بحرية وكرامة وأمان وعدالة في المستقبل؟
فكرت في بداية هذا النص أنّ أبحث عن إجابات لأسئلة تحتلني، لكنّني انتهيت بأسئلة أكثر وأكبر. كيف يُمكن لحياة واحدة أن تتعايش مع كلّ هذا.
يكاد رأسي ينفجر.