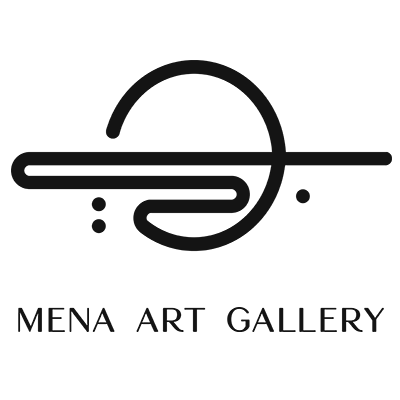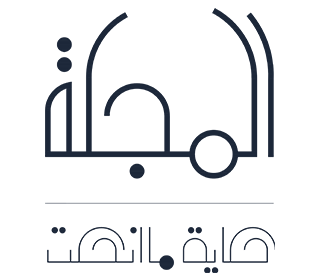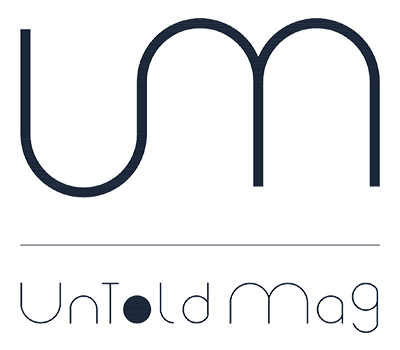في يناير/ كانون الثاني 2024، خلال الأشهر الاولى من الإبادة الإسرائيلية في غزة، قصفت طائرة مسيرة اسرائيلية ضاحية بيروت الجنوب حوالي الساعة الثامنة مساءً، قبل دقائق من زيارة ابنة عمتي منى الى منزلنا في المدينة. فور دخولها الى غرفة الجلوس، فوجئت منى بالخبر الذي نزل عليها كالصاعقة، وعوضًا ان تقول شيئا حول الحدث ذاته او تسألنا عنه، بدأ يتدفق منها كلامًا عفويًا وقلقًا عن العنف الذي عاشته خلال الاجتياح والاحتلال الإسرائيلي للبنان، وكأن هذا العنف القديم المنسي، وسرده، قد حلّا مكان الحدث العنيف الحالي.
الزمن والعنف الإسرائيلي
كنت اعرف بعضًا من هذه الذكريات. كانت بالنسبة لي روايات ثمينة حينما تُسرد، اذ نادرًا ما تجد لها ذكرًا في الأحاديث، وقليلًا ما تُنقل الى الأجيال الاخرى. بدأت منى بتذكّر إحدى قصصها المعروفة والمفضلة لديّ، كمراهقة خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، واقفة في مطبخ جدتنا في مدينة صور (جنوب لبنان) في الطابق الأول، فترى عبر النافذة جنديًا إسرائيليًا مدجّجًا بالسلاح وقد تسلق سطح المنزل المجاور. تسمّرت منى في مكانها، مذهولة، وانتظرت أن يبتعد الجندي قليلًا عن النافذة، ثم بحثت عن شيء تحمي نفسها به، فلم تجد سوى حبات من البصل. التقطت منى حبات البصل ورمتها على ظهر الجندي ورأسه، وانبطحت على أرض المطبخ.
كانت منى تروي هذه الذكرى، وتصل إلى الجزء حيث أصيب فيه الآن الجندي بالبصل، فيشعر بالخوف، ويدور حول نفسه بذعر. في كل مرة سمعنا فيها عن هذه الحادثة، كنا نشترك جميعًا في ضحك عالٍ ومعدٍ، متخيلين معًا الجندي، مسلحًا بكامل عتاده العسكري، مرعوبًا، وخائفًا من بصل منى. “لم أجد إلا البصل لأضربه به، فرميت عليه البصل”، تُكرر منى دائمًا، والدموع تنهمر على وجهها من شدة الضحك.
لكن هذه المرة، انصبّت الذكريات من منى متتاليات، وقد انضم اليها الآن والديّ، مشاركين بقلق ما عاشاه من عنف إسرائيلي، وقد فقدا قدرتهم على السيطرة على هذه الذكريات واخفائها. كانت ذكريات لم تُحك سابقًا في عائلتنا، مثل الوقت الذي علق فيه أبي في الطريق بين مدينة صور وبيروت عشية الاجتياح الإسرائيلي، وقد شاهد الدبابات تدخل بيروت، مختبئًا في سيارته تحت الجسر. وكيف، في ذلك المساء، اضطرت والدتي، التي كانت تزور عائلتها في مدينة النبطية (جنوب لبنان) إلى حرق الكتب ذات العناوين والدلالات اليسارية، أو نقعها في حوض الاستحمام، لإزالة أي علامة يسارية من منزل عائلتها، خشية وصول الإسرائيليين. وكيف اقتحم جيب عسكري إسرائيلي ذات مرة الطريق باتجاه منى وأختها في صور، محاولًا دهسهما، وكيف علقت منى مرة عند حاجز إسرائيلي في طريق الجنوب ليلاً، واضطرت إلى التدحرج على الأرض إلى طريق فرعية للهرب من الجنود.
في تلك الليلة، سقطت الذكريات عن منى وعن أهلي، الواحدة تلو الاخرى، وكأنّ العنف الإسرائيلي الذي عاشوه واخبؤوه في داخلهم منذ الاجتياح قد حاضرهم بشدّة، وكأن العنف الإسرائيلي الحالي الفظيع في غزة، وتبعاته في لبنان، قد أصبح حاوية لأزمنة وأمكنة أخرى، مثل كبسولة زمنية-نفسية تبعث الى الحاضر ماضي العنف الإسرائيلي كله المتراكم والمقموع، وجروحه غير الملتئمة.
في مقالي الأخير عن الصدمة والمعاناة النفسية: كيف يمكن استعادة إنسانية الفلسطينيين؟، تطرقت الى استحالة استعمال ثنائية “التروما / الصمود” كخطابات تحريرية شفائية تتيح مناهضة الإبادة الجماعية وعملية التجريد من الإنسانية الفلسطينية، وكتبتُ عن أهمية ان “نعيد التفكير فيما تعنيه استعادة الإنسانية على المستوى العاطفي والنفسي، بينما ننسحب إلى مساحاتنا الحميمية والحسية” وان “نحمل هذا الألم بمفردنا ومعًا، ونحمله دون الغير، ونعيد الإنسانية له”.
في هذا النص الشخصي، ابدأ عملية التفكير هذه عبر استكشاف واستنباط المساحات النفسية والمتقطعة للذاكرة الجماعية والفردية عن العنف الإسرائيلي، والعيش فيه عبر أجيال مختلفة. هذه الذاكرة المتراكمة وغير المستقرة للعنف لا تطفو بسهولة الى السطح، بل تحضر عنيفة وبوجع، خاصة مع معايشة الإبادة الجماعية الفظيعة في فلسطين. لكنّ أهمية استكشاف هذه الذكريات لعنف إسرائيلي ماض بمواجهة عنف إسرائيلي حالي تكمن أولًا في سردها وتأريخها لهذا العنف، وفي قدرته على تقطيع الطفولة والجسد والوقت والذاكرة وخطاباتها معًا. ثانيًا، تأتي هذه الذكريات كي تربط بين الجروح المندملة الماضية والحاضرة، وتُؤرخ لها. ولا تتساوى جروح الاحتلال والاجتياح الإسرائيلي مع الجروح والبتر التي ترتكبها الإبادة الفظيعة الحالية، ولكن عملية ربط هذه الجروح معًا ومشاركتها قد تؤسس لمخزون معرفي نفسي عن علاقتنا مع الذاكرة، والجسد، والضحك، والهرب، والصمت الخ، وعلى قدرتنا على التشافي معًا.
العنف الإسرائيلي المُقطِّع: طفولة عالقة في الزمن
كان عمري ستة أشهر أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان [1]. القصة الرسمية التي روتها أمي عن تجربتي مع الاجتياح هي أنني استغرقتُ في نوم عميق خلال الغزو ولم أشعر بأي شيء اطلاقًا. وبينما كانت هي مشغولة بحرق الكتب وإغراقها، وكان والدي عالقًا تحت الجسر يحدّق في الدبابات، واصلتُ أنا النوم، كأنه لم يكن هناك قصف ولا طائرات حربية ولا دبابات. لكن –تروي أمي—مع كلّ قصفة، مع كلّ ضربة، “كان جسمك عم يرطّ رطّ” (جملة جنوبية)، وهو يقفز للأعلى ويقع للأسفل، للأعلى وللأسفل، بينما كنتِ تستمرين في النوم. لم تبالِ! ينتاب أمي نوبات ضحك متتالية، وهي تتذكر جسمي الطفولي الصغير نائمًا وهو يقفز ويهبط، يقفز ويهبط، مع كل قصفة وضربة.
قضى والداي بقية سنوات طفولتي، حتى سن الثامنة (سنة انتهاء طفولتي في لبنان مع انتهاء الحرب الاهلية)، في محاولة لتطبيع الخوف والقلق الناتجين عن العنف الإسرائيلي الذي طالما عطّل طفولتي بطرق دقيقة، خفية ومؤلمة كما فعل مع الأطفال الآخرين، وقطّعها. من جهتي، واصلتُ لعب هذا الدور بنجاح، دور الطفلة الهادئة وغير المنزعجة بجسم لا يمكن السيطرة عليه كليًا.

صورة باسبور، بيروت 1984 (العمر سنتان)
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألقى نتنياهو خطابًا، ميّز فيه بين أطفال النور وأطفال الظلام، معلنًا الإبادة الجماعية على أطفال غزة وتجريدهم من إنسانيتهم. عندما سمعتُ مقولة “أطفال الظلام”، وجدتُ نفسي أنبعث بقوة وعنف إلى طفولتي. كان من الصعب عليّ التخلص من الشعور المرعب بأنني عُدتُ طفلة عالقة مرة أخرى في هذه الحرب، لا قدرة لها على الهرب والنجاة، او استيعاب ما يحدث من حولها. ومنذ ذلك الحين، أعايش الإبادة الجماعية من المكان النفسي لهذه الطفولة المقطّعة، وتسقط عني ذكرياتي الخاصة المقموعة والممنوعة من السرد عن العنف الإسرائيلي.
عندما رأيتُ فتاة تبحث في أنقاض منزلها عن دمى لها، استحضرتُ دميتي. عندما شاهدت صبيًا من غزة وهو يجد دراجته بين الانقاض، عُدت طفلة يحاول أباها ان يعلمها ركوب الدراجة ذات العجلتين في خلدة (جنوب بيروت)، فتبدأ الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف، ونهرب ونترك خلفنا الدراجة، ويترك أبي مهمة تعليمي ركوب الدراجة الى الابد. عندما كنتُ أبحث عن مكان آمن يمكن لأهلي في الجنوب ان يختبئوا فيه في حال قُصفت ضيعتنا في الحرب الحالية، حضرت لديّ رائحة الملاجئ التي قبعنا فيها خلال الحروب الماضية بقوة، وكانت هذه الرائحة عبارة عن خليط رائحة غبار قديم وعرق وخوف. كلما خرقت الطائرات الإسرائيلية جدار الصوت، تسقط مني ذكرى من عيشي في ظل العنف الإسرائيلي [2].
في هذه الفترة، حاضرتني بقوة ذكرى لقائي الأول ب”تاتا” و”جدّو” (جدتي وجدي) في مدينة النبطية (جنوب لبنان)، مسقط رأس أمي، سنة 1984. كان عمري سنتين، وقد فقدنا الاتصال بهما بسبب الاحتلال الإسرائيلي. تذكرتُ الرحلة الطويلة والشاقة التي ذهبت بها مع أمي من بيروت إلى النبطية، والتي استغرقت يومًا كاملًا بسبب قطع الطريق والحواجز العسكرية، مرورًا بعدة نقاط تفتيش إسرائيلية (تستغرق الرحلة اليوم مسافة الساعة). تذكرت كم كانت أمي متوترة وخائفة، وكيف اضطررتُ إلى البقاء ساكنًة تمامًا دون إصدار أي صوت، إلا أن جسمي خانني مرة ثانية، ولم أستطع تمالك حاجتي لعمل ال “بي بي”. تذكرت كيف نهرتني أمي بعصبية، وشعوري بالعار وانا اعمل “بي بي” على ناصية الطريق، عار التبول دون رضى أمي، وعار جسمي الذي خذلها مرة أخرى. تذكرت جلوسي في حضنها ليلًا في سيارة أجرة تمر عبر نقطة تفتيش، يداها تحتضناني بقوة. أخبرتني مرة، وقد مرّت سنوات عديدة على الحدث، أن سائق سيارة الأجرة كان يحاول التحرش بها. كان الظلام دامسًا ولم يكن أمامها خيار آخر سوى البقاء في سيارة الأجرة وانا في حضنها، كدرع لها. إسرائيل في الخارج، وعنف من نوع آخر في السيارة.

لا تحبّ امي ان تتكلم عن رحلتنا هذه الا مرغمة، ولم تذكر لي يومًا رحلتها مع اخي وانا، من مدينة النبطية الى بيروت عشية الاجتياح الإسرائيلي. كانت تاتا هي من قصت عليّ هاتين الذكرتين، قبل وفاتها، على الشكل التالي:
وقت الاجتياح كنتِ مع امك عندي بالبيت وكان عمرك ست اشهر. بلّش الاجتياح والقصف، ونزلنا كلنا تخبينا تحت الدرج. وصار الاجتياح والعالم صار تهجّ لفوق. هني يجتاحوا والعالم تهجّ ونحن قاعدين تحت الدرج. بعدين اجا خالك وقال انه هوي فيه يوصّلكم على بيروت وانه حدن دلّه على طريق بس طويلة كثير. خاف جدك يصير معكم شي على الطريق، بس اخدكم خالك ورحتِ انت وأمك على بيروت وما عاد شفتك لشي سنة او سنتين، لما جيتِ مع امك. ولما شفتيني سألتيني: “انتِ مين؟” ولما شفتِ جدك سألتيه: “انتَ مين؟
لا تحبّ أمي تذكر رحلات الهروب، لكنها، مثلي، تتحمس لسماع سردية وصولنا للقاء جدتي وجدي في اليوم التالي. أذكر وقوفنا على الدرج، ننظر الى جدي وجدتي. أذكر أن هناك كان الكثير من الطعام والحب. أذكر أنى جلست في حضن جدي وغنيت له اغنية تبدأ ب “أديش كنا نروح”، أغنية علمتني إياها امي [3]. أذكر انّه كان في الاغنية وصف للنهر والعصافير والأشجار. أعي الآن انّ تذكر لحظة اللقاء هذه كان لعائلتي بمثابة لحظة تشافٍ وإصلاح لعنف الاجتياح، ورحلات الهروب منه.
ربما كان استحضار العنف الإسرائيلي الأكثر ألمًا هو حادثة مقتل هند رجب، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر 6 سنوات في غزة. اتصلت هند بالإسعاف لإنقاذها من سيارتها، فيما أصيب باقي أفراد عائلتها بالرصاص. عُثر عليها بعد أسبوعين مقتولة، مع عمال الإسعاف الذين أتوا لإنقاذها، وقد تعرضت السيارة لإطلاق النار أكثر من 335 مرة.
أيقظ سماع المكالمة الهاتفية التي أجرتها هند مع عمال الإسعاف فيّ ذكرى دفينة ومرعبة، عندما كنت عالقًة في سيارة تحت القصف الاسرائيلي في النبطية حوالي عام 1988 (لاحظت عند كتابتي هذا المقال أنني كنت أيضًا في السادسة من عمري). كنا قد هُجّرنا للتو من بيروت إلى النبطية هربًا من الحرب الأهلية، لنتفاجأ بالعنف الإسرائيلي هناك. بقينا قدر ما استطعنا في منزل عائلة أمي في النبطية، ثم قرّر خالي أنّ العودة إلى بيروت ستكون أكثر أمانًا لنا. وبمجرد صعودنا إلى السيارة، اشتد القصف بشدة، وهربت عائلتي جميعها إلى المنزل. لفترة قصيرة لا تتعدى الدقيقة، وجدت نفسي وحدي داخل السيارة تحت القصف، الى ان رجع خالي أخيرًا وفتح باب السيارة وأعادني بقوة إلى داخل المنزل. عندما سمعت صوت هند تطلب المساعدة، وجدت جسمي مرة أخرى عالقًا في تلك السيارة، تحت القصف، جسم وحيد ومتجمّد، غير قادر على الهرب، على فتح باب السيارة والركض، وعلى البقاء داخل السيارة. انا عالقة لمدة 20 ثانية، وهند علقت الزمن كله.
عندما سقطت عني هذه الذكرى الأخيرة في مواجهة فظاعة العنف الإسرائيلي على هند، سألتُ نفسي: لماذا نجونا من العنف الإسرائيلي وهم لا؟ حدّقت الى جسمي وسألتُ، هل حقًا نجونا؟

العيش في العنف الإسرائيلي: طفولة عبر الجروح
لما يؤسس فعل تذكر ما لم يسرد من عنف إسرائيلي ماضٍ خلال الإبادة الحالية المستمرة؟ وما هي قيمة استحضار طفولة أخرى بحضور فظاعة الإبادة الحالية للطفولة الفلسطينية؟
في مقالهما عن دور الطب في استعادة إنسانية الفلسطينيين، تطرق غسان أبو ستة وريبا ماريا الى الطرق المتاحة للأطباء وغيرهم لمناهضة العنف الإسرائيلي الفظيع الذي يسلب الإنسانية من أجساد والعقول الفلسطينية، لاسيما الأطفال. بالنسبة لكل من أبو ستة وماريا، فإن صيرورة استعادة الإنسانية هي “تمرينًا مهمًا على العالم أن يشارك فيه“، لإعادة تصور الشفاء، والحياة، وللعمل على تحرّر الأجساد والنفوس.
إنّ الجروح المتراكمة والماضية الناتجة عن العيش في ظل العنف الإسرائيلي هي، كالجروح الآنية والحاضرة، جروح مفتوحة. لا تتساوى هذه الجروح، فلا يتساوى مثلًا عنف الاجتياح الإسرائيلي الماضي بحاضر الإبادة. لكنها تؤرّخ لتجربة العيش في العنف الإسرائيلي وفظاعته على اشكالها وجروحها، وتربط بينها ربطًا سياسيًا ونفسيًا.
انّ هذا الربط السياسي-النفسي للجروح يختلف تمامًا عن مشاعر التعاطف مع “الآخر” او فعل الشهادة (ان تشهد على الشيء، تراه) وهي مشاعر نفسية نجدها في خطابات الإنسانية العالمية. على عكس هذه المشاعر “الإنسانية”، يحمل هذا الربط الطفولة الفلسطينية، يرتبط بها، ويسلط الضوء عليها. إن أخذ عملية إستعادة الإنسانية على محمل الجد، كصيرورة سياسية، يعني الاهتمام بالمشهد النفسي للمعاناة من تجربة العيش في العنف الإسرائيلي في منطقتنا، والتشبيك حول ما يسقط منا من سرديات واقوال، والتعلم من التجارب التاريخية لطرق العيش في العنف الإسرائيلي، والنجاة منه.
نعيد خياطة طفولتنا التي قطّعها العنف الإسرائيلي بطرق مختلفة وفظيعة.
[1] هناك محاولات جميلة لسرد وتذكر الاجتياح الإسرائيلي من أجيال أخرى، ولكن بطريقة متعمدة: مثل بدايات، العدد ٣٦، ٢٠٢٣
[2] كتبت عن تجربة العيش في العنف في المقال التالي، كما كتبت مزنة المصري عن الاصداء الحسية للحروب الإسرائيلية وفعل التذكر في المقال التالي:Al-Masri, M. (2017). Sensory reverberations: rethinking the temporal and experiential boundaries of war ethnography. Contemporary Levant, 2(1), 37–48.
[3] أغنية ألفها غريغوار حداد مؤسس الحركة الاجتماعية اللبنانية.