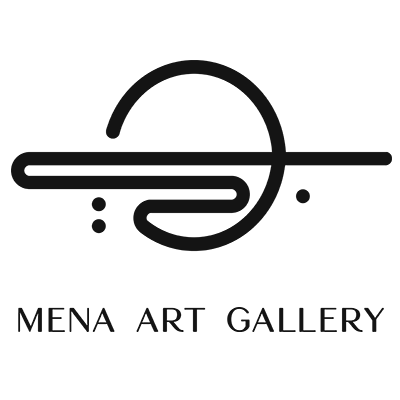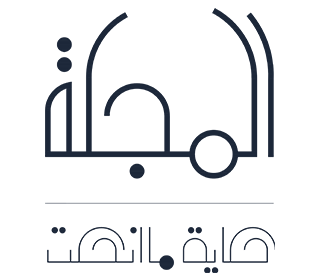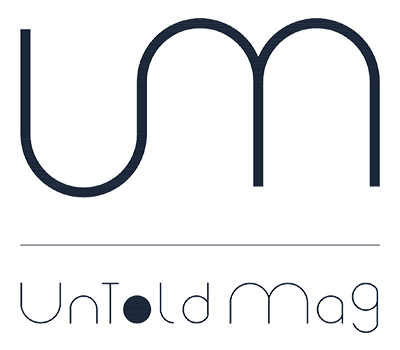*نُشر هذا المقال في الأصل باللغة الإنجليزية في London Review of Books وقد تمت الترجمة بموافقة الناشر. يمكن قراءة النسخة الأصلية هنا.
في عامِ 1977، أي قبل انتحاره بعام، عثرَ الكاتب النمساويّ جان أمري على تقاريرَ صحافيَّةٍ عن التعذيب الممنهجِ الذي يتعرَّض إليه المعتقلون العرب في السجون الإسرائيليَّة. كان أمري نفسه قد تعرَّضَ للاعتقال والتعذيب الوحشيِّ من قِبل جهاز الشرطة السرِّيَّة الألمانيَّة (غِستابو) في عام 1943 في بلجيكا، وذلك أثناء توزيعه منشوراتٍ مُناهضةً للنازيَّة، قبل اقتيادِه إلى أوشفيتز. بقي أمري على قيد الحياة بعد تلك التجربة، لكن دون أن يتمكَّن من النظر إلى عذاباته باعتبارها أحداثاً من الماضي. كان يصرُّ على أنَّ أولئك الذين تعرَّضوا إلى التعذيب يَظلّون مُعذَّبين، وأنَّه لا شفاء لهم من هول تلك الصدمة. على غرار العديد من الناجين من معسكرات الموت النازيَّة، تطوَّرَ لدى أمري “رابطٌ وجودَّيٌّ” بإسرائيل في ستينيَّات القرن المنصرم. هاجمَ بضراوةٍ مُنتقدي الدولة اليهوديَّة من اليسار، واصفاً إيَّاهم “بالطيش وانعدام الضمير“، وكان ربَّما واحداً من أوائل الذين تبنّوا الحجَّة، التي عادةً ما يلجأ الزعماء الإسرائيليَّون ومؤيِّدوهم إلى تعظيم شأنها اليوم، بصدد أنَّ الخبثاء من المعادين للساميَّة إنَّما يتنكَّرون في صورة شرفاء مناهضين للإمبرياليَّة والصهيونيَّة. ومع ذلك، كانت تلك التقارير “غير الكافية، باعتراف الجميع” عن التعذيب في السجون الإسرائيليَّة كفيلةً بدفع أمري إلى إعادة التفكير في حدود تضامنه مع الدولة اليهوديَّة؛ إذ كتبَ في إحدى مقالاته الأخيرة يقول: “إنَّني أناشد جميع اليهود، الذي يريدون أن يصبحوا بشرًا، الانضمام إليَّ في توجيه الإدانة الشديدة للتعذيب الممنهج. فحينما تبدأ الهمجيَّة، لا بدَّ من إنهاء كلِّ شيءٍ، بما في ذلك الارتباطات الوجوديَّة“.
كان أمري منزعجًا بصفةٍ خاصَّةٍ من تمجيد مناحيم بيغن الذي تجلَّى في تنصيبه كرئيسٍ لوزراء إسرائيل في عام 1977. كان بيغن العقل المدبِّر وراء تفجير فندق الملك داوود في القدس في عام 1946، والذي أزهق أرواح 91 شخصًا، ومن أوائل المنادين علانيةً بالتفوُّقِ اليهوديِّ والذين ما زالوا يحكمون إسرائيل. شكَّل بيغن أيضًا سابقةً لأولئك الذين يستحضرون على نحوٍ روتينيّ كلَّاً من هتلر والهولوكوست والكتاب المقدَّس إبَّان الاعتداء على العرب وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلَّة. في أعوامها الأولى، كانت علاقةُ دولة إسرائيل بالمحرقة وضحاياها ملتبسة وغامضة. في بادئ الأمر، اعتبرَ ديفيد بن غوريون، أوَّل رئيس وزراء لإسرائيل، أنَّ الناجين من المحرقة “حُطامٌ بشريّ“، زاعماً أنَّهم لم ينجوا سوى لكونهم “سيِّئين، وقساة، وأنانيِّين“. وكان بيغن، خصم بن غوريون الشعبويّ الآتي من بولندا، من حوَّل مقتل ستَّة ملايين يهوديّ إلى هاجسٍ وطنيٍّ مُكثَّف وركيزةٍ جديدةٍ لهويَّة إسرائيل. شرعت المؤسَّسة الإسرائيليَّة في إنتاج روايةٍ خاصَّةٍ جدًّا للمحرقة وتعميمها، بغية استخدامها في شرعنةِ صُهيونيَّةٍ مُتشدِّدةٍ وتوسُّعيَّة.
انتبه أمري إلى الخطاب الجديد، وكان موقفه حاسمًا بصدد عواقبه المدمِّرة على اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل. فكتب أنَّ بيغن، “الذي يحمل التوراة في يمينه ويتذرَّع بالوعود التوراتيَّة“، ويتحدَّث بصراحةٍ عن سرقة الأراضي الفلسطينيَّة “والتي ستكون وحدها سببًا كافيًا كي يعيد اليهود في الشتات النظر في علاقتهم بإسرائيل“. وناشد أمري زعماء إسرائيل “الاعتراف بأنَّه لا يمكن تحقيق حرِّيَّتكم إلَّا إلى جانب ابن عمِّكم الفلسطينيِّ، وليس على حسابه“.
بعد خمسة أعوامٍ أصَّر طوالها على فكرة أنَّ العرب هُم النازيّون الجدد، وياسر عرفات هو هتلر الجديد: هاجمَ بيغن لبنان. وبحلول الوقت الذي اتَّهم فيه رونالد ريغان الأخير بارتكاب “هولوكوست” آمرًا إيَّاه بالتراجع، كانت القوَّات الإسرائيليَّة قد أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الفلسطينيِّين واللبنانيِّين، ومسحَت أجزاءً واسعةً من بيروت عن بكرة أبيها. في روايته “كابو” الصادرة في عام 1993، يلتقط الروائيِّ اليهوديّ–الصربيّ ألكسندر تيسما الاشمئزازَ الذي شعرَ به العديد من الناجين من المحرقة إزاء الصور القادمة من لبنان: “يهود، وأقاربه، وأبناءُ معاصريه وأحفادهم، ومعتقلون سابقون في المعسكرات، انتصبوا جميعاً في بُرجيَّات الدبَّابات، قادوها، والأعلام تلوّح، عبر مساكن غير مُحصَّنة، عبر لحمٍ بشريّ، مزَّقوه إلى أشلاء برصاص رشَّاشاتهم، واعتقلوا الناجين في معسكراتٍ مُسيَّجةٍ بأسلاك شائكة“.
خاضَ بريمو ليفي أهوال أوشفيتز في الفترة نفسها مثل أمري، وشعرَ أيضاً بتقاربٍ عاطفيٍّ إزاء الدولة اليهوديَّة حديثة العهد، لكنَّه سرعان ما نظَّم رسالةً احتجاجيَّةً مفتوحةً وأجرى مقابلةً قال فيها “إنَّ إسرائيل تسقطُ، بوتيرةٍ متسارعة، في عزلةٍ تامَّة… لا بدَّ من كبح نوازعنا إلى التضامن العاطفيِّ مع إسرائيل كي يتسنَّى لنا الإصغاء إلى صوت العقل حيال ما ترتكبه الطبقة الحاكمة الحاليَّة في إسرائيل من أخطاء. لا مَناص من التخلُّص من تلك الطبقة الحاكمة“. وفي عددٍ من أعماله الروائيَّة وغير الروائيَّة، لم يكتفِ ليفي بإمعان التفكير في الفترة التي قضاها في معسكر الموت وإرثها الأليم والمستعصي على الغياب وحسب، بل أيضًا في التهديدات المستمرَّة للياقة البشر وكرامتهم. كان شديد الغضب أيضًا من استغلال بيغن للمحرقة. بعد عامين، صرَّح ليفي أنَّه “لا بدَّ لمركز الثقل في العالم اليهوديِّ من العودة خلفًا؛ أي يجب أن يخرج من أيدي إسرائيل ويعود إلى الشتات“.
اليوم، تدُان المخاوفُ المشابهة لتلك التي عبَّر عنه كلٌّ من أمري وليفي باعتبارها معاديةً للساميَّة على نحوٍ صارخ. لكن من الجدير بالذكر أنَّ العديد من الطروحات بصدد إعادة النظر في الصهيونيَّة والتخوُّفات بشأن نظرة العالم لليهود إنَّما تتأتَّى عن تحفيزٍ من ناجين من المحرقة، وشهودٍ عليها، بسبب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيَّة وأساطيرها الجديدة المُغرِضة. بالفعل، ومنذ عام 1969، حذَّر عالم اللاهوت يشعياهو ليبوفيتش، الفائز بجائزة إسرائيل في عام 1993، من “تحوُّل إسرائيل إلى النازيَّة“. وفي عام 1980، وصَّف الكاتب الصحافيّ الإسرائيليّ بوعز إيفرون مراحل هذا التآكل الأخلاقيّ: إذ عبَّر عن خشيته من أنَّ انتهاج الخلط بين الفلسطينيِّين والنازيِّين، والصراخ بأنَّ محرقةً أخرى على وشك الحدوث، إنَّما سيُحرِّر الإسرائيليِّين العاديِّين من “أيِّ ضوابط أخلاقيَّة؛ فمن يواجهُ خطر الإبادة يرى نفسه معفيًا من أيِّ اعتباراتٍ أخلاقيَّةٍ قد تحدُّ من جهوده لإنقاذ نفسه“. وبحسب تعبير إيفرون، قد ينتهي المطاف باليهود بمعاملة “غير اليهود بوصفهم أدنى من البشر“، واستنساخ “سلوكيَّاتٍ نازيَّةٍ عُنصريَّة“.
حذَّر إيفرون، أيضًا، من مؤيِّدي إسرائيل (الجدد والمتحمِّسين آنذاك) في أوساط يهود أميركا. فهو يرى أنَّ دعم إسرائيل، بالنسبة إليهم، قد تحوَّل إلى “ضرورةٍ بسبب غياب أيِّ نقطةٍ مركزيَّةٍ أخرى لهويَّتهم اليهوديَّة“- في الواقع، كان افتقارهم الوجوديّ هذا عظيمًا إلى درجة أنَّهم، وفقًا لإيفرون، لم يرغبوا حتَّى برؤية إسرائيل حرَّةً من اعتمادها المتزايد على الدعم اليهوديِّ الأميركيّ.
كانوا بحاجةٍ إلى الشعور بأنَّ هناك من يحتاج إليهم. كانوا بحاجةٍ أيضًا إلى “البطل الإسرائيليّ” باعتبارِه تعويضًا اجتماعيًّا وعاطفيًّا في إطار مُجتمعٍ لا ينظُر عادةً إلى اليهوديِّ كتجسيدٍ لخصائص المحارِب الباسل. وهكذا، قدَّم الإسرائيليُّ لليهوديِّ الأميركيّ صورةً متناقضةً مزدوجة– رجوليَّة البطل الخارق، وضحيَّة المحرقة المحتملة؛ مع العلم أنَّ مُكوِّنات الصورتين كلتيهما بعيدةٌ كلَّ البعد عن الواقع.
اعترى زيغمونت باومان، الفيلسوف اليهوديِّ بولنديُّ المولد واللاجئ من النازيَّة، والذي أمضى ثلاثة أعوامٍ في إسرائيل إبَّان سبعينيَّات القرن المنصرم قبل الفرار من مناخها المتعصِّب والعدوانيّ، يأسٌ شديدٌ من جرَّاء ما اعتبر أنَّه “خصخصةٌ” للمحرقة من قِبل إسرائيل ومناصريها. فكتبَ في 1988، واصفاً أنَّه يجري تذكُّرها الآن باعتبارها “تجربةً تخصُّ اليهود وحدهُم؛ كقضيَّةٍ ما بين اليهود وكارهيهم“، مع العلم أنَّ الشروط التي جعلت حدوثها مُمكناً قد عادت للظهور مجدَّداً في جميع أنحاء العالم. لقد استشعرَ هؤلاء الناجون من المحرقة، الذين انحدروا من الإيمان السامي بالنزعة الإنسانيَّة العلمانيَّة إلى الجنون الجمعيّ، أنَّ العنف الذي نجوا منه، وهو عنف غير مسبوق في حجمه، لم يكُن انحرافًا في حضارةٍ معاصرةٍ سويَّةٍ في الأصل. وأنَّه لا يمكن عزوه بالكامل أيضًا إلى تحيُّزٍ عتيقٍ ضدَّ اليهود. لقد مكَّنت كلٌّ من التكنولوجيا، والتوزيع العقلانيّ للعمل، الناس العاديِّين من المساهمة في أفعال الإبادة الجماعيَّة بضميرٍ مرتاح، بل حتَّى بشعورٍ غامرٍ من الفضيلة، وصارَت الجهود الوقائيَّة ضدَّ هذه الأنماط غير الشخصيَّة والمتاحة للقتل تستلزمُ ما هو أكثر من اليقظة والحذر من معاداة الساميَّة.
حين عدتُ مؤخَّرًا إلى كُتبي من أجل إعداد هذه المقالة، وجدتُ أنَّني قد رسمتُ خطوطًا بالفعل تحت العديد من الفقرات التي أقتبسُها الآن هُنا. وفي مذكَّراتي، هناك سطورٌ نقلتُها عن جورج شتاينر (“ليسَت الدولة القوميَّة التي تعجُّ بالسلاح سوى بقايا ماضٍ مرير، وعبثيَّةٌ في قرنِ اكتظاظ الرجال“)؛ وأبا إيبان (“لقد آن الأوان لنقفَ على أقدامنا، وليس على أقدام أولئك الملايين الستَّة من القتلى). يعود تاريخ معظم هذه التعليقات التوضيحيَّة إلى زيارتي الأولى إلى إسرائيل والأراضي الواقعة تحت احتلالها، عندما كنتُ أبحثُ، بسذاجة، عن إجابةٍ لسؤالين مُحيِّرَين: كيف تمكَّنت إسرائيل من مُمارسة هذه السلطة المفزِعة على حياة مجموعة سُكَّانٍ من اللاجئين وموتهم؛ وكيف بمقدور التيَّارين السائدين في الغرب، سياسيًّا وإعلاميًّا، تجاهل، بل وتبرير، ما ترتكبُه من فظائع ومظالم ممنهجةٍ بصورةٍ لا تقبل الشكّ؟
تشَّربتُ في سنوات نشأتي بعضًا من الصهيونيَّة التبجيليَّة التي واظبَتْ عليها عائلتي التي تنتمي بدورها إلى الطبقة العليا من القوميِّين الهندوس في الهند. انبثقَت كلٌّ من الصهيونيَّة والقوميَّة الهندوسيَّة في أواخر القرن التاسع عشر من تجارب ذات صلةٍ بالإذلال؛ كان هناك توقٌ لدى العديد من مُنظِّري الحركتين إلى التغلُّب على ما اعتبروا أنَّه افتقارٌ مخزٍ في الإنسانيَّة لدى اليهود والهندوس. بالنسبة إلى القوميِّين الهندوس في سبعينيَّات القرن الفائت، والذين كانوا معارضين ضعفاء لحزب المؤتمر الوطنيِّ الحاكم آنذاك، والداعم للفلسطينيِّين، بدا أنَّ الصهاينة العنيدين من أمثال بيغن وآرييل شارون وإسحاق شامير، قد انتصروا في السباق نحو إقامة دولةٍ قوميَّةٍ قويَّة. (لم يعد هذا الحسد خفيًّا على أحدٍ اليوم: إذ يُشكِّل الترول، أو المتصيِّدون الهندوسيّون، أكبر نادٍ للمعجبين ببنيامين نتنياهو في العالم). أذكُر أنَّه كانت على حائط غرفتي صورةٌ لموشيه ديان، الذي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ ووزير الدفاع إبَّان حرب الأيَّام الستَّة؛ وحتَّى بعد فترةٍ طويلةٍ من تلاشي ولعي الطفوليّ بالقوَّة الغاشمة، ظلَّت نظرتي إلى إسرائيل متناغمة مع رؤى زعمائها لها منذ ستينيَّات القرن الفائت، أي باعتبارها خلاصًا لضحايا المحرقة، وضمانةً منيعةً في وجه تكرارها.
أدركتُ مدى ضآلة الأثر الذي خلَّفتهُ مأساة اليهود، الذين عومِلوا ككبش فداءٍ خلال الانهيار الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ في ألمانيا خلال عشرينيَّات القرن الفائت وثلاثينيَّاته، في ضمير زعماء أميركا وأوروبا الغربيَّة، وكيف استُقبِل الناجون أنفسهم من المحرقة بتجاهلٍ وجفاء، بل وبمذابحَ جديدةٍ في أوروبا الشرقيَّة. وعلى الرغم من اقتناعي بعدالة القضيَّة الفلسطينيَّة، إلَّا أنَّني كنتُ أجد صعوبةً في مقاومة المنطق الصهيونيِّ القائل: إنَّه لا سبيل لنجاة اليهود في بلادٍ غير يهوديَّة، ولا بدَّ أن يحظوا بدولةٍ خاصَّةٍ بهم. بل كنتُ أظنُّ أيضاً أنَّه من الإجحاف أنَّ إسرائيل وحدها مُضطرَّة، بخلاف سائر دول العالم، لتبرير حقِّها في الوجود.
لم أكن ساذجًا لدرجة الاعتقاد بأنَّ المعاناة ترفعُ من قدر ضحايا الفظائع الجسيمة أو تُمكِّنهم من التصرُّف على نحوٍ أخلاقيٍ متفوِّق. إنَّ إمكانيَّة تحوُّل ضحايا الأمس إلى جلَّادي اليوم هو الدرس المستفاد من العنف المنظَّم في كلٍّ من يوغوسلافيا السابقة، والسودان، والكونغو، ورواندا، وسريلانكا، وأفغانستان، وأمثلة أخرى عديدة. كنتُ لا أزال مصدومًا من الخلاصة المظلمة التي استقتها الدولة الإسرائيليَّة من المحرقة، ومن ثمَّ مأسستُها في آليَّةٍ قمعيَّة. أعمال القتل التي تستهدف الفلسطينيِّين، ونقاط التفتيش، وهدم المنازل، وسرقة الأراضي، والاعتقالات العشوائيَّة وغير محدَّدة المدَّة، واستشراء التعذيب في السجون؛ بدت كلُّها إعلانًا عن منظومةٍ قيمٍ وطنيَّةٍ عديمة الرحمة: أنَّ البشر مُقسَّمون إلى أقوياء وضعفاء، وبالتالي فإنَّه ينبغي على أولئك الذين كانوا ضحايا، أو من المتوقَّع أن يصبحوا كذلك، أن يسحقوا أعداءهم المُفترَضين بصورةٍ استباقيَّة.
على الرغم من اطِّلاعي على أعمال إدوارد سعيد، إلَّا أنَّني صدِمتُ باكتشافي شخصيًّا لمدى التستُّر الخبيث الذي يمارسه مناصرو إسرائيل رفيعو المستوى على أيديولوجيَّة البقاء للأقوى العدميَّة، التي تعيدُ كافَّة الأنظمة الإسرائيليَّة إنتاجها منذ عهد بيغن. ومع أنَّ المصلحة الذاتيَّة تقتضي تسليط الضوء على جرائم المحتلِّين، فضلًا عن نقل معاناة المحرومين والمجرَّدين من إنسانيَّتهم؛ نجد أنَّ الأمرين كليهما لا يَلقيان الكثير من المعاينة في وسائل الإعلام الغربيَّة المرموقة. كلُّ شخصٍ يشيرُ بالبنان إلى مشهد التزام واشنطن الأعمى تجاه إسرائيل مُتَّهمٌ بمعاداة الساميَّة وتجاهل العبر المستخلَصة من المحرقة. وأمَّا الفهم المشوَّه للمحرقة، فيضمن أنَّه كلَّما انتفض ضحايا إسرائيل بضراوةٍ مُتوقَّعةٍ ضدَّ جلَّاديهم، بعد أن تبلُغ قدرتهم على تحمُّل المعاناة أقصاها، فإنَّهم سيوصمون كنازيِّين عازمين على ارتكابِ محرقةٍ جديدة.
من خلال قراءتي لأعمال أمري وليفي وآخرين والتعليق عليها، حاولتُ بطريقةٍ ما كبحَ الإحساس الطاغي بالخطأ الذي شعرتُ به بعد أن انفتحتُ على كلٍّ من التأويل القاتم الذي قدَّمته إسرائيل للمحرقة، وشهادات الجدارة الأخلاقيَّة الرفيعة التي أسبغها عليها حلفاؤها الغربيّون. كنتُ أبحثُ عن الطمأنينة من أشخاصٍ اختبروا، بأجسادهم الواهنة، الرعب الوحشيَّ الذي حلَّ بملايين البشر على يد ما يفترض أنَّها دولةٌ قوميَّةٌ أوروبيَّة مُتحضِّرة، والذين عزموا على أن يكونوا درعًا أبديًّا في وجه تشويه معنى المحرقة والإساءة إلى ذكراها.
على الرغم من تحفُّظاتها المتزايدة إزاء إسرائيل، تظلُّ هناك طبقةٌ سياسيَّةٌ وإعلاميَّةٌ في الغرب لا تنفكُّ تُجمِّلُ الحقائق الصارخة للاحتلال العسكريِّ والضمِّ غير المشروط للأراضي على أيدي ديماغوجيِّين قوميِّين–عرقيِّين: لإسرائيل، بحسب تلك الجوقة، الحقّ، باعتبارها الديموقراطيَّة الوحيدة في الشرق الأوسط، بالدفاع عن نفسها، ولا سيما في وجه الوحوش الإباديِّين. ونتيجةً لهذا، فإنَّ ليس بمقدور ضحايا الهمجيَّة الإسرائيليَّة في غزَّة اليوم أن يضمنوا حتَّى اعترافًا صريحًا بكارثتهم من قبل النخب الغربيَّة، ناهيك عن إغاثتهم. خلال الأشهر الأخيرة، يشهد مليارات البشر في جميع أنحاء العالم على مذبحةٍ غير مسبوقةٍ، حيثُ ضحاياها، بحسب وصف بليني ني غرالايغ، وهي محاميةٌ أيرلنديَّة وممثِّلةٌ عن جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدوليَّة في لاهاي: “يبثُّون على الهواء مباشرةً هلاكهم بأنفسهم، على أملٍ يائس، وغير مجدٍ إلى الآن، بأنَّ العالمَ قد يفعل شيئاً ما حيال ذلك“.
لكنَّ العالم، أو الغرب كي نكون أكثر تحديدًا، لا يُحرِّك ساكنًا. الأسوأ من ذلك هو التعتيم على ما يجري في غزَّة من تصفية، إن لم يكن إنكارها، على الرغم من دأب مرتكبيها على تفصيلها وبثِّها، من خلال أدوات الهيمنة العسكريَّة والثقافيَّة في الغرب: من مزاعم رئيس الولايات المتَّحدة أنَّ الفلسطينيِّين كاذبون، وترديد سياسيِّين أوروبيِّين لفكرة أنَّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها، ومنافذ إعلاميَّة مرموقة تعمدُ إلى استخدام نبرةٍ سلبيَّةٍ للحديث عن المجازر المرتكبة في غزَّة. نجدُ أنفسنا أمام حالةٍ غير مسبوقة. لم يحدُث من قبل قطّ أن ارتُكِبت مذبحةٌ بهذا الحجم الهائل، على مرأى من هذا الكمِّ الكبير من البشر، لحظة بلحظة. ومع ذلك، فإنَّ كلًَّا من الصرامة والجُبن والرقابة التي تسود المشهد، لا تتيحُ مجالًا لصدمتنا وحزننا، بل وتستهزئ بهما أيضًا. إنَّ الكثير منَّا، ممَّن شاهدوا الصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزَّة، تلك المناظر الجهنَّميَّة لجثثٍ متشابكةٍ ومدفونةٍ في مقابر جماعيَّة، وأخرى أصغر حجمًا تحمِلها أيادي آباء مكلومين، أو مُسجَّاة على الأرض في طوابير مُنتظَمة، قد أصيبوا بالجنون في صمتٍ على امتداد الأشهر القليلة الفائتة. كلُّ أيَّامنا مسمومةٌ بإدراكٍ مفاده أنَّنا بينما نمضي قدماً في حياتنا، فإنَّ هناك المئات من البشر العاديِّين، مثلنا، يتعرَّضون للقتل، أو يُجبَرون على مشاهدة مقتل أطفالهم.
يرى أولئك المتحمِّسون للبحث في ملامح وجه جو بايدن عن أيِّ إشارةٍ للشفقة أو وضع حدٍّ لإراقة الدماء، صلادةً ناعمةً إلى حدٍّ مخيف، تتخلَّلها ابتسامةٌ متكلِّفةٌ مُقتضَبة ومتوتِّرة فقط حينما يتفوَّه بالأكاذيب الإسرائيليَّة عن أطفالٍ مقطوعي الرؤوس. حقدُ بايدن وقسوته ضدَّ الفلسطينيِّين ليست سوى واحدٍ من بين العديد من الألغاز المروِّعة التي يطرحها أمامنا سياسيّون وصحافيّون غربيّون. لقد حلَّت صدمة المحرقة بجيلين يهوديِّين على أقلّ تقدير، وأمَّا المذابح واحتجاز الأسرى في إسرائيل، في السابع من تشرين الأوَّل، على أيدي حماس وجماعاتٍ فلسطينيَّةٍ أخرى، فقد أجَّجت لدى العديد من اليهود مشاعر الخوف من إبادةٍ جماعيَّة. لكن، كان جليًّا منذ البداية أنَّ القيادة الإسرائيليَّة الأشدّ تعصُّبًا في التاريخ لن تتوانى عن استغلال الشعور المتفشِّي بالانتهاك والفاجعة والذعر. كان يسيرًا على الزعماء الغربيِّين أن يكبحوا رغبتهم بالتضامن غير المشروط مع نظامٍ مُتطرِّف، وفي الوقت نفسه الإقرار بضرورة ملاحقة أولئك المذنبين بارتكاب جرائم حربٍ في السابع من تشرين الأوَّل وتقديمهم إلى العدالة. إذًا، ما الذي يدفع كير ستارمر، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان، للتأكيد على حقِّ إسرائيل بـ “منع الطاقة والمياه” عن الفلسطينيِّين؟ ولماذا شرعَت ألمانيا على نحوٍ محمومٍ ببيع المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل (ومع انتشار الافتراءات في أجهزتها الإعلاميَّة، وحملات القمع الرسميَّة الشرسة، لا سيما ضدَّ فنَّانين ومفكِّرين يهود، والتي تُقدِّم درسًا جديدًا للعالم بصدد الصعود السريع لتيَّار القوميَّة العرقيَّة هُناك)؟ كيف نفسِّرُ عناوين رئيسيَّةً في بي بي سي ونيويورك تايمز على غرار “هند رجب، طفلةٌ في السادسة من عمرها، عُثِر عليها متوفِّيةً في غزَّة عقب أيَّامٍ من اتصِّالاتها الهاتفيَّة طلباً للنجدة“، أو “دموعُ أبٍ من غزَّة خسر 103 من أقاربه“، أو “وفاة رجلٍ بعد أن أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيليَّة في واشنطن، بحسب ما أعلنته الشرطة“؟ لماذا يواظب الصحافيّون والسياسيّون الغربيّون على تقديم عشرات الآلاف من القتلى والمصابين الفلسطينيِّين باعتبارهم أضرارًا جانبيَّةً في حرب الدفاع عن النفس المفروضة على الجيش الأكثر أخلاقيَّة في العالم، بحسب مزاعم الجيش الإسرائيليّ؟
لا مجال إلَّا أن تشوب إجاباتُ الكثيرين في جميع أرجاء العالم مرارةٌ عنصريَّةٌ تستعرُ منذ أمدٍ طويل. ففلسطين “قضيَّة لون“، كما أوضح جورج أورويل في عام 1945، وكذلك كان منظور غاندي حتمًا؛ والذي ناشد الزعماء الصهاينة ألَّا يلجؤوا إلى الإرهاب ضدَّ العرب باستخدام أسلحةٍ غربيَّة، ولا ضدَّ أمم ما بعد الاستعمار التي رفضت معظمها الاعتراف بدولة إسرائيل. توصيفُ وليم دو بويز للمشكلة المركزيَّة للسياسات الدوليَّة، ألا وهي “خطُّ/ حدّ اللون“، شكَّل حافزاً لنِلسون مانديلا ليقول إنَّ حرِّيَّة جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصريِّ “منقوصةٌ ما لم يتحرَّر الفلسطينيّون“. جيمس بولدوِن طالبَ بالحطِّ من قدر ما اصطلحَ له تسمية “الصمت المرائي” إزاء سلوكيَّات إسرائيل؛ عندما قال إنَّ الدولة اليهوديَّة، التي كانت تبيع الأسلحة لنظام الفصل العنصريِّ في جنوب أفريقيا، تجسيدٌ لتفوُّقِ البيض وليس الديموقراطيَّة. محمَّد علي اعتبرَ فلسطينَ نموذجاً للظلم العنصريِّ السافر. وبالمثل، نرى اليوم موقف زعماء أقدمِ الجاليات المسيحيَّة السوداء وأبرزها في الولايات المتَّحدة؛ حيثُ اتَّهموا إسرائيل بارتكاب إبادةٍ جماعيَّةٍ وطالبوا بايدن بقطع كلِّ المعونات الماليَّة والعسكريَّة عنها.
في عام 1967، بلغَ بولدوِن من الفظاظة إلى درجة القول إنَّ معاناة الشعب اليهوديّ “معترفٌ بها كجزءٍ من التاريخ الأخلاقيِّ للعالم“، في حين “أنَّ هذا ليس هو الحال بالنسبة إلى السود“. وفي عام 2024، يدركُ المزيد من الناس أنَّه، ومقارنةً بضحايا النازيَّة من اليهود، فإنَّه بالكاد هناك إشارةٌ إلى الملايين العديدة من الأرواح التي أزهقتها العبوديَّة، ومحارق أواخر العصر الفيكتوريِّ الكثيرة في كلٍّ من آسيا وأفريقيا، والهجمات النوويَّة على هيروشيما وناغازاكي. لقد شهِدت الأعوام الأخيرة تسييسًا محمومًا لمليارات البشر من غير الغربيِّين، كنتيجةٍ لحرب الغرب الكارثيَّة على الإرهاب، و“أبارتايد التطعيم” إبَّان الجائحة، والنفاق الصارخ إزاء محنة كلٍّ من الأوكرانيِّين والفلسطينيِّين؛ بينما يَصعُب عليهم عدم التنبُّه إلى انتشار نسخةٍ عدائيَّةٍ من “إنكار الهولوكوست” بين صفوف نُخَب الدول الإمبرياليَّة السابقة، التي ترفض التعاطي مع ماضي دولِها الحافل بالوحشيَّة الإباديَّة والنهب، وتحاول جاهدةً نزع الشرعيَّة عن أيِّ نقاشٍ بهذا الصدد باعتباره نابعًا عن “صحوةٍ” مُشوَّشة. وما زالت سرديَّاتُ تفوُّق الغرب السائدةُ عن الشموليَّة تتجاهل التوصيفات الثاقبة للنازيَّة (التي قدَّمها جواهر لال نهرو وإيمي سيزير، فضلًا عن رعايا إمبرياليِّين آخرين) بوصفها “التوأم” الراديكاليِّ للإمبرياليَّة الغربيَّة؛ وكذلك تتهرَّب من استكشاف الرابط الواضح ما بين كلٍّ من المذابح الإمبرياليَّة للسكَّان الأصليِّين في المستعمرات، والأهوال الإباديَّة التي ارتُكِبت ضدَّ اليهود على أراضي أوروبا.
واحدٌ من أعظم الأخطار التي تتهدَّد عالمنا اليوم يتمثَّل في ازدياد حدِّ اللون ثخنًا، ليصبح أشبه بخطِّ ماجينو جديد. إنَّ معظم البشر خارج الغرب، الذين كانت تجربتهم الأوَّليَّة مع الحضارة الأوروبيَّة على هيئة استعمار وحشيٍّ من قبل مُمثِّليها، لا ينظرون إلى المحرقة باعتبارها عملًا فظيعًا غير مسبوق. وفي أثناء تعافيها من ويلات الإمبرياليَّة التي حلَّت ببلادها، فإنَّ الشعوب غير الغربيَّة لم تكن في وضعٍ يسمحُ لها بتقدير حجم الأهوال التي ألحقَّها ذلك التوأم الراديكاليُّ للإمبرياليَّة باليهود في أوروبا. لذا عندما يُقارِن الزعماء الإسرائيليُّون حركة حماس بالنازيِّة، ويتقلَّدُ الدبلوماسيّون الإسرائيليّون النجوم الصفراء في الأمم المتَّحدة، فإنَّ جمهورهم يقتصر غالبًا على الغربيِّين وحسب. لا تتحمَّل معظم شعوب العالم عبء الذنب الأوروبيِّ المسيحيّ الناجم عن المحرقة، كما لا يعتبرون نشوء إسرائيل ضرورةً أخلاقيَّةً للتكفير عمَّا ارتكبه أوروبيّو القرن العشرين من خطايا. لأكثر من سبعة عقود حتَّى الآن، ظلَّ النقاش لدى “الشعوب ذوي البشرة الداكنة” على النحوِ الآتي: لماذا ينبغي حرمان الفلسطينيِّين ومعاقبتهم على جرائم لم يتواطأ على ارتكابهم أحدٌ عدا الأوروبيِّين؟ ولا يسعهم إلَّا النفور باشمئزازٍ من الزعم الضمنيِّ الذي مفادُه أنَّ لإسرائيل الحقّ في ذبح 13,000 طفل، ليس من باب الدفاع عن النفس وحسب، لكن باعتبارها دولةً خُلِقت من رحم المحرقة.
في عام 2006، حذَّر توني جدت بالفعل من أنَّه “لم يعُد واردًا توظيف المحرقة كذريعةٍ لسلوكيَّات إسرائيل“، لأنَّ المزيد من البشر “غير قادرين ببساطةٍ على فهم كيف يمكن استحضار أهوال الحرب الأوروبيَّة الأخيرة كرخصةٍ لسلوكيَّات غير مقبولة، أو لغضِّ الطرف عنها، في زمانٍ ومكانٍ آخرين“. حذَّر أيضًا من أنَه لم يعد بمقدور (هوس الاضطهاد طويل الأمد) الإسرائيليّ– “بأنَّ الجميع يسعون للنيل منَّا“- استدرار التعاطف، وأنَّ خطر معاداة الساميَّة العالميَّة قد تحوَّل إلى نبوءاتٍ “ذاتيَّة التحقُّق“: “أيّ أنَّ سلوك إسرائيل الأرعن، وإصرارها الدائم على توصيف كلِّ انتقادٍ يواجهها باعتباره معاديًا للساميَّة، قد صارا اليوم المصدر الرئيسيَّ للمشاعر المعادية لليهود في أوروبا الغربيَّة وجزءٍ كبيرٍ من آسيا“. أخلصُ أصدقاءِ إسرائيل اليوم هُم من يؤجِّجون هذا الوضع. ومثلما أوضح الصحافيّ وصانع الأفلام الوثائقيَّة يوفال أبراهام، بالقول إنَّ “إساءة الاستخدام المشينة” لتهمة معاداة الساميَّة من قِبل الألمان تُفرِغُها من المعنى، و“بالتالي، تُعرِّض اليهود للخطر في جميع أنحاء العالم“. بايدن لا يزال مُتمسِّكًا بحجَّةٍ زائفةٍ مفادها أنَّ أمان الشعب اليهوديُّ حول العالم معتمدٌ على إسرائيل. يقول عزرا لاين، وهو كاتب عمودٍ في نيويورك تايمز: “أنا يهوديّ. هل أشعر بأنَّني أكثر أمانًا؟ هل أشعر أنَّ هناك تراجعًا في معاداة الساميَّة في العالم بسبب ما يجري اليوم، أم يبدو لي أنَّها تشهَدُ صعودًا هائلًا؛ وأن حتَّى اليهود خارج إسرائيل صاروا عرضةٌ للخطر من جرَّاء ما يحدث في داخلها؟“.
بدا أنَّ الناجين من المحرقة، الذين استشهدتُ بهم سابقًا، قد توقَّعوا هذا السيناريو المدمِّرُ بوضوحٍ تامٍ، وحذَّروا من الضرر التي يلحق بذاكرة المحرقة كنتيجةٍ لاستغلالها. في أعقاب ثمانينيَّات القرن المنصرم، حذَّر باومان مرارًا وتكرارًا من أنَّه من شأن هذه الأساليب التي يعمد إليها سياسيُّون عديمو الضمير كبيغن ونتنياهو أن تضمنَ “لهتلر انتصارَ ما بعد الموت، إذ كان يَحلُم بنشوب صراعٍ بين اليهود والعالم أجمَع“، و“منع اليهود من التعايش السلميِّ مع الآخرين أبدًا“. أمري، الذي عاش أعوامه الأخيرة يائسًا بسبب “تفاقم مُعاداة الساميَّة“، كان قد ناشد الإسرائيليِّين أن يُعاملوا الفلسطينيِّين، بما في ذلك الإرهابيِّين منهم، بطريقةٍ إنسانيَّة، وذلك لئلَّا يتحوَّل تضامنه وأمثاله من صهاينة الشتات مع إسرائيل “إلى أساسٍ لشراكةٍ بين طرفين محكومٍ عليها بالفشل في مواجهة الكارثة“.
لا يتوقَّع المرء الكثير من زعماء إسرائيل الحاليِّين في هذا الصدد. كان أحرى بهم إبَّان اكتشافهم هشاشتهم الشديدة أمام كلٍّ من حزب الله وحماس أن يصيروا أكثر استعدادًا للمخاطرة في سبيل التوصُّل إلى تسويةٍ سلميَّة. مع ذلك، ومع كلِّ ما أغدقه عليهم بايدن من قنابل من وزن ألفي رطل، فإنَّهم يسعون بجنونٍ إلى زيادة عسكرة احتلالهم لكلٍّ من الضفَّة الغربيَّة وغزَّة. هذا الأذى الذاتيِّ هو التأثير طويل الأمد التي عبَّر بوعز إيفرون عن خشيته منه عندما حذَّر من “الحديث المستمرِّ عن المحرقة ومعاداة الساميَّة وكراهية اليهود عبر كلِّ الأجيال“. “لا يمكن فصلُ قيادةٍ ما عن أجندتها“، يقول إيفرون، والطبقة الحاكمة في إسرائيل تتصرَّفُ كأنَّها زعامة “طائفة” تنشَطُ “في عالمِ الأساطير والوحوش التي صنعَتها بأيديها“، “ولم تعُد قادرةً على فهم ما يحدثُ في العالم الحقيقيّ” أو “العمليَّات التاريخيَّة التي تحيط بالدولة“.
أيضاً، وبعد أربعةٍ وأربعين عامًا من كتابة إيفرون للسطور السابقة، يبدو أكثر وضوحًا الآن أنَّ رعاة إسرائيل الغربيِّين قد تحوَّلوا إلى أسوأ أعدائها إذ يغرقون ربيبتهم في مزيدٍ من الوهم. وكما قال إيفرون، تتصرَّف القوى الغربيَّة ضدَّ “مصالحها الخاصَّة، وتتعامل مع إسرائيلَ في إطارٍ علاقةٍ تفضيليَّةٍ خاصَّة من دون أن ترى إسرائيل نفسها ملزمةً بالتعامل بالمثل“. نتيجةً لذلك، “فإنَّ المعاملة الخاصَّة التي تحظى بها إسرائيل، مُتمثِّلةً في دعمٍ اقتصاديٍّ وسياسيٍّ غير مشروط“، قد “خلقَت حول الأخيرة دفيئةً اقتصاديَّةً وسياسيَّةً تعزلُها عن الحقائق الاقتصاديَّة والسياسيَّة العالميَّة“.
يُهدِّدُ نتنياهو وزمرتهُ ركائز النظام العالميِّ الذي أعيدَ بناؤه بعد فضح الجرائم النازيَّة. حتَّى قبل غزَّة، كانت المحرقة في خضمِّ خسارة موقعها المركزيِّ في خيالنا عن الماضي والمستقبل. صحيحٌ أنَّه لم تشهَد أيُّ فظاعةٍ تاريخيَّةٍ أخرى هذا القدر الواسع والشامل من إحياء الذكرى؛ لكن ثقافة هذا الإحياء قد بلغت الآن مدى تراكُمِ تاريخها الطويل، والذي يُظهِرُ أنَّ ذاكرة المحرقة لم تنبثِق بطريقة طبيعيَّةٍ عمَّا جرى ما بين عامي 1939 و1945 وحسب؛ بل تَشكَّلَت، على نحوٍ متعمَّدٍ في أغلب الأحيان، ولأجل غاياتٍ سياسيَّةٍ محدَّدة. في الواقع، صار الإجماع الضروريُّ حول الأهمِّيَّة العالميَّة للمحرقة مُقوَّضًا مع تزايد وضوح الضغوطات الأيديولوجيَّة التي تُفرَضُ على ذاكرتها.
بعد عام 1945، لم يعد خفيًّا على أحدٍ أنَّ النظام النازيَّ في ألمانيا، والمتواطئين معه من الأوروبيِّين، قد قتلوا ستَّة ملايين يهوديّ. لكن، لأعوامٍ طوال، لم تلقَ هذه الحقيقة المروِّعة صدى سياسيًّا وفكريًّا يُذكَر. في أربعينيَّات القرن المنصرم وخمسينيَّاته، لم يكن يُنظَر إلى المحرقة باعتبارها فظاعةً بمعزلٍ عن فظائع الحرب الأخرى: كمحاولات إبادة الشعوب السلافيَّة، والروما، وذوي الاحتياجات الخاصَّة، والمثليِّين. لا شكَّ أنَّه كانت لمعظم الشعوب الأوروبيَّة أسبابها الخاصَّة لعدم الخوض في مسألة قتل اليهود. كان الألمان مهووسين بصدمتهم الخاصَّة، الناجمة عمَّا تعرَّضوا إليه من قصف، واحتلالٍ من قِبل قوى الحلفاء، وطردٍ جماعيٍّ من أوروبا الشرقيَّة. فرنسا، وبولندا، والنمسا، وهولندا؛ والتي تعاونت بحماسةٍ مع النازيِّين، أرادت تقديم نفسها كجزءٍ من “مقاومةٍ” باسلة ضدَّ الهتلريَّة. ولفترةٍ طويلة بعد انتهاء الحرب في عام 1945، ظلَّت هناك تذكيراتٌ فاضحةٌ كثيرة تنطوي على دلالات التواطؤ: حيثُ شغلَ منصب المستشار والرئيس في ألمانيا نازيُّون سابقون. وكان الرئيس الفرنسيُّ فرانسوا ميتران قياديًّا في نظام فيشي. وحتَّى وقتٍ متأخِّر، في عام 1992، كان كورت فالدهايم لا يزال رئيسًا للنمسا على الرغم من الأدلَّة التي تفضحُ تورُّطه في الفظائع النازيَّة.
حتَّى في الولايات المتَّحدة، سادَ “صمتٌ عامّ، ونوعٌ من إنكار المحرقة على مستوى الدولة“، بحسب تعبير إديث زيرتال في كتاب “إسرائيل: المحرقة وسياسات الأمَّة“، الصادر في عام 2005. مرَّت فترةٌ طويلةٌ بعد عام 1945 قبل أن يتَّخذ إحياء ذكرى المحرقة طابعًا علنيًّا. في إسرائيل نفسها، ظلَّ الوعي بالمحرقة مُقتصرًا على الناجين منها وحسب طوال أعوامٍ عديدة، وكانوا، ومن العجيب تذكُّرُ ذلك الآن، يُمطَرون بالازدراء من قِبل زعماء الحركة الصهيونيَّة. في البداية، رأى بن غوريون صعود هتلر إلى السلطة بمثابة “دعمٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ عظيمٍ للمشروع الصهيونيّ“، في حين أنَّه لم ينظر إلى الحطام البشريِّ الذي خلَّفه هتلر في معسكرات الموت كمادَّةٍ مُناسبةٍ لبناء دولةٍ يهوديَّةٍ قويَّةٍ جديدة. “كلُّ ما قاسوه“، قال بن غوريون، “كان كفيلًا بتطهير أرواحهم من أيِّ خير“. شاؤول فريدلِندر؛ أحد أبرز مُؤرِّخي المحرقة، والذي كان من أسباب رحيله عن إسرائيل هو عدم قدرته على تحمُّل مشاهدة استغلال المحرقة “كذريعةٍ لاستخدام تدابير قاسيةٍ ضدَّ الفلسطينيِّين“، كتبَ في مُذكَّراته، الصادرة في عام 2016 بعنوان “حيثُ تفضي الذاكرة“، أنَّ الباحثين الأكاديميِّين تجاهلوا الموضوع في البداية، تاركين إيَّاه لمركز ياد فاشيم للذكرى والتوثيق.
بدأت المواقف السابقة تتغيَّر مع محاكمة أدولف آيخمان، في عام 1961. في كتابه “المليون السابع” الصادر في عام 1993، يروي المؤِّرخ الإسرائيليُّ توم سيغف أنَّ بن غوريون، الذي اتَّهمَهُ بيغن وغيره من خصومه السياسيِّين بعدم الاكتراث بالناجين من المحرقة، قرَّر تنظيم “مُتنفَّسٍ وطنيّ” من خلال إجراء محاكمةٍ لمجرم حربٍ نازيّ. كان يأمل في تثقيف يهود البلاد العربيَّة عن المحرقة ومعاداة الساميَّة الأوروبيَّة (كظاهرتين غير مألوفتين بالنسبة إليهم)، والبدء بربطهم باليهود ذوي الأصول الأوروبيَّة ضمن ما بدا بوضوحٍ أنَّه مجتمعٌ متخيَّلٌ بصورةٍ منقوصة. يمضي سيغف في وصف تطوير بيغن لهذه السيرورة الهادفة إلى خلق وعيٍ بالمحرقة لدى اليهود ذوي البشرة الداكنة، الذين كانوا لفترةٍ طويلةٍ هدفًا للإذلال العنصريِّ من قبل مؤسَّسة البيضاء للبلاد. لقد داوى بيغن جراحهم الناجمة عن الطبقيَّة والعنصريَّة من خلال وعدهم بأراضٍ فلسطينيَّةٍ مسروقةٍ ومكانةٍ اجتماعيَّةٍ اقتصاديَّةٍ أعلى من العرب المحرومين والمعدمين.
اقترنَ هذا التوزيع لنسبة الانتماء الإسرائيليّ مع تعاظم تأثير سياسات الهويَّة داخل أقليَّةٍ ثريَّةٍ في الولايات المتَّحدة. في كتابه “المحرقة في الحياة الأميركيَّة“، الصادر في عام 1999، يسهب بيتر نوفيك على نحوٍ مذهلٍ في بيان أنَّ المحرقة “لم تُلق بظلالها إلى حدٍّ بعيد” على حياة يهود أميركا حتَّى أواخر ستينيَّات القرن المنصرم. كما لم يتناول موضوعها إلَّا عددٌ ضئيلٌ من الكتب والأفلام وحسب. فيلم “حُكمٌ في نورمبرغ“، الذي عُرض في عام 1961، أدرجَ القتل الجماعيَّ لليهود ضمن فئةٍ أوسع نطاقًا شملَت جرائم النازيَّة. وفي مقالته “المثقَّف والمصير اليهوديّ“، المنشورة في مجلَّة “كومينتاري” في عام 1957، لم يذكُر شفيعُ الصهاينة المحافظين الجدد في ثمانينيَّات القرن الفائت، نورمان بودهوريتز، أيَّ حرفٍ عن المحرقة على الإطلاق.
في البداية، لم تُشِّجع المنظَّمات اليهوديَّة، التي ذاع صيتها السيِّء بشأن ممارستها الرقابة على الآراء عن بالصهيونيَّة، على تخليد ذكرى الضحايا اليهود الأوروبيِّين؛ بل كانت تهروِل من أجل تعلُّم القواعد الجديدة للعبة الجيوسياسيَّة. ففي التبدُّلات الأشبه بتغيير الحرباء لألوانها إبَّان أوائل فترة الحرب الباردة، تحوَّل الاتِّحاد السوفيّتيّ من كونه حليفًا شرسًا ضدَّ ألمانيا النازيَّة إلى شرٍّ استبداديّ؛ وبالعكس، صارَت ألمانيا حَليفًا ديموقراطيًّا ثابتًا ضدَّ الشرِّ الاستبداديِّ بعد أن كانت تمثِّل واحدةً من تمظهراته. ونتيجةً لذلك، حثَّ محِّرر مجلِّة كومنتاري اليهود الأميركيِّين على ترسيخ “موقفٍ واقعيٍّ بدلًا من تبنَّي موقفٍ عقابيٍّ واتِّهاميٍّ” إزاء ألمانيا، التي تحوَّلت حينذاك إلى ركيزةٍ من ركائز “الحضارة الديموقراطيَّة الغربيَّة“.
هذا التلاعب المكثَّف بالعقول، الذي مارسَه سياسيّو العالم الحرِّ ومفكِّروه، أحدث صدمةً لدى العديد من الناجين من المحرقة وأثار حفيظتهم. مع ذلك، لم يُنظَر إليهم حينها باعتبارهما شهودًا يتمتَّعون بامتيازاتٍ فريدة في العالم الحديث. أمري، الذي كان يبغض “الفيلوساميَّة التطفُّليَّة” لألمانيا ما بعد الحرب، اقتصرَ على تركيز “استيائه” الخاصِّ في مقالاتٍ سعَت إلى استثارة “الضمير البائس” للقرَّاء الألمان. في إحدى تلك المقالات، يصف أمري رحلته عبر ألمانيا في أواسط ستينيَّات القرن الفائت. ففي أثناء مناقشته لرواية سول بيلو الأخيرة مع ثلَّة من مثقَّفي البلد الجدد “الرفيعين“، لم تغب عن ذهنه “الوجوه الخالية من التعبير” لألمان عاديِّين أمام كومةٍ من الجثث؛ واكتشفَ أنَّه يحملُ “ضغينةً” جديدةً تجاه الألمان ومكانتهم المرموقة في “قاعات الغرب المهيبة“. تجربة أمري مع “العزلة المطلقة“، أمام جلَّاديه من الشرطة السرِّيَّة الألمانيَّة، كانت كفيلةً بتدمير “ثقته بالعالم“. ولم يعرف مجدَّدًا معنى “التفاهم المتبادل” مع بقيَّة البشر إلَّا بعد تحريره من الأسر، والسبب، على حدِّ تعبيره، “أنَّ أولئك الذين عذَّبوني وحوَّلوني إلى حشرةٍ” بدا وكأنَّهم يثيرون “ازدراءي“. لكن سرعان ما تداعى إيمانُه الشفائيُّ بـ “توازن أخلاقيَّات العالم” في أعقاب احتضان الغرب لألمانيا، وتهافُتِ العالم الحرِّ على تجنيد النازيِّين السابقين لصالح “لعبته الجديدة على السلطة“.
كانت مشاعر أمري بالخيانة ستزداد حدَّةً لو اطَّلع على مُذكَّرة موظَّفي اللجنة اليهوديَّة الأميركيَّة في عام 1951، إذ أعربت عن أسفها لحقيقة أنَّ “التفكير السليم لدى معظم اليهود، حيال ألمانيا والألمان، لا يزال مشوَّشًا بفعل مشاعر قويَّة“. يُبيِّن نوفيك أنَّ اليهود الأميركيِّين، مثل غيرهم من الجماعات العرقيَّة، كانوا حريصين تهمة الولاء المزدوج والاستفادة من الفرص الهائلة التي وفَّرتها أميركا ما بعد الحرب. صاروا أكثر انتباهًا لوجود إسرائيل في أثناء محاكمة آيخمان المثيرة للجدل وما حظيت به من تغطيةٍ إعلاميَّة مكثَّفة؛ إذ جعلَت من الطرح القائل إنَّ اليهود شكَّلوا القائمة الأساسيَّة لأهداف هتلر وضحاياه حقيقةً لا مفرَّ منها. لكن فقط في أعقاب كلٍّ من حرب الأيَّام الستَّة في عام 1967 وحرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) في عام 1973، أي عندما بدا أنَّ إسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًّا من أعدائها العرب، صار ينُظَر إلى المحرقة ضمن إطار أشمل، في كلٍّ من إسرائيل والولايات المتَّحدة، باعتبارها رمزًا للضعف اليهوديِّ في عالمٍ معادٍ لهم إلى الأبد. هُنا شرعَت المنظَّمات اليهوديَّة بنشر شعار “لن تحدث مجدَّدًا“، للضغط من أجل ضمان سياسياتٍ أميركيَّةٍ لصالح إسرائيل. بدورها، بدأت الولايات المتَّحدة، بعد تعرُّضها لهزيمةٍ مذلَّةٍ في شرق آسيا، ترى في إسرائيل التي تبدو ظاهريًّا لا تقهر، وكيلًا قيِّمًا في الشرق الأوسط، فبدأت تدعم الدولة اليهوديَّة بسخاء. وفي المقابل، أصبحَت السرديَّة التي روَّج لها القادة الإسرائيليّون والجماعات الصهيونيَّة الأميركيَّة، ومفادها أنَّ المحرقة شكَّلت خطرًا داهمًا ومحدقًا على اليهود، أصبحَت بمثابة أساسٍ لهويَّةٍ ذاتيَّةٍ مشتركة لدى العديد من الأميركيِّين اليهود في سبعينيَّات القرن الفائت.
شكَّل الأميركيُّون اليهود حينذاك الأقليَّةَ الأكثر تعليمًا ورخاءً في أميركا، وشهِدَت اللادينيَة ازديادًا في أوساطهم. مع ذلك، وفي المجتمع الأميركيِّ شديد الاستقطاب في أواخر ستينيَّات القرن المنصرم وسبعينيَّاته، حيثُ صار العزل الإثنيّ والعرقيّ ظاهرةً شائعةً وسطَ شعورٍ مستشرٍ بالفوضى وانعدام الأمن، وحيث تحوَّلت الكارثة التاريخيَّة إلى شارةٍ للهويَّة والاستقامة الأخلاقيَّة؛ ازدادت أعدادُ المنتسبين من الأميركيِّين اليهود المندمجين إلى ذكرى المحرقة، وصاروا ينشؤون علاقاتٍ شخصيَّةً مع إسرائيل التي اعتبروا أنَّها مُهدَّدةٌ من قِبل إباديِّين مُعادين للساميَّة. وهكذا، تحوَّر التقليد السياسيُّ اليهوديُّ الذي كان مشغولًا بقضايا عدم المساواة، والفقر، والحقوق المدنيَّة، وحماية البيئة، ونزع السلاح النوويّ، ومعاداة الإمبرياليَّة، إلى آخرَ يتميَّزُ بالاهتمام المفرِط بالديموقراطيَّة الوحيدة في الشرق الأوسط. في المذكرات التي كتبها منذ ستينيَّات القرن الفائت فصاعدًا، يتأرجح موقف الناقد الأدبيِّ ألفرِد كازين ما بين حيرةٍ وازدراء، إذ يُسهب في تفصيل أنماط سايكودراما الهويَّة الشخصيَّة، التي ساعدت في خلق الدائرة الانتخابيَّة الأشد ولاءً لإسرائيل في الخارج:
سيأتي يومٌ نتذكَّر فيه فترة “النجاح” الحاليَّة لليهود كإحدى أعظم المفارقات… وقع اليهود في الفخّ، قُتِلوا، وانتهى الأمر! من بين الرماد، كلُّ هذا النحيب والاستغلال الحتميَّين للمحرقة… إسرائيل؛ باعتبارها “حصن” اليهود؛ والمحرقة باعتبارها كتابنا المقدَّس الجديد، أكثر من كونها سِفرَ مراثٍ.
نفرَ كازين من التقديس الأميركيِّ لإيلي فيزيل الذي كان يؤكِّدُ علانيةً أينما حلَّ أنَّ المحرقة حدثٌ غير قابلٍ للفهم، ولا المقارنة، ولا التمثيل، وأنَّه ليس للفلسطينيِّين حقٌّ في القدس. في رأي كازين، عثَرت “الطبقة الوسطى اليهوديَّة الأميركيَّة” في فيزيل، “يسوع المحرقة“، على “بديلٍ لفراغها الدينيّ“. لم يخفَ التأثيرُ القويُّ لسياسات الهويَّة لأقليَّةٍ أميركيَّةٍ عن أعين بريمو ليفي أثناء زيارته الوحيدة للبلاد في عام 1985؛ أي قبل انتحاره بعامين. كان انزعاجهُ شديدًا من الثقافة الطاغية لاستهلاك المحرقة التي أحاطَت فيزيل (الذي زعم أنَّه كان صديقًا مقرَّبًا لليفي في أوشفيتزٍ؛ في حين لم يتذكَّر ليفي أنَّه التقى به مُطلَقًا)، كما شعرَ بالحيرة إزاء هوس مضيفيه الأميركيِّين التلصُّصيِّ بصدد يهوديَّته. في هذا السياق، كتب ليفي إلى أصدقائه في مسقطِ رأسه، تورينو، يشكو من أنَّ الأميركيِّين “علقَّوا نجمة داوود” عليه. وعندما سُئل عن آرائه بسياسات الشرق الأوسط، خلال محاضرة له في بروكلين، شرع ليفي بالقول “إنَّ وجود إسرائيل خطأٌ، من منظورٍ تاريخيّ“. أثار هذا ضجَّةً عارمة، اضطرَّ على إثرها المحاوِرُ إلى إنهاء اللقاء. وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك العام، عمدت مجلَّة “كومنتاري“، التي تؤيُّد إسرائيل بضراوة اليوم، إلى تكليف شابٍّ في الرابعة والعشرين من عمره، ويطمَح أن يصبح محافظًا جديدًا، بشنِّ هجماتٍ خبيثةٍ ضدَّ ليفي. وبحسب كلمات الأخير نفسه، فإنَّ هذه البلطجة الفكريَّة (التي يشعر الشخصُ الذي كان وراءها اليوم بندمٍ مرير، بعد أن صار كاتبًا مُعاديًا للصهيونيَّة) قد ساهمت في إخماد “رغبته في الحياة“.
في الأدب الأميركيّ الحديث، تتجلَّى بوضوحٍ بالغٍ مفارقةٌ مفادها أنَّه كلَّما ابتعدنا زمنيًّا عن المحرقة، أصبح تمسُّك الأجيال اللاحقة من الأميركيِّين اليهود بذكراها أشدَّ ضراوة. لقد أذهلني حجم الاستخفاف الذي صَوَّر فيه إيزاك باشفيس زينغر، المولود في عام 1904 ببولندا، ويُعتبَر إلى حدٍّ كبيرٍ الكاتب اليهوديَّ الأعلى جودةً في القرن العشرين، الناجين من المحرقة في أعماله الروائيَّة، واستهزاءه بكلٍّ من دولة إسرائيل والفيلوساميَّة المفرطة الأميركيِّين غير اليهود. إنَّ روايةً على غرار “ظلال على نهر هدسون“، تكادُ تبدو مُصمَّمةً خصيِّصاً من أجل إثبات أنَّ تجربة الاضطهاد لا ترتقي بالأخلاق. بينما يبدو أنَّ الكتَّاب اليهود، الأصغر سنًّا والأكثر علمانيَّة من زينغر، غارقون للغاية بما أسمَّته جيليان روز، في مقالتها اللاذعة عن فيلم قائمة شندلر، بـ “ورع الهولوكوست“. في مراجعةٍ نشرتها “لندن ريفيو أوف بوكس” في عام 2005 لرواية “تاريخ الحبّ“، الصادرة في العام نفسه للروائيَّة نيكول كراوس وتدور أحداثها في كلٍّ من إسرائيل وأوروبا والولايات المتَّحدة، يشيرُ الكاتب جيمس وود إلى أنَّ الروائيَّة، المولودة في عام 1974، “تمضي في تطوير العمل كما لو أنَّ المحرقة حدثت بالأمس“. كما يضيف لاحقاً أنَّ الطابع اليهوديَّ للرواية “مُشوَّهٌ بالاحتيال والتكلُّف بفعل التأثير الطاغي لهويَّة كراوس على امتداد العمل“. هذه “الحماسة اليهوديَّة” التي تقاربُ حدود “التهريج الجوَّال“، تتناقضُ بشدَّةٍ مع أعمال كلٍّ من بيلو ونورمان ميلر وفيليب روث، الذين “لم يُظهروا اهتمامًا كبيرًا بما ألقته المحرقة من ظلال“.
نشأ ارتباطٌ وثيقٌ أيضًا بين الصحافة الأميركيَّة عن إسرائيل والمحرقة إلى حدٍّ بعيد، وقد أثَّر ذلك سلبيًّا على تغطيتها. والأهمُّ من ذلك، أفضى كلٌّ من تديُّن المحرقة السياسيّ–العلمانيّ، والتماهي المفرط مع إسرائيل منذ سبعينيَّات القرن الفائت، إلى إحداث انحرافاتٍ خطيرةٍ في السياسة الخارجيَّة للولايات المتَّحدة، أبرز رعاة إسرائيل. في عام 1982، قبيل وقتٍ قصيرٍ من إصدار ريغان أمرًا صريحًا لبيغن من أجل إيقاف “محرقته” في لبنان، التقى سيناتور أميركيّ شابّ، وكان أيضاً أحد مريدي فيزيل، برئيس الوزراء الإسرائيليّ. وبحسب رواية بيغن التي تنضح ذهولًا عن ذلك اللقاء، فإنَّ ذلك السيناتور قد أثنى على جهود إسرائيل الحربيَّة، وتفاخر بأنَّه كان سيمضي أبعد ممَّا حدث بالفعل، حتَّى لو عنى ذلك قتل النساء والأطفال. كانت كلماتُ الرئيس الأميركيِّ المستقبليّ، جو بايدن، قد فاجأت بيغن نفسه، ودفعته للردِّ بإصرار: “كلَّا، يا سيِّدي! قيمُنا تَمنعُنا من إيذاء النساء والأطفال، حتَّى لو كان ذلك أثناء الحرب… هذا معيارٌ للحضارة الإنسانيَّة، ألَّا نؤذي المدنيِّين“.
إنَّ الأمد الطويل للسلام النسبيِّ جعل معظمنا غافلين عن الفظائع التي سبقتها. قليلٌ فقط من البشر الذين ما زالوا على قيد الحياة يتذكَّرون تجربة الحرب الشاملة التي ميَّزت النصف الأوَّل من القرن العشرين، والصراعات الإمبرياليَّة والقوميَّة داخل أوروبا وخارجها، والحشد الجماهيريّ الأيديولوجيّ، واندلاع الفاشيَّة والنزعة العسكريَّة. لقد كشفَت قرابةُ نصف قرنٍ من الصراعات الأكثر وحشيَّة وأشدِّ الانهيارات الأخلاقيَّة في التاريخ، عن المخاطر التي تتهدَّد عالمًا لا ينطوي على أيِّ ضوابط دينيَّة أو أخلاقيَّة لما يمكن للبشر فعله أو ما قد يتجرَّؤون على الإقدام عليه. والمنطق العلمانيّ والعلم الحديث، اللذان حلَّا محلَّ الدين التقليديّ وأزاحاه، لم يكشفا فقط عن عجزِهما في تشريع السلوك البشريّ؛ بل كانا متواطئين في أنماطٍ جديدةٍ وفعَّالةٍ من القتل الوحشيِّ تجلَّت في كلٍّ من أوشفيتز وهيروشيما.
إبَّان عقود إعادة الإعمار التي أعقبَت عام 1945، أصبح من الممكنِ تدريجيًّا أن نؤمن مجدَّدًا بمفهوم المجتمع الحديث، وبمؤسَّساته باعتبارها قوَّة تَحضيرٍ لا لبس فيها، وبقوانينه باعتبارها درعاً في وجه الأهواء الخبيثة. تكرَّس هذا الإيمان المؤقَّت عبر لاهوتٍ علمانيٍّ سلبيٍّ مُستمّدٍ من فضح الجرائم النازيَّة: لن تحدُث مجدَّدًا. وشيئًا فشيئًا، اكتسبَت هذه الضرورة الحتميَّة لمرحلة ما بعد الحرب شكلًا مؤسَّساتيًّا مع إنشاء منظَّماتٍ على غرار محكمة العدل الدوليَّة، والمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، ومنظَّمات حقوق الإنسان اليقظة مثل منظَّمة العفو الدوليَّة وهيومن رايتس ووتش. وكانت إحدى أبرز وثائق أعوام ما بعد الحرب، وهي ديباجة الميثاق العالميّ لحقوق الإنسان في عام 1948، مُشبَّعةً بالخوف من تكرار ماضي أوروبا العنصريِّ الكارثيّ. في العقود الأخيرة، ومع تلاشي التصوُّرات الطوباويَّة عن نظامٍ اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ أفضل، صارت سلطة النموذج الأسمى لحقوق الإنسان مستقاةً بصورةٍ أكبر من ذكريات الشرِّ الأعظم الذي ارتُكب خلال المحرقة.
في نضالات الإسبان من أجل عدالةٍ تصالحيَّةٍ بعد أعوامٍ طوال من الديكتاتوريَّات الوحشيَّة؛ وثورات الأميركيِّين اللاتينيِّين من أجل معتقليهم المختفين قسرًا؛ ومناشدات البوسنيِّين طلبًا للحماية من ممارسات التطهير العرقيِّ الصربيَّة؛ والنداءات الكوريَّة لإنصاف “نساء المتعة” اللواتي استعبدهنَّ اليابانيّون إبَّان الحرب العالميَّة الثانية؛ شكَّلت معاناةُ اليهود على أيدي النازيِّين الأساس الذي استندت إليه معظم خصائص الأيديولوجيا والأعمال الوحشيَّة المتطرِّفة، وكذلك معظم المطالبات بالاعتراف والتعويضات.
أسهمَت هذه الذكريات في تحديد مفاهيم مثل المسؤوليَّة، والذنب الجماعيّ، والجرائم ضدَّ الإنسانيَّة. لكن لا ننكر حقيقة أنَّها تتعرَّض باستمرارٍ للاستغلال من قِبل دعاة النزعة الإنسانيَّة العسكريَّة، الذين اختزلوا حقوق الإنسان بالحقِّ في عدم التعرّض للقتل الوحشيِّ وحسب؛ ولا النمو المطَّرد للسينيكيَّة مع تحوُّل الأنماط النسقيَّة لإحياء ذكرى المحرقة، كالرحلات المتشائمة إلى أوشفيتز، والتي تعقبها رفاقيَّة حماسيَّة مع نتنياهو في القدس، إلى ثمنٍ بخسٍ لتذكرة احترام السياسيِّين المعادين للساميَّة، والمحرِّضين المعادين للإسلام، وإيلون ماسك. أو عندما يمنح نتنياهو صكوك غفرانٍ أخلاقيَّةً مقابل الحصول على دعم سياسييٍّ أوروبا الشرقيَّة المعادين للساميَّة علنًا، الذين يدأبون باستمرارٍ على إعادة تأهيل أكثر الجلَّادين المحليِّين حماسةً ضدَّ اليهود إبَّان المحرقة. مع ذلك، وفي غياب أيِّ شيءٍ آخر أكثر فعاليَّة، تظلُّ المحرقة معيارًا جوهريًّا لقياس صحَّة المجتمعات النفسيَّة والأخلاقيَّة؛ إذ لا تزال ذكراها، برغم أنَّها عرضةٌ للاستغلال، قادرةً على كشفِ المزيد من الآثام الأكثر خبثًا. فعندما أنظرُ إلى أعمالي عن مُهلِّلي هتلر المعادين للإسلام وحجم تأثيرهم الشرير على الهند اليوم، أشعرُ بالذهول من عدد المرَّات التي استشهدتُ فيها بتجربة الاضطهاد اليهوديَّة في سياق التحذير من الهمجيَّة التي تتحوَّل إلى أمرٍ واقعٍ عند تجاوز محظورات معيَّنة.
كلُّ ما سبق من علاماتٍ مرجعيَّة عالميَّة، المحرقة كمعيارٍ لكلِّ الجرائم، ومعاداة الساميَّة كأسوأ أشكال التعصُّب فتكًا، مهدَّدةٌ بالاندثار بينما يذبح الجيش الإسرائيليُّ الفلسطينيِّين ويجوِّعهم، ويُدمِّر منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومساجدهم وكنائسهم، ويُشظِّيهم إلى مخيَّمات أصغر وأصغر، في حين يتَّهم كلَّ من يناشده بالكفِّ عن أفعاله بمعاداة الساميَّة أو الدفاع عن حماس؛ سواءٌ أكانت الأمم المتَّحدة، أم منظَّمة العفو الدوليَّة، أم هيومن رايتس ووتش، أم حكومات كلٍّ من إسبانيا وأيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا، أم الفاتيكان. اليوم، تنسفُ إسرائيلُ صرح الأعراف العالميَّة الذي بُنيَ بعد عام 1945، وظلَّ يترنَّح منذ الحرب الكارثيَّة على الإرهاب، التي لم يعاقَب أيُّ من مرتكبيها، وحرب بوتين الثأريَّة على أوكرانيا. هذه القطيعة العميقة التي نشعرُ بها اليوم ما بين الماضي والحاضر إنَّما هي قطيعةٌ في التاريخ الأخلاقيِّ للعالم منذ نقطة الصفر في عام 1945؛ التاريخِ الذي تبوَّأت فيه المحرقة، على مدى أعوامٍ عديدة، موقع الحدث المركزيَّ والمرجعيَّة العالميَّة.
هناك المزيد من الزلازل التي تنتظرنا؛ فقد قرَّر السياسيُّون الإسرائيليّون الوقوف في وجه إنشاء دولةٍ فلسطينيَّة؛ ووفقاً لاستطلاع رأيٍ حديث، فإنَّ الأغلبيَّة الساحقة من اليهود الإسرائيليِّين (بنسبة 88 بالمئة) يرون أنَّ حجم الضحايا من الفلسطينيِّين مُبرَّر؛ كما تمنع الحكومة الإسرائيليَّة وصول المساعدات الإغاثيَّة إلى غزَّة. يعترفُ بايدن اليوم بأنَّ أتباعه الإسرائيليِّين مذنبون بجريمة “القصف العشوائيّ“، لكنَّه في الوقت نفسه يُغدق عليهم، بصورةٍ قهريَّة، الكثير من المعدَّات العسكريَّة. وفي اليوم العشرين من شهر شباط، استهزأت الولايات المتَّحدة في الأمم المتَّحدة، وللمرَّة الثالثة، بالرغبة الملحَّة لمعظم شعوب العالم بصدد إنهاء حمَّام الدمّ في غزَّة. بعدها بستَّة أيَّام، وبينما كان يلعقُ مخروطًا مُثلَّجات، طرحَ بايدن ما يدور في خياله بشأن وقف إطلاق نارٍ مؤقَّت، والذي سرعان ما أجهضته كلُّ من إسرائيل وحماس. في المملكة المتَّحدة، يبحث ساسةٌ من العمَّال والمحافظين على حدٍّ سواء، عن صياغاتٍ لفظيَّةٍ من شأنها تهدئة الرأي العامّ وفي الوقت نفسه توفير غطاءٍ أخلاقيٍّ للمذبحة في غزَّة. ربَّما لا يبدو الأمر قابلًا للتصديق، لكن الأدلَّة أصبحَت دامغة: نحنُ نشهدُ ما يمكن وصفُه بانهيار العالم الحرّ.
في الوقت نفسه، صارَت غزَّة في منظور عددٍ لا حصر له من المستضعفين الشرطَ الأساسيَّ للضمير السياسيِّ والأخلاقيِّ في القرن الحادي والعشرين، تمامًا كما كانت عليه الحرب العالميَّة الأولى بالنسبة إلى جيلٍ كاملٍ في الغرب. وعلى نحوٍ متزايد، يبدو أنَّ أولئك الذين اهتزَّت ضمائرهم بفعل كارثة غزّة هم وحدهم القادرون على إنقاذ المحرقة من براثن نتنياهو وبايدن وشولتز وسوناك، وإعادة أهمِّيَّتها الأخلاقيَّة إلى مكانتها العالميَّة؛ هُم فقط من يمكن الوثوق بهم في مهمَّة استعادة ما أسماه أمري توازن أخلاقيَّات العالم. إنَّ العديد من المتظاهرين الذين يملؤون شوارع مدنهم أسبوعًا تلو الآخر ليسَت لديهم علاقةٌ مباشرة بالماضي الأوروبيِّ للمحرقة، وهم يُحاكمون إسرائيل بناءً على أفعالها في غزَّة، وليس وفقًا لمطالباتها بالأمان الدائم والشامل، والمستندة إلى تقديس المحرقة. وسواءٌ أكانوا يحيطون علمًا بالمحرقة أم لا، فإنَّهم يرفضون الدرس الداروينيَّ–الاجتماعيَّ الفجّ الذي تستخلصهُ إسرائيل منها– أي بقاءَ مجموعةٍ من البشر على حسابِ أخرى. إنَّهم مدفوعون برغبتهم البسيطة بالتشبُّث بالمثل العليا التي بدَت صائبةً تمامًا عالميًّا بعد عام 1945: احترام الحرِّيَّة، والتسامح مع اختلاف المعتقدات وأنماط الحياة؛ والتضامن مع المعاناة الإنسانيَّة؛ والشعور بالمسؤوليَّة الأخلاقيَّة إزاء الضعفاء والمضطهدين. ويدركُ هؤلاء الرجال والنساء أنَّه في حال كان هناك درسٌ شعاراتيّ يُستخلص من المحرقة، فهو أنَّها “لن تحدُث مجدَّدًا، لأيٍّ أحد“: وهذا شعار الناشطين الشباب الشجعان من منظَّمة “الصوت اليهوديّ من أجل السلام“.
احتمالُ خسارتهم لا يزال قائمًا. ربَّما إسرائيل، من خلال ذهانها المهووس بالبقاء، ليسَت “حطامًا بشريًّا” كما وصفها جورج شتاينر، بل نذيرةٌ لمستقبل عالمٍ مفلس ومنهَك. إنَّ التأييد المطلق الذي تحظى به إسرائيل من قبل رموزٍ يمينيَّة متطرِّفة على غرار خافيير مايلي في الأرجنتين، وغايير بولسونارو في البرازيل، ورعايتها من قبل دولٍ يستشري القوميّون البيض في حياتها السياسيَّة، مثل الولايات المتَّحدة، والمملكة المتَّحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، إنَّما يوحي بتقهقر عالم الحقوق الفرديَّة، والحدود المفتوحة، والقانون الدوليّ. واردٌ أن تنجحَ إسرائيل بتطهير غزَّة عرقيًّا، بل والضفَّة الغربيَّة أيضًا. هناك أدلَّة كثيرةٌ جدًّا بصدد أنَّ كفَّة العالم الأخلاقيِّ لا ترجح باتِّجاه العدالة؛ أنَّ بمقدور الرجال الأقوياء جعل مجازرهم تبدو ضروريَّةً ومحقَّة. إنَّه ليس من الصعب أبداً تخيُّل نتيجةٍ ظافرةٍ لصالح المذبحة الإسرائيليَّة.
يُلقي الخوف من هزيمةٍ كارثيَّةٍ بثقله على أذهان المتظاهرين الذين يُعطِّلون خطابات حملة بايدن الانتخابيَّة، ويُطرَدون أمام ناظريه على وقع هتاف “أربعة أعوامٍ أخرى“. ويسود عدم التصديق ما يشاهدونه يوميًّا من مقاطع مصوَّرة من غزَّة، ويُطاردُ الخوفُ من مزيدٍ من الوحشيَّة المنفلتة المعارضين عبر الإنترنت، الذين ينتقدون بشدَّةٍ التقارُب الحميميَّ لأعمدة السلطة الرابعة الغربيَّة مع القوَّة الغاشمة. فباتِّهامهم إسرائيل بارتكاب إبادةٍ جماعيَّة، يبدو أنَّهم يتعمَّدون الإساءة إلى الرأي “المعتدل” و“العقلانيّ” الذي يضعُ إسرائيل، والمحرقة أيضًا، خارج التاريخ الحديث للنزعة التوسُّعيَّة العنصريَّة. وهُم على الأرجح لا يقنعون أحدًا من التيَّار السياسيِّ الغربيِّ المتشدِّد.
لكن إذا نظرنا إلى أمري نفسه، حينما وجَّه سخطه إلى الضمير المزري لزمنه، فإنَّه لم يكن يتكلَّم “بقصد الإقناع، على الإطلاق؛ بل ألقي كلماتي جزافًا على كفَّة الميزان، أيًّا كان وزنُها“. وبعدما شعر أنَّ العالم الحرَّ خدعه وتخلَّى عنه، أعلنَ استياءه “لكي تصبح الجريمة واقعًا أخلاقيًّا بالنسبة إلى المجرم، ولكي تجتاحَهُ حقيقة ما اقترفه من فظاعة“. واليوم لا يبدو أنَّ مُتَّهِمي إسرائيل الصاخبين يبحثون عن أكثر من ذلك. ففي وجه كلٍّ من الأعمال الوحشيَّة، والبروباغندا التي تستندُ إلى التجاهل والتعتيم، تعلنُ ملايين لا حصر لها من البشر اليوم، في الفضاءات العامَّة وعبر وسائل الإعلام الرقميَّة، عن سخطها العارم. وفي خضمِّ ذلك، يخاطرون بتكدير حياتهم بصورةٍ دائمة. لكن ربَّما سيكون غضبهم وحده كفيلًا، في الوقت الراهن، بتخفيف مشاعر العزلة المطلقة التي تغمر الفلسطينيِّين، والمساهمة إلى حدٍّ ما باسترداد ذكرى المحرقة.
*نُشر هذا المقال في الأصل باللغة الإنجليزية في “London Review of Books” وقد تمت الترجمة بموافقة الناشر. يمكن قراءة النسخة الأصلية هنا.