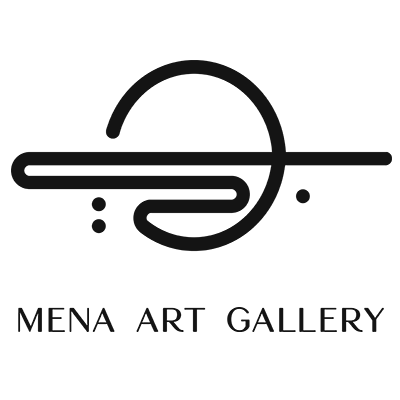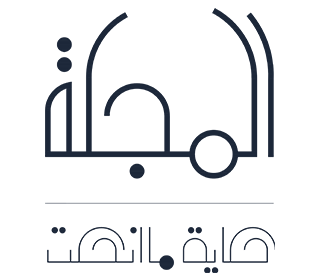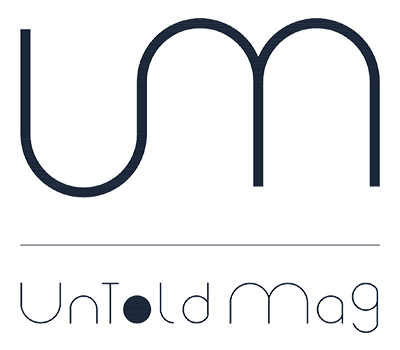يبدو أنَّنا دخلنا حقبة حربٍ لا نهائيَّة؛ تتمدَّد في جميع أنحاء المعمورة حتَّى لتزعزعَ أبرزَ مراكز النظام العالميّ. وفي حين أنَّ لكلِّ نزاعٍ مُعاصرٍ سياقاته التاريخيَّة ورهاناته، إلَّا أنَّه من المفيد التراجع خطوةً إلى الوراء بغية رصفها معاً ضمن إطارٍ أشمل.
تقضي فرضيَّتنا أنَّنا نشهَدُ انبثاق نظام حربٍ عالميّ- نظامٍ ينطوي على تشابكٍ وثيقٍ ما بين منظومات الحكم والعسكر من جهةٍ، والبنى الرأسماليَّة من جهةٍ أخرى. ومن أجل فهمٍ مَعمَّقٍ لديناميَّات كلٍّ حربٍ على حدة، وكذلك صياغة مشروع مقاومةٍ ملائم، فلا بدَّ من أن نفهم معالم هذا النظام.
منذ مطلع الألفيَّة الجديدة، طرأت تغيُّرات دراماتيكيَّة على كلٍّ من خطاب الحرب العالميَّة وممارساتها، وذلك حينما كان يُعتقَد أنَّ “الدولة المارقة” و”الدولة الفاشلة”، باعتبارهما مفهومين أيديولوجيَّين أساسيَّين، كفيلان بتفسير نشوب النزاعات العسكريَّة التي كانت، بحكم تعريفها، حكراً على الدول الهامشيَّة. إنَّ هذا الافتراض ينطوي مسبقاً على وجود نظام حكمٍ دوليٍّ مُستقرٍّ وفَعَّال، تتزَّعمُه الدول القوميَّة المهيمنة والمؤسَّسات العالميَّة. في الوقت الراهن، يعاني هذا النظام من أزمةٍ ويبدو غير قادرٍ على صون استقراره؛ فالنزاعات المسلَّحة، على غرار ما يحدث في أوكرانيا وغزَّة، إنَّما تستقطبُ بعضاً من أقوى الجهات الفاعلة على المسرح الدوليّ، وعلى نحوٍ يستحضرُ شبح التصعيد النوويّ. طالَما اعتمَدت مُقاربة الأنظمة العالميَّة منظوراً يرى في هذا النمط من الاضطرابات دلالةً لتبدُّلاتٍ على مستوى الهيمنة، في تفسيرٍ مشابهٍ لاعتبار أنَّ حربَي القرن العشرين العالميَّتين إنَّما يُمثِّلان نقطة تحُّول الهيمنة العالميَّة من بريطانيا إلى الولايات المتَّحدة. لكن في سياق الراهن، فإنَّ هذا الاضطراب لا يُنبِئ بانتقال السلطة؛ إذ ليسَ انحسار الهيمنة الأميركيَّة إلَّا إيذاناً ببدء حقبةٍ صارَت فيها الأزمةُ المعيارَ والقاعدة.
لأجل إدراك طبيعة هذه الحقبة، نقترحُ مفهوم “نظام حرب”؛ والذي من الممكن ملاحظته، أوَّلاً وقبل أيِّ شيءٍ آخر، في عسكرة الحياة الاقتصاديَّة وازدياد تواؤمها مع متطلَّبات “الأمن القوميّ”. لا تقتصر هذه الظاهرة على ارتفاع مُخصَّصات التسلُّح ضمن الإنفاق العموميّ وحسب؛ بل تشمل منظومة التنمية الاقتصاديَّة برمَّتها، والتي بحسب راؤول سانشيز سيديلّو، تخضع صياغتها على نحوٍ متزايدٍ إلى كلٍّ من المنطقين العسكريّ والأمنيّ. وكذا التقدُّم الاستثنائيّ الذي يشهده ميدان الذكاء الاصطناعيّ، المدفوع إلى حدٍّ كبير بمصالح عسكريَّة وتقنيَّاتٍ ذات استخداماتٍ حربيَّة. وعلى نحوٍ مماثل، تتكيَّف المسارات والبنى التحتيَّة اللوجستيَّة مع النزاعات والعمليَّات المسلَّحة. وهكذا، تغدو الحواجز الفاصلة ما بين الاقتصاديِّ والعسكريِّ أكثرَ ضبابيَّة من أيِّ وقتٍ مضى. حتَّى أنَّها أصبحَت، في بعض القطاعات الاقتصاديَّة، عصيَّةً على التمييز.
يتَّضح نظام الحرب أيضاً في عسكرة الميدان الاجتماعيّ. يظهر هذا في هيئةٍ صريحةٍ أحياناً، من خلال قمع المعارضة وارتفاع نسب الالتفاف الشعبويّ حول الدولة/ الحزب في فترات الحروب والنزاعات؛ لكن أيضاً في هيئة محاولةٍ أعمّ لترسيخ الإذعان للسلطة على مستوياتٍ اجتماعيَّةٍ مُتعدِّدة. طالما لم تقتصر الانتقادات النسويَّة على إبراز ما تُعبِّئه العسكرة من تمظهرات الذكورة السامَّة، بل كذلك تسلِّط الضوء على التأثير التشويهيّ لمنطق العسكرة في مختلف العلاقات والنزاعات الاجتماعيَّة. فالعديد من الرموز اليمينيَّة- على غرار بولسونارو، وبوتين، ودوتيرتي- تربط بصورةٍ جليَّةٍ ما بين مُثُلها العسكريَّة ودعمها للتراتبيَّات الاجتماعيَّة. وحتَّى عندما لا يكون هذا بائناً للعيان، فإنَّه لا يزال بمقدورنا ملاحظة انتشار مرجعيَّات سياسيَّة رجعيَّة تجمع ما بين العسكريتاريَّة والقمع الاجتماعيّ: سواءٌ من خلال إعادة فرض التراتبيات العرقيَّة والجندريَّة، ومهاجمة المهاجرين وإقصائهم، وحظر إمكانيَّة الإجهاض أو تقييدها، وتقويض حقوق المثليِّين والمثليَّات والعابرين جنسيَّاً؛ وغالباً ما تتزامن الممارسات السابقة كافَّة مع التلويح بشبح حربٍ أهليَّة وشيكة.
نظام الحرب الناشئ أيضاً يتجلَّى في المفارقة الظاهريَّة بصدد الإخفاقات المتواصلة للحملات الحديثة لحروب الهيمنة. فعلى امتداد نصف قرن، على الأقلّ، وعلى الرغم من كونها الأكثر تمويلاً وتقدُّماً تكنولوجيَّاً على وجه البسيطة، فإنَّ المؤسَّسة العسكريَّة الأميركيَّة لم تُحقِّق أيَّ شيءٍ سوى خسارة الحروب وحسب، سواءُ أكان ذلك في فيتنام أو أفغانستان أو العراق. كرمزٍ لهذا الإخفاق، تبرُز صورة المروحيَّة القتاليَّة التي تقلُّ آخر ما تبقَّى من عناصر أميركيِّين، لتبتعد بهم مُخلِّفةً وراءها مشهداً قد عصف به الدمار. لماذا لا تنفكُّ تفشل آلةٌ عسكريَّةٌ بمثل هذه القوَّة؟ إحدى الإجابات الواضحة على هذا السؤال هي أنَّ الولايات المتَّحدة لم تعد تلك القوَّة المهيمنة الإمبرياليَّة التي لا يزال البعض يعتقد أنّها كذلك. بيد أنَّ ديناميَّة الفشل هذه إنَّما تُفصح أيضاً عن بنية القوَّة العالميَّة الشاملة التي تساهم مثل هذه النزاعات في استدامتها. في هذا السياق، تجدر بنا الإشارة إلى عمل ميشيل فوكو بصدد الإخفاقات الدائمة للسجن في تحقيق أهدافه المعلنة. تنبَّه فوكو إلى أنَّ منظومة المؤسَّسات العقابيَّة، المكرَّسة ظاهريَّاً منذ نشوئها لمهمَّة تصويب السلوكيَّات الإجراميَّة وتأهيلها، إنَّما تفعلُ العكس مراراً وتكراراً؛ أي زيادة معدَّلات النكوص الإجراميّ، وتحويل الجناة إلى جانحين، وهلَّم جرَّا. في تعقيبه على هذه الظاهرة، يقول: “ربَّما ينبغي أنَّ نعكس المشكلة، فنسأل أنفسنا عمَّا يخدمُه فشلُ السجن… ربَّما علينا أن نسبر أغوار هذه التشاؤم الظاهريِّ من جدوى المؤسَّسة العقابيَّة”. في هذه الحالة أيضاً، لا بدَّ لنا من عكس المشكلة والسؤال عمَّا تخدمه إخفاقات الآلة الحربيَّة- عمَّا يحتَجِب وراء أهدافها الظاهريَّة. عند فعل ذلك، فإنَّنا لن نكتشفُ عصبةً من الزعماء السياسيِّين والعسكريِّين يحيكون مؤامراتٍ خلف أبوابٍ موصدة؛ بل سنعثر بالأحرى على ما يصطلح عليه فوكو بـ مشروع حوكمة. إنَّ الاستعراض المستمرَّ للمواجهات المسلَّحة، سواءٌ أكانت واسعة النطاق أو ضيِّقته، يساهم في دعم بُنية حوكمةٍ عسكريَّة ذات تمظهراتٍ تختلفُ باختلاف مواقعها، وتسترشدُ ببنيةٍ متعدِّدة المستويات من القوى؛ بما في ذلك الدول-القوميَّة المهيمنة، والمؤسَّسات فوق الوطنيَّة، وقطاعات رأس المال المتنافسة، والتي تتوافق أحياناً وتتناحر أحياناً أخرى.
ليسَت هذه العلاقة الوطيدة ما بين الحرب ومسارات رأس المال بجديدة؛ إذ ترتبط نظم اللوجستيَّات الحديثة بأنساب عسكريَّة تمتدُّ جذورها لتصل إلى المساعي الاستعماريَّة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطيّ. بيد أنَّ الأزمة العالميَّة الراهنة تتَّسم بالتراكب المتزايد ما بين “الجيوسياسيّ” و”الجيواقتصاديّ”، وذلك في خضمِّ عمليَّات صياغة وإعادة الصياغة مستمرَّة لفضاءات تثمين رأس المال ومراكمته، والتي تتقاطع مع التوزيع المثير للجدل للقوى السياسيَّة حول العالم.
ساهمَت المشكلات اللوجستيَّة إبَّان جائحة كوفيد 19 في تمهيد الطريق لعددٍ من القلاقل العسكريَّة اللاحقة. كما دلَّت صور الحاويات العالقة في الموانئ على ما ألمَّ بالتجارة العالميَّة من جمود وتعثُّر. بدورها، بذلت الشركاتُ جهوداً محمومةً للتعامل مع الأزمة، بما في ذلك إنعاش مساراتٍ تجاريَّة قديمة أو افتتاح أخرى جديدة. أعقب ذلك غزو أوكرانيا وما نجم عنه من اضطراباتٍ لوجستيَّة؛ والتي تُعتبر تجارة النفط والغاز من روسيا إلى ألمانيا من أبرز ضحاياها، خاصَّة في أعقاب التفجير الدراماتيكيّ لخطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، ممَّا جدَّد الحديث عن “التبادلات التجاريَّة مع الجوار” و”التبادلات التجاريَّة مع الأصدقاء” كإستراتيجيَّتين من أجل فصل الاقتصادات الأوروبيَّة عن مصادر الطاقة الروسيَّة. علاوةً على ذلك، عطَّلت الحرب تدفُّق كلٍّ من القمح والذرة والبذور الزيتيَّة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا؛ وشحِّ المواد الغذائيَّة الأساسيَّة في كلٍّ من أفريقيا وأميركا اللاتينيَّة؛ وتصاعد التوتُّرات ما بين بولندا وجمهوريَّة التشيك وأوكرانيا عقب رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعيَّة الأوكرانيَّة. في الوقت الحالي، يعاني الاقتصاد الألمانيّ من الركود، كما اضطرَّت دولٌ عديدة أخرى في الاتِّحاد الأوروبيّ إلى إعادة تنظيم إمداداتها من الطاقة من خلال إبرام صفقات مع دول شمال أفريقيَّة. أمَّا بالنسبة إلى روسيا، فقد أعادت توجيه صادراتها من الطاقة شرقاً، خاصَّةً إلى الصين والهند؛ أتاحَت لها المساراتُ التجاريَّة الجديدة- عبر جورجيا، على سبيل المثال- التحايل على العقوبات الغربيَّة، حتَّى لو بصورةٍ جزئيَّة على الأقلّ. وما من شكٍّ في أنَّ إعادة التنظيم هذه، التي ألمَّت بالمجالات اللوجستيَّة، إحدى أبرز رهانات النزاع.
كذلك المسألة في غزَّة أيضاً، حيث تلعب الترتيبات اللوجستيَّة وترتيبات البنية التحتيَّة دوراً مفصليَّاً، رغم أنَّها غالباً ما تحتجب وراء مشهد المذبحة الذي لا يُطاق. كانت الولايات المتَّحدة تمنّي النفس في أن يُدعِّم الممرِّ الاقتصاديِّ الهندي-الشرق أوسطيّ- الأوروبيّ، بامتداده من الهند إلى أوروبا عبر الإمارات والسعوديَّة والأردن وإسرائيل واليونان، نفوذها الاقتصاديّ الإقليميّ ويوفِّر ثقلاً موازِناً في وجه مبادرة الحزام والطريق الصينيَّة. بيد أنَّ هذا كان يعتمد مشروع التطبيع العربيّ الإسرائيليّ الذي ربَّما نُسِف عن بكرة أبيه من جرَّاء الحرب الجارية. وفضلاً عن ذلك، أجبرَت هجمات الحوثيِّين في البحر الأحمر شركات نقلٍ بحريٍّ كبرى على تجنُّب قناة السويس لصالحِ مساراتٍ أطول وأعلى تكلفة. في الوقت الحالي، تُنشِئ المؤسَّسة العسكريَّة الأميركيَّة ميناءً قبالة ساحل غزَّة، بذريعة تسهيل إيصال المساعدات، في حين ترى المنظَّمات الفلسطينيَّة أنَّ غايته النهائيَّة ليسَت سوى تسهيل التطهير العرقيّ.
على هذا النحو، يُجسِّد القتال الدائر في كلٍّ من أوكرانيا وغزَّة إعادة تشكيل فضاءات رأس المال على مستوى العالم؛ إذ نشهَدُ إعادةً لتشكيل مراكز التداول الرئيسيَّة، وفقاً لنظام حرب، عن طريق التدخُّل الفعَّال لدولٍ قوميَّة. ينطوي هذا على تمازُج المنطقين السياسيّ والاقتصاديّ؛ وهي ظاهرةٌ تعدو أكثر وضوحاً في منطقة “المحيطين الهنديّ والهادئ”، حيثُ تؤثِّر التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبيّ، والتحالفات العسكريَّة من قبيل أوكوس [اتِّفاقيَّة أمنيَّة ثلاثيَّة بين أستراليا والمملكة المتَّحدة والولايات المتَّحدة]، على الشبكات الاقتصاديَّة كاتِّفاق الشراكة الشاملة والتقدُّميَّة عبر المحيط الهادئ. وفي خضمِّ هذه المرحلة الانتقاليَّة، فإنَّ كلَّ نزاعٍ أو تعطُّلٍ في سلسلة توريدٍ قد يحملُ فائدةً لدولةٍ أو أخرى، أو فاعلٍ رأسماليٍّ أو آخر. ومع ذلك، يعصفُ بالنظامَ ككلٍّ تشرذمٌ مكانيُّ متزايد وانبلاجُ جغرافيَّاتٍ يتعذَّرُ التنبُّؤ بها.
على صعيد التصدِّي لنظام الحرب العالميّ، فإنَّه لا غنى عن دعوات وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، بيد أنَّ اللحظة الراهنة تقتضي سياسةً دوليَّةً متَّسقة أيضاً. والمطلوب هو ممارساتٌ منسَّقة تُفضي إلى انشقاقٍ جذريٍّ للناس عن الوضع الراهن. وفي وقت كتابة هذه المقالة، تبرزُ حركة التضامن العالميَّة مع فلسطين بوصفها أوضح الإرهاصات لمثل هكذا مشروع.
إبَّان القرنين التاسع عشر والعشرين، غالباً ما كان يُنظَر إلى الأمميَّة على أنَّها تضامن بين مشاريع وطنيَّة. اليوم، يَصدُق في بعض الأحيان، كما هو الحال بصدد قضيَّة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدوليَّة. بيد أنَّ مفهوم التحرَّر الوطنيّ، الذي كان بمثابة الأساس للنضالات المناهضة للاستعمار في حقبٍ سابقة، يبدو بعيد المنال أكثر فأكثر. وبينما يستمرّ النضال من أجل حقِّ الفلسطينيِّين بتقرير المصير، تفقد التطلُّعات لتحقيق حلِّ الدولتين، وإقامة دولةٍ فلسطينيَّةٍ ذات سيادة، واقعيَّتها على نحوٍ مُتزايد. بالتالي، كيف بمقدورنا صياغة مشروع تحرُّرٍ دون افتراض السيادة الوطنيَّة كهدفٍ من أهدافه؟ استناداً إلى بعضٍ من تقاليد الماركسيَّة والوحدويَّة الأفريقيَّة، فإنَّنا بحاجة إلى إحداث تجديد، وتوسعة، لصيغةٍ غير قوميَّة من الأمميَّة، مؤَّهلةٍ لمواجهة المسارات العالميَّة لرأس المال المعاصر.
ليسَت الأمميَّة والكوزموبوليتانيَّة شيئاً واحداً؛ إذ تستلزم الأولى أساساً ماديَّاً محدَّداً ومحلِّيَّاً عوضاً عن مزاعم مجرَّدة بالكونيَّة. ولا تقصي هذه الظاهرة صلاحيَّات الدول القوميَّة، بل تدرجها ضمن سياقٍ أوسع؛ فمن شأن حركة مقاومةٍ تلائم عشرينيَّات القرن الحاليّ أن تضمَّ طيفاً متنوِّعاً من القوى، بما في ذلك المنظَّمات المحلِّيَّة والأهليَّة، والبنى الوطنيَّة، والفاعلين الإقليميِّين. وعلى سبيل المثال، تتجاوز حركات التحرُّر الكرديَّة الحدودَ الوطنيَّة والعوائقَ الاجتماعيَّة في كلٍّ من تركيا وسوريا وإيران والعراق. وكذا تفعل حركات السكَّان الأصليِّين في الأنديز إذ تتخطَّى هذه الأنماط من الانقسامات، في حين تقدِّم التحالفات النسويَّة في أميركا اللاتينيَّة وخارجها نموذجاً قويَّاً لأمميَّةٍ غير قوميَّة.
طالما كان هذا الانشقاق، الذي ينطوي على طيفٍ من ممارسات الفرار، تكتيكاً مُفضَّلاً لمقاومة الحرب. وهو لا يقتصر على الجنود وحسب، بل بمقدور أفراد المجتمع كافَّة أن يقاوموا بمجرَّد النأي بأنفسهم عن مشروع الحرب. بالنسبة إلى مقاتلٍ في صفوف الجيش الإسرائيليّ أو الروسيّ أو الأميركي، يظلُّ هذا التصرُّف فعلاً سياسيَّاً ذا مغزى، على الرغم من أنَّه قد يكون شديد الصعوبة من حيث التطبيق. قد ينطبق هذا أيضاً في حالة الجنود الأوكرانيِّين، على الرغم من أنَّ موقفهم مختلفٌ إلى حدٍّ بعيد. لكن بالنسبة إلى أولئك المحاصرين في قطاع غزَّة، فإنَّ هذا الخيار ليس قائماً. وعليه، فإنَّه لا بدَّ من النظر للانشقاق عن نظام الحرب الراهن بصورةٍ مختلفة عن الأنماط التقليديَّة. فهذا النظام، مثلما أشرنا سابقاً، يتجاوز الحدود وبُنى الحوكمة الوطنيَّة. بإمكان المرء، في الاتِّحاد الأوروبيّ، معارضة الحكومة الوطنيَّة ومواقفها الجينغويَّة، لكن لا بدَّ له أيضاً من مواجهة البنى فوق الوطنيَّة للكتلة التجاريَّة نفسها، وذلك مع إدراك أن حتَّى أوروبا ككلٍّ ليسَت فاعلاً سياديَّاً في هذه الحروب. كذلك الأمر في الولايات المتَّحدة أيضاً، حيثُ تتجاوز بنى صنع القرار العسكريّ والقوات المقاتلة الحدود الوطنيَّة لتشمل شبكةً واسعة من الفاعلين الوطنيِّين وغير الوطنيِّين.
إذاً، كيف يتسنَّى للمرء أن ينأى بنفسه عن بنيةٍ على مثل هذا التنوُّع؟ لا تأثيرَ يُذكَر للمبادرات المحلِّيَّة والفرديَّة، بل يجب أن تنطوي شروط التطبيق العمليِّ الفعَّال على رفضٍ جَمعيٍّ مُنظَّم ضمن دوائر عالميَّة. فالاحتجاجات الشعبيَّة العارمة ضدَّ الغزو الأميركيّ للعراق، والتي اندلعت في مدنٍ مختلفةٍ حول العالم في اليوم الخامس عشر من شباط لعام 2003، قد أصابت في تحديد التكوين فوق الوطنيِّ لآلة الحرب، مُعلنةً إمكانيَّة انبثاق فاعلٍ أمميٍّ جديدٍ مناهضٍ للحرب. وعلى الرغم من فشلها في وقف الهجوم، إلَّا أنَّها أحدثَّت سابقةً لممارسات الانسحاب الجماعيِّ المستقبليَّة. وبعد عقدين من الزمن، تَبرُز الصور المتنوِّعة للتعبئة المناهضة للمذبحة في غزَّة- منبثقةً في شوارع المدن وحُرُم الجامعات حول العالم- لتبشِّر بانبعاث “فلسطينَ عالميَّة”.
في وجه مثل هذه السياسة الأمميَّة التحرُّريَّة، تَظهر النزعة المُعَسكريَّة كإحدى العقبات الرئيسيَّة: وهي مقاربةٌ أيديولوجيَّة تختزل المشهد السياسيَّ إلى مُعسكَرين مُتعارضَين، وغالباً ما تفضي إلى تعزيز فكرة أنَّ عدوَّ عدوِّنا لا بدَّ أن يكون صديقنا. فترى بعضاً من مناصري القضيَّة الفلسطينيَّة يحتفون، أو أقلَّه يتقاعسون عن توجيه الانتقاد، لأيٍّ فاعلٍ يعارضُ الاحتلال الإسرائيليّ، بما في ذلك إيران وحلفاؤها في المنطقة. وفي حين أنَّه يمكن فهم هذه النزعة في الظرف الراهن، حيثُ يقف سكَّان غزَّة على شفير المجاعة بينما يتعرَّضون لعنفٍ مروِّع، إلَّا أنَّ المنطق الجيوسياسيّ الثنائيّ للمعسكريَّة يفضي في نهاية المطاف إلى التماهي مع قوى قمعيَّةٍ مُقوِّضةٍ للتحرُّر. لذا، وعوضاً عن دعم إيران وحلفائها، حتَّى على المستوى الخطابيّ، فإنَّه يجب على المشروع الأمميّ ربط نضالات التضامن مع فلسطين بنضالاتٍ أخرى مثل حركات “المرأة، الحياة، الحرِّيَّة” التي وقفت في وجه الجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران. ومختصر القول، يتعيَّن ألَّا يقتصر النضال ضدَّ نظام الحرب على مساعي وقف مجموعة الحروب الراهنة وحسب، بل لا بدَّ أيضاً من أنّ يفضي إلى تحقيق تحوُّلٍ اجتماعيٍّ أوسع.
إذاً، يجب أن تنبثق الأمميَّة من الأسفل، أي حيثُ تجدُ مشاريع التحرُّر المحلِّيَّة والإقليميَّة سُبُلها للنضال جنباً إلى جنب. لكنَّها تنطوي على عمليَّةٍ عكسيَّة أيضاً؛ إذ ينبغي أن تَرمي إلى خلق لغةٍ تحرُّريَّةٍ يمكن تمييزُها، وتقليب النظر فيها، وتطويرها، في سياقاتٍ متنوِّعة: أي كآلة ترجمةٍ مُستمرَّة، إذا جاز التعبير، قادرةٍ على الجمع بين السياقات والذاتيَّات غير المتجانسة. ينبغي للأمميَّة الجديدة ألَّا تفترض أيَّ تجانسٍ عالميٍّ أو تطمح إلى تحقيقه، لكن يجب بدلاً من ذلك أن تجمع بين الخبرات والبُنى، المحلِّية والإقليميَّة، شديدة التباين. وبالنظر إلى تَصدُّع المنظومة العالميَّة، واختلال المجالات الإستراتيجيَّة لمراكمة رأس المال، وتشابُك الجيوسياسيّ بالجيواقتصاديّ- وكلُّها ظواهر أرسَت الأسس لنشأة نظام الحرب كنموذجٍ تَفضيليٍّ من نماذج الحوكمة- فإنَّ أقلَّ ما يستلزمه مشروع الانشقاق هو إستراتيجيَّة أمميَّة تُفضي إلى إعادة تشكيل العالم.
تَدين هذه المقالة بالفضل لبريت نيلسون إذ رفدها بالعديد من الأفكار العميقة. ونيلسون هو شريك ساندرو ميزادرا في تأليف كتاب: “الغرب والآخرون: رأس المال والقوَّة في عالم متعدِّد الأقطاب”، الذي يصدُر قريباً عن منشورات فيرسو.
نشر هذا المقال بالانكليزية على موقع Sidecar في ٩ أيار/مايو ٢٠٢٤